أود في البداية أن أنبّه إلى أنني لستُ بصدد كتابة تقرير أكاديمي أو تناول هذه القضية نظرياً، بل هذه ملاحظاتُ ممارسٍ للصحافة والترجمة، ومن محبّ للغة الضاد وساعٍ إلى إثراء محتواها الرقمي على الإنترنت، فخلال عملي، أجد يومياً مصطلحات جديدة لترجمتها إلى لغتنا، وغالباً ما يكون المصطلح جديداً ولا ترجمةَ له باللغة العربية، مما يدفعُنا إلى محاولة نحتِ واستحداثِ كلماتٍ أو تعابيرَ جديدة. ورغمَ كل التحديات فإن الهدفَ نبيل، ليس فقط على مستوى المجتمع والنهوض به وترسيخ هُويته وانتمائه العربي، بل أيضاً على المستوى الشخصي.
حتى الآن، ما زال موضوع الرقمنة جديداً، ولا يتوفرُ الكثير من الدراسات حوله، ولكنه من صميم عملي اليوميّ في مجال الترجمة إلى اللغة العربية الفصحى والنشرِ بها والتأكدِ من سلامتها، فما أهمّ التحديات التي تواجه اللغةَ العربيةَ في المجال الرقمي؟ وكيف يمكن تنمية وتطوير المحتوى العربي على الإنترنت. وما أهمّ المبادرات في هذا الشأن؟
لعله من المناسب أن نبدأ بتعريف الرقمنة، فهي تعريبٌ لكلمة "digitization"، وهي مصطلح جديد له عدة مرادفات باللغة الأجنبية منها: scanning، digitalization، computerization، digitizing. كما تُرجم إلى لغتنا عدة تراجم مثل "الترقيم"، "التمثيل الرقمي"، "الأرشفة الرقمية والإلكترونية".
والمصطلح باختصار، يعني تحويل المواد -سواءً كانت مرئيةً أو مسموعةً أو مقروءةً- إلى صيغ رقميةٍ صالحةٍ للتداول على الأجهزة الرقمية والإنترنت، والتخزين على الوسائطِ الحديثة من أقراص صلبة ومرِنة، وقابلة للنشر على الإنترنت.
ويواجهُ المتعاملون مع اللغة سواء بالكتابة أو الصحافة أو الترجمة أو الأدب تحديات كبيرةً، خصوصاً في التعامل مع المضامين اليومية. وعبرَ مسيرتي في مجاليْ الإعلام والترجمة خاصةً، تواجهُني عادة بعضُ المواقف أو التعابير التي تتطلبُ بحثاً ثمَّ اختياراً قلَّما يكونان سهليْن بين ما هو صحيحٌ وفصيحٌ، وبين ما هو دارجٌ بين الناس ومفهوم، وإن كان به عَوَرٌ أو خطأ لغويّ خفيف، إن جاز وصفُ الخطأ بالخفة.
الإعلاميون غالباً، عليهم أن يجمعوا بين الدقة والسهولة وما يفهمُه الجمهورُ المستهدف. وهذا الجمع بين اللغة الجزْلة الصحيحة وما هو مفهومٌ عادةً ما يكونُ صعباً، خصوصاً في المجالات المستحدثة والعلوم الحديثة، حيث تُنحت المصطلحات بشكل يكادُ يكونُ يومياً تبعاً لتطور هذه العلوم ومستجداتها، وهذا يُحتّم علينا سرعةَ التعاطي مع النصوص المترجمَة، إذ قد لا يُسعفنا الوقت لاستشارة المعاجم المتخصصة، وحتى لو أسعفنا فلن تفيدنا، فهذه المصطلحات تتجدد باستمرار، وهو ما يقتضي سرعةَ اتخاذ القرار واعتماد المصطلحات، خاصةً في مجال الأخبار السريعة ومواكبة الأحداث والدراسات الجديدة.
ومن أهم التحديات أو العوائق:
-
انتشار الأمية، والأُمية المعلوماتية، حيث تقدر بعض الدراسات نسبة الأمية في العالم العربي بنحو 40%.
-
ضعف البنية التحتية لشبكات الإنترنت، وضعف المستوى المادي لغالبية شعوبنا، وهذا يمنعها من الاستفادة والحضور في العالم الرقمي الذي يُنظرُ إليه في المستويات الاقتصادية الدنيا على أنه ترفٌ فكري.
-
غياب دَور الجامعات ومراكز البحث في رقمنة المخطوطات مثلاً والدراسات والبحوث التي تعدها هذه المؤسسات، وهذا أيضاً مرتبط بقضية الموارد وشُحِّها.
-
ضعف حركة النشر وغياب شبكات التوزيع.
-
انتشار ما يُعرف باللغة الفرانكو عربية (franco-arabe) أو ما يسميه إخوتنا المشارقة بالعربيزي، أي كتابة اللغة العربية بحروف أجنبية، وهو ما جنى على اللغة جناية عظيمة.
-
قضية التدقيق الآلي وشيوع الأخطاء، فمعظم محركات البحث عندها خوارزميات ثابتة تتعلق بشيوع الاستخدام، بغض النظر عن السلامة اللغوية، فكلما كان اللفظ مستخدماً أكثر تعاملت معه على أنه هو الصحيح.
-
غياب الموسوعات العربية الموثوقة والمصادر المفتوحة أو ما يُسمى "MOOCs"، وهو اختصار للعبارة الإنجليزية "Massive Open Online Course"، وهي مواقع متخصصة في كل فرع من العلوم، وفيها معلومات موثَّقة. فغياب هذه الموسوعات يزيد الفجوة المعرفية ويُتيح المجال لانتشار المعلومات المغلوطة.
هذه التحديات أو العقبات أثّرت بشكل كبير على المحتوى الرقمي العربي الذي لا يتماشى ولا يُناسب قيمةَ وأهمية هذه اللغة الجميلة ولا إشعاعَها الثقافيَّ التاريخي كلغة أولى للعلوم والمعارف، حيث يُقدرُ حجم المحتوى العربيّ الرقميّ المنشور على صفحات شبكة الإنترنت وعلى مختلف الوسائط الإلكترونية، حسبَ تقديرات أكبر محركات البحث العالمية مثل غوغل وياهو، بأكثر قليلاً من 1% من مجمل المحتوى الرقمي العالمي، وكان قبل سنوات قليلة لا يتجاوز 0.3%، وهذه النسبة طبعاً دون المستوى المقبول ولا ترقى إلى مكانة لغتنا العربية.
وتنمية المحتوى العربي الرقمي تتطلب حسب اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا)، أدواتٍ معلوماتية أساسية تعتمدُ على حوسبة اللغة العربية وتحليلها بشكل عملي دقيق. وأهم هذه الأدوات محركات البحث والمعاجم. وما يوجد حالياً لا يلبي الاحتياجات، ولا يرقى إلى مستوى الأدوات المُماثلة في لغات أخرى، وخاصة الإنجليزية؛ فنحن بحاجة إلى بحوث في كيفية تصميم وصناعة المعاجم لتوليد المصطلحات وتوحيدها، إضافة إلى حوسبة اللغة العربية.
وتواجه لغتنا الكثير من المشكلات المعجمية رغم الجهود الكبيرة التي قامت وتقوم بها مجامع اللغة في عدة أقطار عربية. ومن هذه المشكلات أن أغلب معجمات اللغة العربية معجمات "تاريخية" أو مرتبطة بتاريخ معين، وغالباً تنتهي عند عصر الاستشهاد، وذلك لأن أصحاب هذه المعاجم وضعوها بهدف الحفاظ على لغة القرآن الكريم والحديث الشريف، وهو لا شك هدفٌ نبيل وفي غاية الأهمية، لكنه من ناحية أخرى قصَر اللغة على تلك العصور، وكأنَّها ماتت هناك، ولن يتطور الإنسان وتُستجدّ له مسائلُ وأشياء تتطلب كلماتٍ وتعابيرَ جديدةً للتعبير عنها ولا مخترعات جديدة كالسيارة مثلاً.
فالدارس للغتنا لديه معاجمُ ضخمة جداً مثلا أكبر معجم –ربما- وهو "تاج العروس" الذي يقع في أربعين جزءاً، وكل جزء حوالي خمسمئة صفحة إن لم تخني الذاكرة.
لكن هذه المعاجم الضخمة لن تُفيده كثيراً في دراسته للعلوم الحديثة، ولا حتى في متابعة الإعلام، ولا في لغتنا المتحدَّثة في الشارع.
بالعودة إلى التحديات، تبرز مثلاً:
-
الفجوة الكبيرة بيننا وبين العالم المتقدم في العلوم الحديثة، وعدم مسايرتنا لتطوراته وما يُصاحبها من مصطلحات وتعبيرات.
-
الثراء الكبير في المفردات، مما يجعل البحث صعباً خصوصاً على غير العرب من الدارسين والمهتمين، فمثلاً إذا كنتُ أبحثُ عن كلمة "عارضة" فعليَّ أن أقرأ حوالي خمسين صفحةً هي مادة "ع ر ض" في قاموسٍ مثل "تاج العروس". وحتى بعد هذا الجهد الجهيد، فلن يُفيدني هذا في معناها الحديث: عارضة المرمى في كرة القدم! وقس على هذا..
-
اختلاف طبيعة اللغة العربية عن أغلب اللغات الأجنبية، من حيث كتابتها من اليمين إلى اليسار، ومن حيث اعتمادها على الجذر بدل التسلسل الأبجدي.
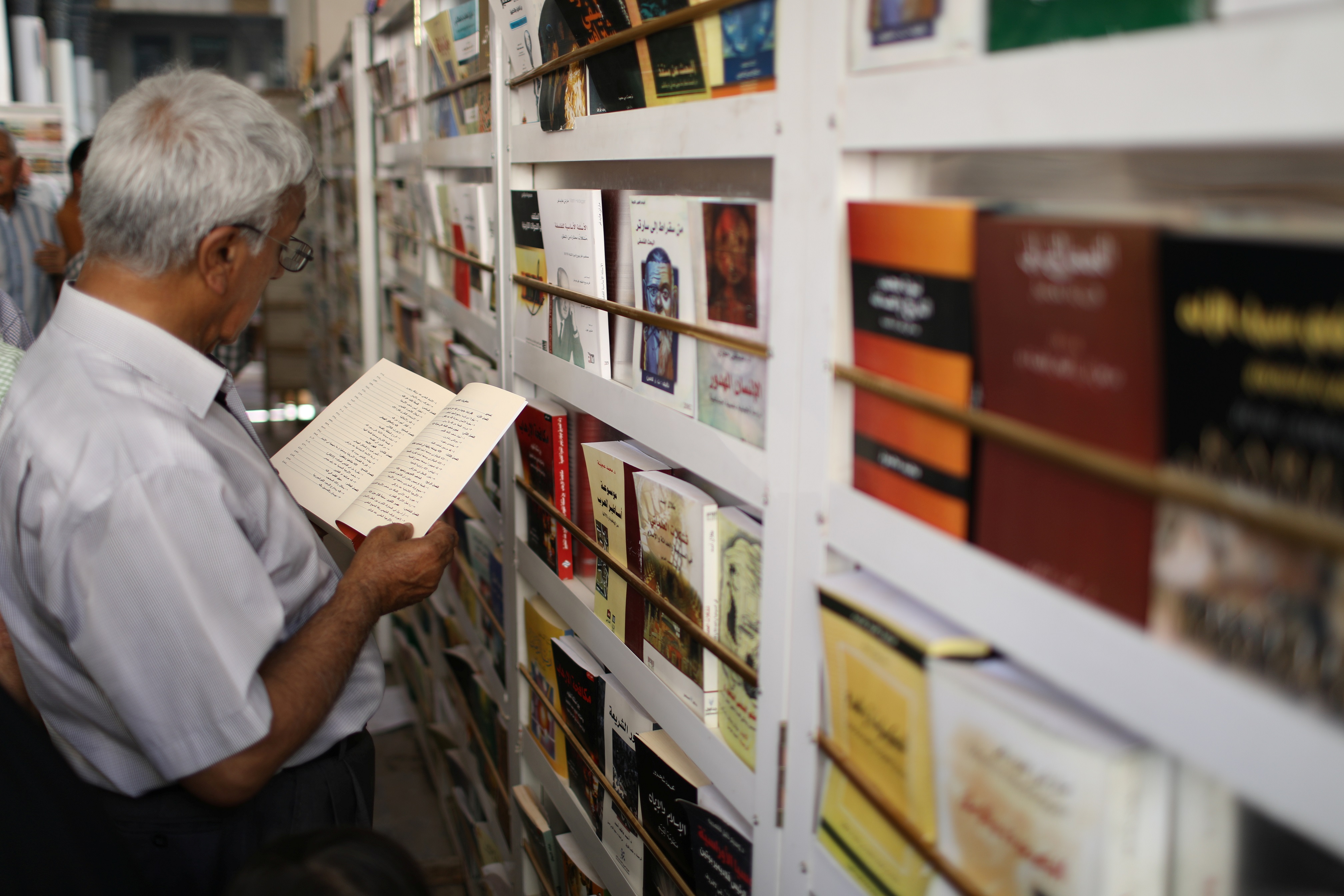
ومن قضايا وإشكاليات الرقمنة التي تواجه اللغة العربية وتعوق إثراء المحتوى الرقمي العربي على الإنترنت، إشكاليات الترجمة وتعريب المصطلحات ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأذكرُ هنا أنني منذ أشهر قليلة كنت أترجم تقريراً إخبارياً وردت فيه كلمة Whataboutism، وهي تقنية الرد على الأسئلة الصعبة أو الاتهامات باتهامات مضادة أو بالتطرق لأسئلة مختلفة (تغيير الموضوع).
مثلاً، حين أسأل عن شيء ويُجيبني أحد قائلاً: وماذا عن كذا؟ أو ماذا عن فلان الذي قال أو فعل كذا وكذا؟ فيغير بذلك الموضوع دون أن يُجيبَ على السؤال.
وبهذا المعنى تُمكن ترجمتها بالمراوغة أو التهرب من الأسئلة.. وهذا المصطلح في اللغة الأجنبية مكوَّنٌ من كلمتيْ "WHAT" وتعني "ماذا" و"ABOUT" وتعني "عن"، واللاحقة "ISM" التي تجعل الصفة اسماً، فكان عليَّ أن أجد لها -أو أنحتَ على الأصح- مقابلاً باللغة العربية، وهذا تقريرٌ سيصدر بعد دقائق، فلا أنا أملك الوقت لمطالعة المعجمات أو البحث على الإنترنت، وحتى لو توفر لي كل الوقت في العالم فهذا المصطلحُ جديدٌ حتى في اللغة الإنجليزية، إنما نحتوهُ قبلَ أسبوع!
وقد اقترحتُ الكلمات التالية -مع تبيين أنه مصطلح جديد- لكي نستغني عن ذكر هذه الكلمة الأجنبية في صدر النص: "المَذْعَنية" و"أسلوب ماذا عن؟" و"الماذاعنية".. وكلها طبعاً اجتهادات.
وفي مجال الترجمة أيضاً، لا بد من التأكيد على أهمية التنسيق بين مختلف المجامع اللغوية واتخاذ قرار بتوحيد ترجمات الكلمات الأجنبية. كما أنه من ناحية تقنية، على مترجمينا الابتعاد عن الحَرفية والارتباط باللغة المنقول عنها، فلننحت مصطلحاتِنا من لغتنا وخلفياتنا الثقافية والحضارية، ولا نكن مرآةً للغات الأخرى واستنساخاً لها.
كما أنني أتصور أن قضية توحيد المصطلحات والعمل على استصدار قوانين تجعل العمل بها مُلزماً، شيءٌ ضروريٌ في كل البلدان التي تتحدث العربية أو تتخذها لغةً رسمية. وهذه الخطوة -حسب رأيي- ستحل الكثير من المشكلات التي يعانيها ممارسو الكتابة سواءً في المجال الإعلامي أو غيره، فنجد الآن مصطلحاً يُترجم بكلمة في بلد وبأخرى في بلد ثان، بل حتى إننا نجد نفسَ المصطلح يُكتب بصيغة في المشرق وبصيغة أخرى في المغرب! مثل الجيم المصرية مثلاً التي تُكتب مرةً جيماً وتارةً غيناً وأخرى قافاً، وهكذا.












































