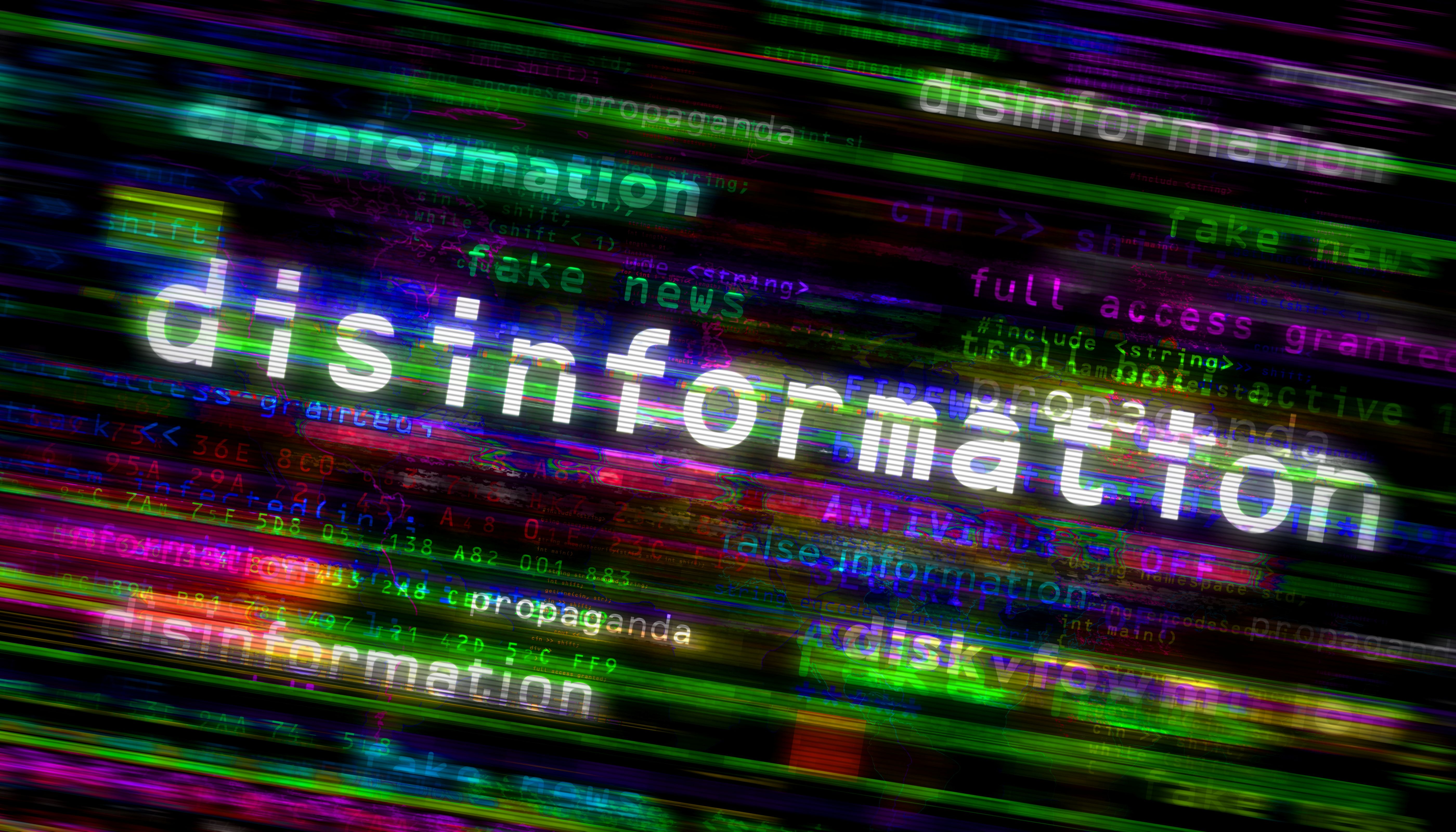ترجمة: محمد زيدان
تواصلت معي مؤخرًا صديقة عزيزة، فعمدتُ فورًا إلى قراءة رسالتها في بريد الرسائل الواردة، ذلك أني كنت قد طلبت منها بشكل مخصوص أن تطلعني على تطورات حالة زوجها منذ أن عرفتُ منها أنه أصيب بعدوى فيروس كورونا الجديد.
فقد تدهورت حالته الصحية وهو في فترة العزل الذاتي بالمنزل، رغم أنه في نهاية الثلاثينيات ولا يعاني من أمراض مزمنة. لكنْ، تلك هي معضلة هذا الفيروس وأخطر ما في سلوكه، إذ يفترض الأصحاء أنّهم أمام فيروس ضعيف لا يقوى على فعل شيء، ثم بمجرّد التعرّض للعدوى به، يتحوّل هذا الفيروس الضعيف إلى قوّة كاسرة تنهش الرئتين والعضلات والروح المعنوية للمريض الذي أصيب به على غفلة.
وصلتني تلك الرسالة التي تعبّر باختصار عن سنة 2020 باختصار شديد، وجاء فيها: "لقد تغيّرت حياتي من أقصى درجات الإيجابية إلى أقصى درجات التوتّر والجزع".
بحمد الله، تحسّنت حالة الرجل بعد عدّة أيام وزالت عنه الحمّى، ونجا من الفيروس بعد فترة من العزل التامّ في قبو منزله، لا يرافقه سوى الوحدة بوصفها ضريبة لازمة لهذا المرض، محرومًا من الرعاية المباشرة لزوجته وأنس حضورها وحضور ابنته التي اعتاد على ضحكتها الصباحية المنعشة. وقد بلغ به المرض حدًّا فقدَ معه مجرّد القدرة على الكلام معها، كما فقد الشهيّة للطعام والشراب.
كثيرون ممن أصيبوا بالعدوى لم يقدّر لهم أن يعانوا مثلما عانى هذا الرجل، إلا أن كثيرين غيره -أيضا- قاسوا ما هو أشدّ وأفظع. لكن، لو فكّرنا في المشترك الذي أصاب الجميع في هذا العام، لربّما قلنا إنه الاضطرار لمواجهة حقيقة العزلة، فجميعنا عانى بشكل أو بآخر من تجربة الانقطاع عن التواصل مع الآخرين. كلّنا عانينا من التباعد، معًا، وهذه من أقسى مفارقات العام 2020.
في ذروة تفشّي الجائحة، عمل فريقنا بجهد دؤوب لتغطية كافة التطورات لحظة بلحظة، في حين كانت الجائحة إزاءنا جميعًا، مما اضطرنا إلى الانتقال للعمل من المنازل لأجل غير معلوم، في خطوة غير مسبوقة ومليئة بالمفارقات هي الأخرى. وزعتُ وقتي في المنزل، ففي الصباح أضع أجندة الأخبار أثناء اجتماع الفريق التحريري، على نحو يضمن تغطية زوايا جديدة فيما يتعلق بأزمة "كوفيد-19"، ثم أنتقل فجأة خلال النهار إلى وضعية إدارة الأزمات وأنا أسمع تمتمات متزايدة من الفريق بشأن رصد أول حالة عدوى بالفيروس في قطر.
في الواقع لم يكن الوضع حينها ليمنعنا من الاستفادة من كافة الخبرات الصحفية التي تتوفر لدينا، إلا أنه ليس في وسعنا أن ننكر أننا -مثل غيرنا من البشر في تلك الفترة- لم نعِ تمامًا كنه ما يجري حولنا.
وهكذا رحنا نغطي هذا الموضوع المراوغ بأفضل ما أتاحته لنا الحيلة الصحفية، مع نشر آخر التحديثات والمعلومات على مدار أيام عديدة بلا انقطاع، وعمدنا إلى تعزيز روح المسؤولية فيما يتعلق بتزويد الجمهور بمعلومات دقيقة من مصادر موثوقة.
أذكر في بدايات التغطية أننا قررنا الامتناع عن نشر صور الناس الذين يرتدون الكمامات الواقية، إذ ظننا حينها أن في ذلك "تضليلا" محتملا للجمهور الذي قد يفترض أن الكمامات كافية للوقاية من العدوى، ثم سرعان ما تراجعنا عن هذا القرار حين أوضحت منظمة الصحة العالمية والمجتمع الطبي الموقف من الكمامات وأهميتها.
ذكّرني ذلك بمشهد في الفيلم الكوميدي "ذا بيغ سيك" (The Big Sick) -وهو فيلم ربما يبالغ البعض في تقييمه- حين يقول بطل الفيلم لأمّ صديقته التي ترقد في غيبوبة بالمستشفى: "أعتقد أن هؤلاء الأطباء يقومون بما يرون أنه الأنسب"، لكن السيدة تردّ عليه وتقول: "لا، هذا غير صحيح، إنهم يتخبّطون، كبقيّة الناس".
نحن أيضًا كنّا نتحرّك في البداية وفق ما تمليه عليه البداهة الصحفيّة، لا وفق خطّة واضحة المعالم، واضعين الجمهور في اعتبارنا في كل خطوة نقدم عليها، وهو ما جعل تغطيتنا الشاملة للجائحة في مارس/آذار الماضي تحقق أعلى المتابعات على الإطلاق، حتى تجاوزنا الأرقام القياسية التي حققتها الجزيرة عام 2011 إبان تغطيتها لأحداث الربيع العربي، بل حتى تغطيتُنا للانتخابات الأميركية في الشهر الماضي ظلت في المرتبة الثانية بعد أزمة كورونا. ولا شكّ أن تحقيق مثل هذه الإنجازات على يد فريق متناثر حول العالم ومن غرفة أخبار بعيدة، لهو أوضح دليل على عزيمة وتفاني فريقنا من الصحفيين، وهو ما أعتزّ به على الدوام.
أنا أؤمن بالقوّة الكامنة في المعاناة المشتركة، رغم ما يعتري ذلك من آلام. لقد كنا قريبين من قرائنا بشكل لم نختبره من قبل، إذ كنا نقدّر تمامًا ما يعنيه فقدان الحريّة في الحركة والتواصل والتضحية بذلك من أجل تجنّب عدوى فيروس غير مرئي، ومحاولة كبح طبيعتنا البشرية المجبولة على التواصل الاجتماعي. ولم يكن أحدٌ في منجًى من هذه التحولات العميقة على نمط حياتنا، حتى أشدّ الناس ثراء وحظوة. لقد أدركت شخصيًّا هذه التغيّرات حين فتحت نافذة سيارتي في أحد الأيام، فجاءني فورًا صوت ابني من المقعد الخلفي يقول بنبرة عاتبة: "ماما، لا تدعي الفيروس يدخل علينا".
لقد سرقت منّا هذه الجائحة أيضًا أحباء لنا، فاختلط وعيُنا بالأرقام القياسية التي نحققها مع حقيقة أنها إنجازاتٌ ترتبط بظروف بائسة تؤثر على ملايين البشر حول العالم. لقد كان ذلك بمثابة تذكير بتلك الغرزة "الساديّة" التي لا يملك الصحفي إلا أن يحيكها في غمرة عمله، في سعيه للنجاح في أن يكون أول من يحصد الخبر المؤلم، وأن يفعل ذلك على النحو السليم. هذه الورطة في عملنا كثيرًا ما تتحول إلى موضوع تندّرٍ بين الزملاء، تمامًا كما صرنا نتندّر على عبارة "ما يحصل في غرفة الأخبار يبقى في غرفة الأخبار".. أحيانًا نلجأ إلى الضحك هربًا من البكاء.
لكن ما نمتاز به في الجزيرة هو قدرتنا على تجاوز ما يعرض لنا من تقارير وأرقام وتوريات حكومية وإحصاءات للوفيات، والتي يحفظها الصحفي ويراجعها عن ظهر قلب، كأرقام تكتب على اللوح وتمسح ليحلّ مكانها أرقام أخرى في اليوم التالي. وفي خضمّ ذلك كلّه، لا نغفل اللمسة الإنسانية في تقاريرنا، بحيث تكون قصص الناس هي المحور التي يدور عليها معظم عملنا.
فنحن نحرص على أن نكون صوتًا مسموعًا للمنسيين، مثل عمال النظافة الذين يخاطرون بحياتهم في ظل أزمة كورونا، أو فتيات الكاميرون اللواتي يخشين ميلادهنّ العاشر لأن ذلك هو العام الذي سيخضعن فيه لكيّ صدورهنّ كما تقضي التقاليد الثقافية هناك، أو تسليط الضوء على أسماء ووجوه من قضوا من الأميركيين السود على يد الشرطة في الولايات المتحدة. وليس ذلك عبر التركيز على الإحصاءات وحسب، بل بالبحث عن القصّة حتى لو كان ذلك يعني أن نتبع خيوطها لأيام عديدة، مثلما فعلنا مع قصّة العاملة المنزلية الغانيّة التي عانت في أيامها الأخيرة بلبنان، وكان اسمها فاوستينا تاي، ولم تتجاوز من العمر 23 عامًا.
ثمّة أيام أخرى أسوأ، حيث لا يكون في وسعنا سوى محاولة الكشف عن زاوية أخرى لما يحصل من أحداث، وأن نساعد المتابعين -كلّ بحسب موقعه وظروفه- على تطوير نظرة أكثر تعقيدًا ودقّة للمشهد.
ولكي أكون صادقة مع نفسي، فلا بدّ أن أعترف بأن العام 2020 أخذ المهمة المنوطة بنا إلى أقصى حدودها، وكانت النتيجة أحيانًا تماهي الحدود الفاصلة بين تقديم الأخبار بدقة وموضوعية، مع التجرّد عن القصص التي نرويها في الأخبار والتجارب التي يعيشها أولئك الذين نحاول أن نوصل صوتهم عبر عملنا الصحفي.
ولقد كنّا نحن أيضًا جزعين من تلك القوّة غير المرئية بالعين المجرّدة لفيروس جديد فرض سطوته على العالم وغيّر طريقة حياتنا وإدارة شؤوننا. نحن كذلك منا الآباء والأمهات، وكان علينا أن نرعى أطفالنا عبر تجربة التعليم المنزلي التي نخوضها لأول مرّة، وصرنا مشتّتين بين اجتماعات على الزوم للعمل وبين التحقق من واجبات الأولاد وسير دروسهم، دون أن ننسى معالجة فضولهم وقلقهم إزاء ما يجري في العالم خارج نافذة المنزل.
لقد مرّ علينا هذا العام الذي شارف على نهايته ونحن معكم ومثلكم، خائفين من الآثار التي خلفتها الجائحة على الاقتصاد العالمي، وما فرضه ذلك من ضرورة خفض الميزانيات والضغط على الموارد والكوادر. كثيرون منا ظلوا محرومين من عيادة أفراد أسرهم ممن أصابهم المرض، أو غير قادرين على السفر لرؤيتهم وهم في أشدّ الحاجة إليهم.
كما حصل خلال الأشهر الماضية أن تلقّيتُ العديد من المكالمات الهاتفية من زملاء نال منهم الاكتئاب والإحباط، وراحوا يبحثون عن أي فرصة ليسمعوا من أحدهم بأن الأمور ستكون على ما يرام. وقد تبين أننا نحتاج بالفعل إلى البكاء أحيانًا، ثم لم يعد الأمر سرًّا حين بدأنا نشر مقالات عن الصحة الذهنية في ظل الوباء.
لعل البعض سيتنفس الصعداء مع حلول العام 2021، ليس ظنًّا منهم بأن حسنات العام الجديد ستمحو سيئات العام الفارط، ولا إنكارًا لحتمية استمرار المآسي في العالم، وإنما هي الحكمة التي اكتسبناها خلال العام 2020 بعد أن تجاوزنا أخيرًا كل ما فيه من تحدّيات.
وهنا أود أن أعبر عن شكري لكافة من تابعونا ولجؤوا إلينا لفهم ما جرى في 2020، حتى في تلك اللحظات التي لم نكن فيها مدركين تمامًا لحقيقة ما حصل. شكرًا لكم، لأنكم بقيتم معنا وتعاطيتم المحتوى الذي صنعناه بمستويات غير مسبوقة، ونعدكم بأننا سنواصل السعي لتحقيق التوازن المنشود بين أجندة الأخبار العالمية واحتياجات متابعينا.
الدرس المستفاد هو أن جوهر عملنا يرتبط بأمر بسيط: أن نقدّم للمتابعين ما يهتمّون بمعرفته والاطّلاع عليه، وأن نؤدّي ذلك على أتمّ وجه.
لكن، لعل الأهمّ من ذلك هو أنه لا يجدر بنا أن نشعر بالإنجاز لمجرّد أننا نقلنا قصّة صحفية ما بتجرّدٍ عن موضوعها وأشخاصها، فهذه الجائحة علّمتنا أن المقاربة الأفضل هي أن ننطلق في العمل الصحفي من ذلك الحسّ بالتجربة الإنسانية المشتركة.
* مقال مترجم عن موقع الجزيرة الإنجليزية.