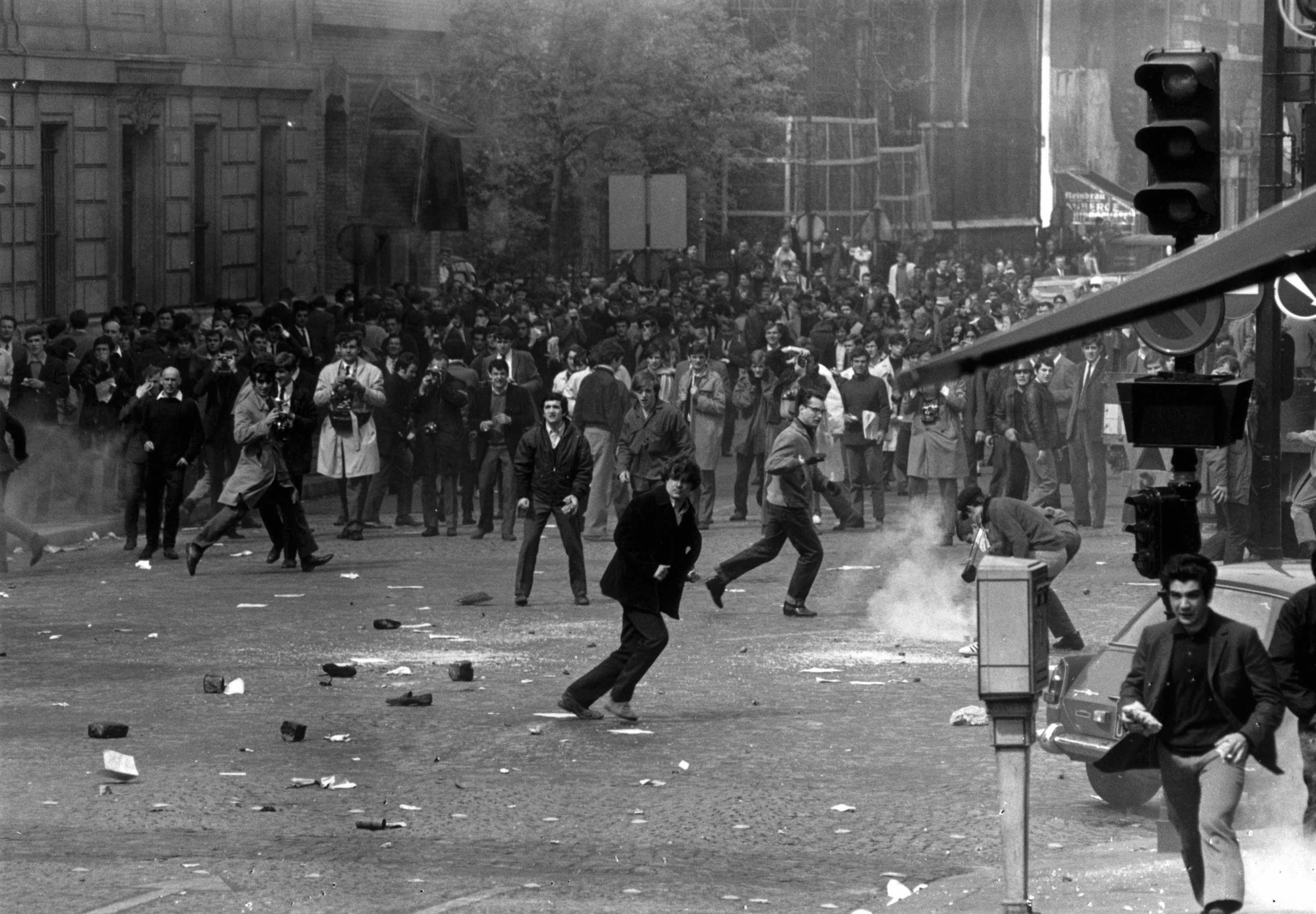كانت المساعدات الأميركية المُعلنة لوسائل الإعلام والصحفيين خارج الولايات المتحدة لا تكاد تُذكر عندما قرّر توماس وينشب مع جيم إيوينغ وجورج كريمسكي عام 1984، تأسيس "المركز الدولي للصحفيين" (ICFJ) ومؤسسة "ألفريد فريندلي" غير الربحية لخدمة الصحفيين، وإتاحة دورات تطوير أداء وزمالات حول العالم.
قبل ذلك التاريخ، كان لوزارة الخارجية الأميركية مثلاً برنامجٌ تستقدم من خلاله صحفيين إلى واشنطن للتدريب، لكن لم تكن هناك أي جهة -حكومية أو خاصة- تُكرّس جهودها تماما -وبشكل علني- لدعم الصحافة الدولية.
أتى العام 1989 ليشكل محطة مفصلية في مجال الاستثمار في المشاريع الصحفية حول العالم. تزامن ذلك مع سقوط "الستار الحديدي" (جدار برلين)، ومن ثم تفكّك الاتحاد السوفياتي، حيث ظهر الإعلام كعنصر فاعل في المجتمعات التي كانت تُعيد بلورة قواها السياسية وديناميات قوتها.
"هرع الأميركيون والأوروبيون لتشجيع الديمقراطية من خلال دعم الصحافة الحرة، إلى أن أصبح تطوير الصحافة المستقلة حول العالم التزامًا بملايين الدولارات تنخرط فيه مئات المنظمات الأميركية والأوروبية"، مثلما وصفت ذلك إيلين هيوم في بحث أجرته عام 2004 بعنوان "البعثات (التبشيرية) الإعلامية" (Media Missionaries)، والذي كان بدوره مدعومًا من منظمات تُعنى بمشاريع التطوير الإعلامي حول العالم.
حكت هيوم عن "600 مليون دولار وربما أكثر بكثير وظّفتها جهات أميركية لدعم الصحافة المستقلة حول العالم بين عامي 1994 و2004". ومن هذه الجهات "الوكالة الأميركية للتنمية" (USAID) التي صرفت خلال 10 سنوات 275 مليون دولار لهذه الغاية، و"المجتمع المفتوح" (Open Society) التي استثمرت سنويًّا 20 مليون دولار على الأقل لمساعدة الصحفيين. هذه أرقام عمرها 16 عاما، وقد تطورت خلال الأعوام القليلة الماضية.
كما استثمر الأوروبيون -بشكل موازٍ- في التدريب وتأمين المعدات وتقديم النصائح القانونية لصحفيين حول العالم. ومن الجهات التي ذكرتها هيوم "الوكالة الدانماركية للتنمية الدولية"، و"منظمة الأمن والتعاون في أوروبا" (OSCE)، والحكومة الهولندية من خلال "الصحافة الآن" (PRESS NOW)، و"الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي" (SIDA)، و"الوكالة الكندية للتنمية الدولية"، ومنظمات ألمانية عدة مثل "فريدريتش إيبرت".
عند متابعة المسار الذي سلكته معظم هذه الوكالات والمنظمات، يظهر أنها ركزت في كل حقبة -لا سيما في الفترات المفصلية- على منطقة بعينها، بينما بدأ اهتمامها بالمنطقة العربية يزداد بعد أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001، وأصبح أكثر وضوحًا وانخراطًا مع بدء الربيع العربي عام 2011.
في مرحلة ما بعد 2011، لعبت المبادرات الإعلامية المستقلة والمنصات التي خرجت من صلب الحراكات الاجتماعية؛ دورًا بارزًا في طرح القضايا الحقوقية والثقافية والاجتماعية، وتقديمها كمسائل تتقاطع بشكل عضوي مع الشأن السياسي.
ولأن تمويل هذا النوع من المبادرات لم يكن يمر بالقنوات الرسمية التي اعتادت عليها سلطات هذه الدول، ولأن القضايا التي طرحتها منصات حديثة بدا سقفها أكثر ارتفاعًا من المعتاد والمسموح به (رسميًّا)، بدأ النقاش يتخذ منحى "مؤامراتيًّا"، حتى تحوّل "التمويل الأجنبي" إلى تهمة تصل حدَّ الملاحقة القانونية في بعض الدول.
ولأن الصحافة التي حاولت منصات عدة خرجت من صلب الربيع العربي تكريسها والعمل على أساسها؛ بدت مكلفة بدون أن تكون مربحة، لكونها عملت على رفع سقف النقاش حول الأزمات المزمنة ومساءلة الجهات المسؤولة عنها، وبالتالي تهديد مصالح مسؤولين كثر، فإن العلاقة التقليدية لوسائل إعلامية عديدة مع الشركات وأسواق الإعلانات (المرتبطة عادة بالقوى الحاكمة) لم تكن ممكنة، فكانت الحاجة إلى موارد مستقلة تؤمّن الانطلاقة والاستمرارية.
منصات عديدة بنت شراكات مع جهات صحفية حول العالم ساعدتها في تطوير محتواها أو تأمين محتوى مجاني، في وقت بدت فيه المنظمات العالمية المعنية بدعم الإعلام وتمويل مشاريعه بابًا آمنًا لتلك المنصات، بحيث يحفظ لها هامشًا واسعًا من الاستقلالية، ويساعدها في طرح قضايا بدت الشوارع "الثائرة" أكثر انفتاحًا على نقاشها.
تشترك معظم المنظمات الدولية التي تدعم المنصات الإعلامية في التأكيد على مبدأي "الديمقراطية" و"الشفافية المالية". وقد ساهم ذلك في تكريس ثقافة جديدة لدى المنصات الإعلامية الحديثة، لم تكن سائدة وفق ديناميات التمويل السياسي والتبرعات التقليدية.
ومع أن التمويل في ذاته ليس جريمة، ولا يوجد في القانون ما يمنعه، فإن خروجه عن القنوات التقليدية التي يمكن للسلطة السيطرة عليها، أدخله في شق مؤامراتي وسلسلة اتهامات عززتها لدى المتلقي العادي كلُّ المخاوف المتراكمة لديه من "الأجندات الخارجية" والدور السلبي الذي لعبته حكومات أجنبية في مسار التغيير الذي شهدته بلدان عربية عدة.
لكن، بعيدًا عن الشق المؤامراتي المُكرّر في النقاش حول التمويل الأجنبي، ثمة شقٌّ آخر على جانب من الأهمية قد يكون أشد تأثيرًا من فرض المموّل الأجنبي لأجندته ومن إشكالية "استقلال الصحافة"، وهو المرتبط "بحدود العمل الصحفي" أو الطرق التي تقارب بها المؤسسات الصحفية عملها وتنتقي وفقها زوايا اهتماماتها.

أنواع التمويل
"نعلم أن الموسيقى الكلاسيكية كانت يومًا ما موسيقى شعبية، لكنها لم تعد كذلك، وباتت تحتاج إلى دعم خيري للصمود.. نحتاج أن نشرح للناس أن تحوّلا مشابهًا حدث للصحافة". هكذا يفسّر رئيس منظمة "بروبوبليكا" (ProPublica) الأميركية للصحافة الاستقصائية ريتشارد توفل الحاجة إلى التمويل.
قد تحمل مقاربة توفل بعضًا من المغالاة، لكنها تعكس جانبًا كبيرًا مما آلت إليه الحال.
وبينما أظهرت جهات صحفية مرموقة مثل "الغارديان" إمكانية الاعتماد على دعم القراء وتمويل الأفراد من خلال عامل ثقة بين القارئ والمنصة الإعلامية يرتكز على المحتوى الجيد والحصري، لم تتمكن منصات إعلامية عربية مستقلة من الاعتماد عليه، فعامل الثقة لم يتحقق لأسباب عدة، وبقيت المنظمات الدولية والجهات المانحة الرافعةَ الأساسية لاستمرار الكثير من المشاريع.
وبحسب "ميديا إمباكت فوندرز" (Media Impact Funders)، صرفت المؤسسات الدولية المانحة بين عامي 2011 و2015 مبالغ تزيد قيمتها عن 1.3 مليار دولار سنويًّا لوسائل الإعلام والصحافة في جميع أنحاء العالم، وشمل ذلك مثلا 250 مليون دولار كل عام لدعم تطوير وسائل الإعلام، و220 مليونا لدعم التقارير الصحفية المستقلة.
في حديث مع الناشطة النسوية ومديرة مؤسسة "أصوات" الفلسطينية غدير الشافعي حول المسألة، وهي على تماس مباشر معها لكون مؤسستها تعمل بتمويل أجنبي، تشير إلى أنه لا يمكن وضع كل مصادر التمويل الأجنبي في خانة واحدة، إذ يجب التمييز بين أنواع التمويل المتوفرة وأهدافها.
تقول غدير: "هناك التمويل الذي يهدف إلى السيطرة على الوضع الراهن وإبقائه على حاله، والتمويل الهادم الذي من شأنه أن يتسبب بضرر من خلال فرض تدخل خارجي على قضايا وسياقات داخلية حساسة، وهناك التمويل الداعم الذي يأخذ بالاعتبار خصوصية كل مجتمع وجاهزيته وسُبُله للتغيير، ويثق بخبرات وعمل ونشاط المؤسسات المتواجدة على الأرض، من أجل إحداث تغيير حقيقي".
من المهم -وفقا للناشطة- الإشارة إلى أن مصادر التمويل الكبيرة -مثل "الوكالة الأميركية للتنمية" والاتحاد الأوروبي- تفرض معاييرها وسياساتها وشروطها، لا سيما في سياقات سياسية حساسة كالسياق الفلسطيني، مما يخلق تحديات وجودية كبيرة ويشكل عبئًا على المؤسسات الصحفية والاجتماعية المحلية، إذا ما أخذنا في الاعتبار ارتباط الوعي الاجتماعي بالموقف السياسي للأفراد.
مع ذلك، تشير غدير إلى أنهم في عملهم يراعون تقاطعية القضايا، أي دعم قضايا النساء والحريات الجندرية باعتبارها أساسية في سيرورة التحرّر. وبسبب ما قالت إنه "تدفيع" ثمن مبادئ المؤسسة التي عملت مثلًا على فضح سياسات "الغسيل الوردي" الإسرائيلية، لا تقبل المؤسسة التمويل المشروط أيًّا كان مصدره.
بدورها، تحكي المسؤولة في "المؤسسة العربية للحريات والمساواة" ومديرة برنامج "النساء في الأخبار" في الشرق الأوسط ميرا عبد الله عن ثلاثة أنواع من العلاقات بين الممولين والجهات المستفيدة من التمويل.
الأول- يظهر لدى الجهات التي تسعى لأي تمويل بغض النظر عن كيفية ترجمته، وهنا نجد تشتتًا في توجهاتها والمواضيع التي تطرحها.
الثاني- هو الذي يأخذ تمويلا على مشروع محدد يتّسق مع توجهاته، وهنا قد يتدخل الممول في وضع معايير تنفيذ المشروع، كفرض "مساواة جندرية"، أي وجود 50% من النساء في مشروع ما.
الثالث- هو شراكة فعلية بين الممول والجهة المستفيدة، تتخطى فكرة مشروع بعينه إلى تعاون طويل الأمد.
أثر التمويل
يناقش بحث مشترك نشره العام الماضي مارتن سكوت وميل بونس وكايت رايت في "دراسات الصحافة"، أثر تمويل المنظمات غير الربحية على العمل الصحفي.
تضمّن البحث حوارًا مع 74 جهة صحفية أظهرت شهاداتها أن تأثير تمويل المؤسسات يتجاوز مسألة استقلال الصحافة -لا سيما أنه "ليس من مصلحة المؤسسات المانحة أن يُنظر إليها على أنها تتدخل في السياسة التحريرية لوسائل الإعلام"- لينعكس على الآليات التي يفهم من خلالها الصحفيون عملهم ويقومون به على أرض الواقع.
وفي نقاش مع مسؤولين بمؤسسات إعلامية عربية وصحفيين يعملون معها، يتشارك كثيرون الحديث عن الجهد الكبير الذي يبذلونه في عملية "التودد" للجهات المموّلة وبناء علاقات معها تجعلهم أكثر حضورًا في المشهد الإعلامي وإحساسًا "بالأمان الاقتصادي".
ولأن التمويل لا يأتي حصرًا عندما تعلن جهة مانحة عبر موقعها الإلكتروني عن رغبتها في تمويل مشروع يناقش قضية معيّنة وتدعو المؤسسات الإعلامية إلى تقديم مخطط تنال على أساسه التمويل، فهو يتم أحياناً من خلال مسار غير رسمي.
يحكي أحد الصحفيين عن مشاركته في لقاءات ومؤتمرات -بتكليف من مؤسسته- بغرض توسيع شبكة العلاقات والتعرف على ممولين محتملين، والبحث معهم عن مصالح مشتركة. تركيز الصحفي على هذه "المهمة" الموكلة إليه في مؤتمر ما يكون أكثر من اهتمامه بالتشبيك مع صحفيين آخرين وإجراء نقاشات تصب في صلب العمل الصحفي.
ولأن المموّل يسعى كذلك نحو شريك موثوق -وهو أمر منطقي- فإن ذلك يترك أثرًا سلبيًّا في بعض الأحيان، إذ يشكو عاملون في الحقل الصحفي من أن المجموعات نفسها تحصل دائمًا على التمويل، وهذا يغلق الباب أمام مؤسسات ومبادرات جديدة ومهمة لكي تكتسب حضورًا وتأثيرًا.
في هذا السياق، تجد مؤسسات صحفية نفسها إزاء سؤال أساسي: هل نصرف جهدًا وطاقة على البحث عن المشاكل الاجتماعية الفعلية التي تهم شرائح المجتمع وتقديم محتوى يحاكيها، أم نركز على القضايا التي نعتقد أنها تهم المموّل، ونستثمر أكثر في تحسين صورة المؤسسة وقولبتها بشكل يراعي "ترندات" التمويل؟
من جهة ثانية، تبرز مسألة مطالبة الممول للمؤسسة الصحفية بإثبات ما حققته المشاريع الصحفية التي يدعمها. وبما أن مشاريع عديدة -حتى الضخمة منها- لا تترك أثرًا واضحًا في دول لم تعتد المساءلة والمحاسبة، فقد تهمل المؤسسات الصحفية المواضيع الشائكة التي تأخذ وقتًا أطول لصالح محتوى يُعتقد سلفًا أن تأثيره سيكون أوضح.
"الترند" الحقوقي والمعطى الثقافي
من بين أكثر أنواع الدعم التي تقدمها الجهات الدولية لمؤسسات صحفية عربية، هي تلك الهادفة إلى تغطية الأخبار المتعلقة بمواضيع كالتنمية وحقوق الإنسان والعنف ضد المرأة والحريات.
وبينما يتزايد الدعم المخصص لمواضيع من هذا القبيل، تبرز مخاوف من أن يأتي ذلك على حساب تغطية مواضيع في مجالات أخرى أقل جاذبية بالنسبة للأطراف المانحة، لكنها قد تشكل أولوية للمجتمعات المحلية.
تعلق الباحثة والأستاذة الجامعية نهوند القادري على التمويل الأجنبي لبلدان العالم الثالث باعتباره "من أشكال الكولونيالية، أو الاستعمار الثقافي والفكري الناعم"، وترى فيه "استغلالا للحاجة المادية من أجل العمل على مواضيع يحدد الممول سلفًا مقارباتها، من دون الأخذ في الاعتبار الحاجات الفعلية للناس والمناخ الثقافي والسياسي السائد".
وحتى عناوين حقوق الإنسان وقضايا الحريات التي يحملها المموّل الأجنبي، تُظهر -برأي الباحثة- معضلةً كبيرة مرتبطة "بازدواجية المعايير"، فقضايا الحريات "تحددها البلدان الغربية المتطورة بطريقة تتلاءم مع حاجاتها وسياساتها".
وبينما يمر طرح أي قضية شائكة في الدول المتقدمة بعدة مراحل، منها تحوّل القضية إلى إشكالية ذهنية وفكرية، ومن ثم يأتي الناشطون ويحملون رايتها، وبعد ذلك يتلقفها الإعلام ويغوص في كواليسها حتى يوصلها إلى أصحاب القرار والمؤثرين، تختلف مقاربة القضايا الشائكة في المنطقة العربية، حيث يحمل الإعلام عناوين كبرى تتماشى مع توجهات الممول دون أن تكون قد مرّت "بالمراحل المنطقية"، ودون أن تكون قد أخذت حقها من التمهيد لتجنّب طرحها دون استعراض أو استفزاز.
تبرز مسألة أخرى تحدد معالم هذا الاتجاه، وهي أن أغلبية الممولين يتكلمون الإنجليزية حصرًا، مما يشكل عائقًا أمام مبادرات محلية فعلية وحقيقية من الوصول إلى الممولين الكبار، وتنحصر الفرص في أولئك الضالعين بكواليس عالم التمويل ولغته. كما تخلق اللغة أزمة أمام الممول الذي يعجز أحيانًا عن فهم الواقع الفعلي للقضية التي يمولها، بما يشكل خسارة للجهد والوقت.

وإذا أخذنا مثالا حول تمويل مشروع إعلامي يتضمن تغطية قضايا النساء في المناطق النائية وتدريبهن على رواية قصصهن، يرفع المموّل من سقف توقعاته بأن "يُغيّر حياة ضحايا المجتمع الذكوري"، ولا تساعده الجهة التي تستميت أحيانًا لاستقبال التمويل في خفض هذا السقف والنظر إلى الأمور بواقعية. وعند التنفيذ تبدأ المشكلات بالظهور، منها -على سبيل المثال- صعوبة الوصول إلى الكثير من النساء المستهدفات بالمشروع.
وقد يقدم المثال السابق عن النساء في المناطق النائية زاوية أخرى لمقاربة الموضوع، وهي المتعلقة باللغة الصحفية المستخدمة في هذا النوع من المشاريع، كمصطلحات "تمكين المرأة" و"العدالة الجندرية" التي تحصر أحيانًا النقاش في دوائر نخبوية ضيقة لا تصل إلى الفئة المستهدفة.
هكذا، نجد أنفسنا إزاء مروحة واسعة من المصطلحات التي جرى "استيرادها" بدل أن تخرج من أرض الواقع، فحمَلت إسقاطاتِها الغربية، وبالتالي حساسيةَ غربتها الدائمة عن محيطها المباشر.
خلال حفلٍ أُقيم لتكريمها عام 2015، سُئلت قاضية المحكمة العليا روث بادر غينسبرغ أن توجّه رسالة إلى النساء انطلاقًا من تجربتها التي امتدت لأكثر من نصف قرن كطالبة وناشطة ومحامية حقوقية وأستاذة قانون، والتي جعلتها واحدة من أيقونات النضال النسوي والحقوقي حول العالم. كان جواب غينسبرغ بجملة واحدة تمّ تداولها بكثرة في الأيام الماضية تزامنًا مع إعلان خبر وفاتها: "حارِبن من أجل القضايا التي تُؤمِنّ بها، لكن ليكن ذلك بطريقة تحمل الآخرين على الانضمام إلى صفوفكن".
الوصفة التي ساقتها غينسبرغ انطلقت من ضرورة ربط التغيير الاجتماعي بالعمل المنظّم، لكنها ربطت فعالية الأخير -بشكل أساسي- بقدرته على الاستقطاب ومحاكاة "الآخرين" بلغة يفهمونها، فتتوحد القوى المؤثرة في قضية بعينها في مواجهة ما يُفترض أن يكون الخصم الأساسي.
وإذا ما حملنا هذه الوصفة إلى دائرة العمل الصحفي في شقه الخبري أو المعمّق، نجد أنها تُحاكي المعضلة الأساسية التي تواجهها منصات صحفية عديدة تُعنى بقضايا حقوق الإنسان والمشاكل الاجتماعية والقضايا التي تُعتبر تابوهات في مجتمعات المنطقة، وهي غربة المقاربات الصحفية في أحيان عديدة عن الواقع الفعلي المُعاش.
يمكن ربط هذه المشكلة بتركيز جهات صحفية عديدة على لغة المموّل وثقافته أكثر من بذل الجهد لمخاطبة شرائح المجتمع المعنية بالمواضيع التي تطرحها، فيتحول الأمر إلى دائرة "بزنس" مغلقة بين الصحفيين والممولين، غريبة عن الحاجات الفعلية للفئات المستهدفة بالمشاريع.
في المقابل، برز وعي متزايد في السنوات القليلة الماضية لدى بعض الجهات المُموِّلة حول هذه الإشكاليات، وقد بدأت بمراجعة إستراتيجيتها التمويلية، فضلا عن تعزيز فكرة "المانح الوسيط" الذي يموّل مشاريع صغيرة من تمويل كبير حصل عليه، والذي يكون عادة على تماس أكبر مع المجتمعات المحلية.
وفي حديث مع مسؤولة عن مراجعة مشاريع تمويل، تتعاون مع جهتين مختلفتين، تشير إلى أن "الإستراتيجيات يتم تعديلها كل فترة، وقد تعلمت الجهات الممولة مع الوقت الكثير من التعقيدات المرتبطة بالعمل الصحفي في المنطقة العربية، وهي تُطوّر آليات دعمها على هذا الأساس".
لا يمكن الجزم بأن التغييرات التي يشهدها العمل الصحفي بفعل التمويل الأجنبي كلها إيجابية أو سلبية، إذ أظهر تسليط الضوء على مواضيع حقوقية إشكاليةٍ محددة -بفضل هذا التمويل- أثرًا إيجابيًّا على رفع الوعي الاجتماعي وتعزيز منطق المحاسبة، في مقابل انتقادات طالت هذا التوجه الذي قد يؤدي إلى تهميش مواضيع إشكالية أو شرائح اجتماعية لا تُلائم "الترند".
قد يختصر ما كتبه سكوت وزميلاه في خاتمة بحثهم دوافع القلق الأساسي من هذا النوع من التمويل، على أهميته، إذ يقولون إن "ما يثير قلقنا خصوصًا هو أن تشهد طبيعة الصحافة والدور الذي تلعبه في المسار الديمقراطي والحقوقي؛ تغييرات على يد مجموعة من المؤسسات المانحة، لا على يد الصحفيين أنفسهم".