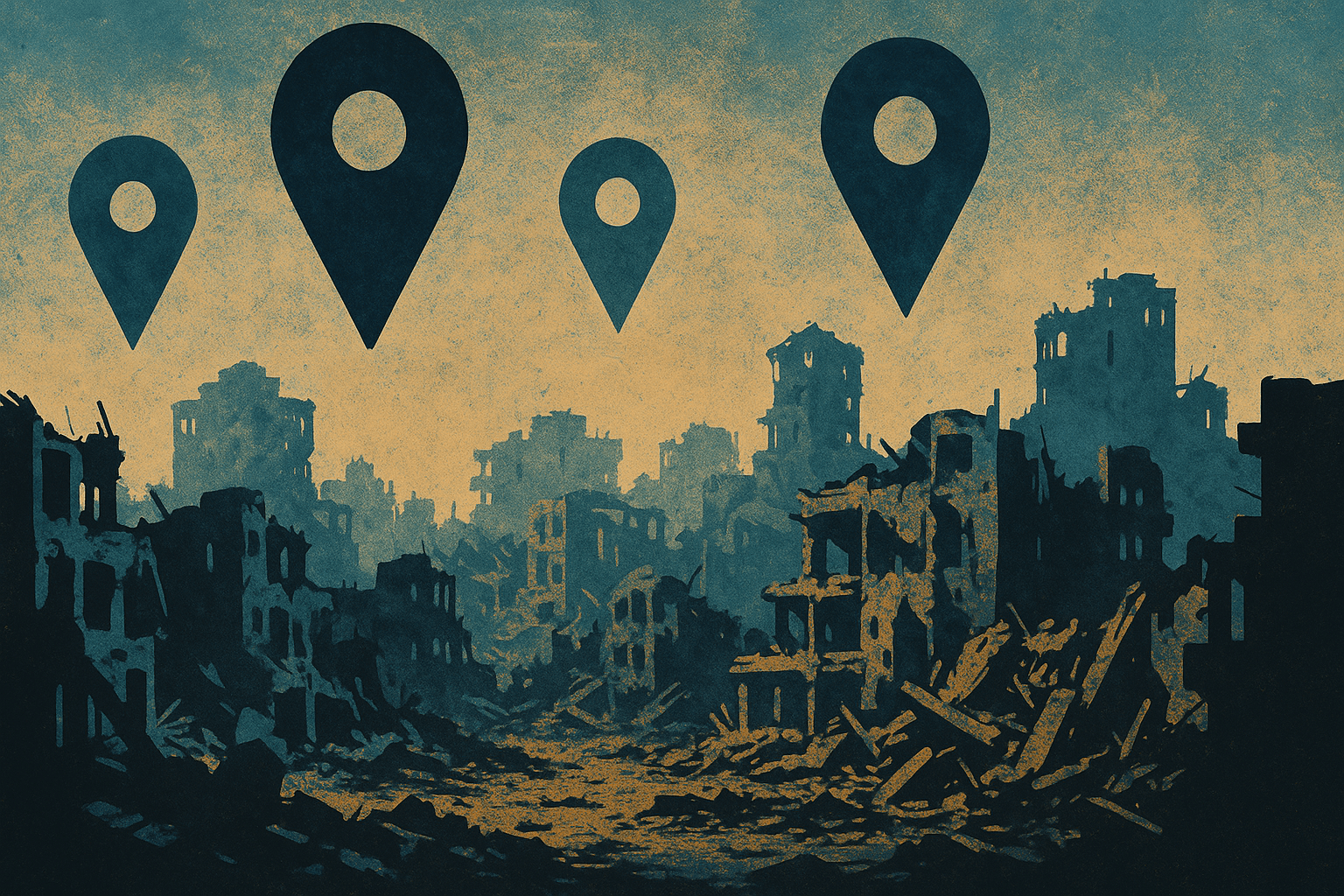كان صباحا شتويا قارسا من شهر نوفمبر/تشرين الثاني عام 2015. كنت جالسة بين 18 امرأة في أتمقام، عاصمة منطقة نيلوم في الشطر الباكستاني من كشمير. كان لدى كل امرأة قصة لتحكيها، عن فقد الأحبة ودمار المنازل وانقطاع سبل الرزق والعيش. وبما أني كاتبة مهتمة بالتاريخ الشفوي، فقد قررت الذهاب هناك لتوثيق تلك القصص، ولفهم التجارب اليومية المتعلقة بالعيش في أوضاع عنيفة، فهمًا يتجاوز روايات المسؤولين ولغة الأرقام الجافة.
أتمقام واحدة من بلدات وقرى عديدة محصورة بين المواقع العسكرية الهندية والباكستانية في كشمير. وتشير التقديرات إلى أن هنالك ما يقارب 285 قرية على طول خط التماس في الجزء الخاضع للسيطرة الباكستانية وحده، وقد أدت الرشقات والقصف المدفعي الثقيل على طول خط التماس الذي يفصل جزأي جامو وكشمير المتنازع عليهما بين الهند والباكستان إلى استهداف العديد من هذه البلدات والقرى منذ مطلع التسعينات، وهو ما حال دون تمتع أهلها بفترات هدوء ولو مؤقتة كانت من المفترض أن ترافق اتفاقات الهدنة.
في التسعينيات "عم الخوف الأرجاء"، كما تخبرني إحدى السيدات، وتضيف: "كان إطلاق النار تهديدًا لا ينقطع في أي وقت... في إحدى المرات سقطت قذيفة هاون في البقعة التي تجلسين فيها الآن. وحين يحالفنا الحظ ونظل أحياء بعد قصف ما، فإننا لم ندرِ إن كان الموت سيصيبنا بعدها بعشر دقائق".
عندما اكتسب الكفاح الكشميري ضد الاحتلال المزيد من الزخم في أواخر الثمانينات، اتهمت الهند باكستان بتأجيج القتال في كشمير، فتصاعد التوتر على خط التماس. البعض تمكنوا من الانتقال إلى مدن بعيدة، وبعض الرجال انتقلوا إلى مدن أكبر مثل مظفر أباد (عاصمة الجزء الخاضع للسيطرة الباكستانية من كشمير) أو لاهور أو كراتشي بهدف البحث عن عمل، ولكن الكثيرين، خاصة من النساء والأطفال وكبار السن، لم يغادروا. العديد من النساء في الغرفة ذلك اليوم أخبرنني أنهن لم يحظين برفاهية اختيار المغادرة من عدمه، فقد كان لا بد لأحد ما أن يعتني بالماشية والمنزل والأرض، فلم يكن بمقدور الجميع المغادرة.
جلسنا جميعا حتى وقت متأخر من مساء ذلك اليوم، كانت أكواب الشاي الساخن تأتي لتدور علينا كل بضع ساعات فتختلط مع أحاديثنا، بما يضفي هالة من الحميمية رغم قسوة الجو. الجميع، من الجدات الطاعنات في السن وحتى الصبايا المولودات مطلع التسعينات، كانت لديهن ذكريات يرغبن في الحديث عنها. كانت إحداهن تبدأ رواية القصة فتنبري الأخريات ليدلين بتفاصيل إضافية، لتتداخل ذكرياتهن وتتوسع وتحملنا جميعا نحو طرف قصيّ من الحكاية. تحدثن عن أيام قضينها محشورات في المخابئ بلا طعام ولا ماء، وعن ليالٍ أمضينها متلاصقات في عتمة موحشة راجيات ألا تجد قذيفة هاون طريقها إليهن. تذكرن كيف أن أطفالهن بكوا من الجوع، وكيف أنه لم يكن بمقدورهن حتى إشعال جذوة من النار للطهو عليها خوفا من أن يكشفن عن موقعهن، وتذكرن أيضا أولئك الذين لم يكونوا محظوظين بقدرهن فلحقتهم العاهات أو أصابهم الموت.
تشير التقديرات إلى أن ما بين 2500 إلى 3000 شخص قضوا حتفهم في حوادث مرتبطة بالقصف المدفعي في وادي نيلوم قبل التوصل إلى الهدنة عام 2003، وقد كانت النساء في الغرفة على معرفة شخصية بالكثير من أولئك القتلى، بل إن أحد القتلى كان رجلا في الثانية والعشرين من العمر وكنت أجلس في منزله.
ما إن بدأنا الحديث ذلك الصباح حتى أخبرتني عن مقتل ابن عمها الذي كان طفلا في التسعينات، فقالت إن قذيفة هاون أصابته وإنه "لم يتبق شيء من جسده. كان مثل اللحم المفروم". كنت لا زلت أحاول أن أستوعب تلك القصة إلا أن أمه تقدمت ضامة بيديها صورة لشاب في مقتبل العمر، رفعتها وسألتني: "هل ترين هذه الصورة؟ هذا ابني. كنت سأصبح جدة اليوم لو أنه لم يزل على قيد الحياة، ولكنه رحل شهيدا. كان على الطريق الجانبي ذاهبا إلى العمل إلا أن قذيفة هاون سقطت عليه، وبعدها مباشرة دهسته سيارة مسرعة. كان علي أن ألملم بيدي أشلاءه وعظامه كي نتمكن من دفنه".
أكملت كلامها واقفة أمامي لبضع ثوان، صوت أنفاسها عالٍ، ونظراتها مسمّرة إزائي، ثم مشت إلى زاوية الغرفة وجلست لتستمع بهدوء إلى ما تقوله باقي السيدات عن ابنها وعن قصصهن في الفقد.
أتى صوت عمته من الجانب فقالت: "كان علي أن أدفع بيدي المجردتين بعض أشلاء لحمه لأعيدها إلى جثته، وذلك لكي نتمكن من إتمام الجنازة. مرت أوقات استمر فيها إطلاق النار على مدى أيام عديدة، حتى إننا لم نكن نتمكن من الخروج لالتقاط جثث القتلى... كانت الجثث تتعفن في الخارج في الوقت الذي كنا نبكي أصحابها ونحن داخل المخابئ بلا طعام ولا ماء طوال أيام".
القصص وتبعاتها
مع حلول ذلك الوقت من عام 2015 كنت قد قضيت سنوات عديدة في إجراء المقابلات المتخصصة في التاريخ الشفوي، مع ناجين من أحداث تقسيم الهند البريطانية عام 1947، وكنت قد وثقت الكثير من الشهادات حول أحداث العنف، ولكنني رغم عملي على ذكريات الصدمات النفسية إلا أنني لم أكن أعرف كيف أتجاوب معها، وأنّى لأي شخص التجاوب معها حقًا؟ كيف نكتب عن مثل هذه التجارب؟ ألفيت نفسي أطرح المزيد من هذه الأسئلة على مدى سنوات، وفكرت بالآثار التي تترتب على نقل المراسلين أو الصحفيين أو المؤرخين للتاريخ الشفوي لقصص خاصة بأشخاص آخرين، وكيف نضمن أن طرق طرحنا للأسئلة وتوثيقنا للقصص ونشرها ستكون أخلاقية وغير مخلّة بحساسية الموقف؟
في كتابها المهم "الجسد المتألم: صنع العالم وتفكيكه" (The Body in Pain: The Making and Unmaking of the World)، تؤكد إلين سكاري أن الألم الشديد يشلّ اللغة، ولكنها تقول أيضا إنه من المهم في الوقت ذاته أن نكون قادرين على التعبير عن الألم لأن إنكار الشعور به رغم وجوده يضاعف سطوة الجلاد. وهكذا ففي حين أن العنف والألم يمكن أن يعطلا اللغة، إذ ربما لا توجد كلمات قادرة على وصف تجربة مر بها أحدهم، إلا أن القدرة على الحديث والمشاركة والتعبير يمكن أن تكون ذات أثر علاجي. وشهادات الناجين والتاريخ المحكي على ألسنتهم والمقابلات معهم يمكن أن تؤدي دورا هاما في خلق مساحة لمشاركة القصة والإقرار بها، بل وربما حتى لعلاجها. إلا أن الطرق التي قد يختارها الناس للمشاركة، أو في بعض الأحيان لعدم المشاركة، هي طرق متباينة ومختلفة. فالذكريات، خاصة تلك التي تشتمل على عنف أو صدمات نفسية، غالبا ما تظهر مجزأة في عبارات قصيرة ووقفات وتنهّدات ولحظات صمت، فكيف يمكن أن يترجم كل ذلك على الورق؟ وكيف علينا نحن الكتاب أن ننسجم مع حقيقة أن الكتابة غالبا ما تحتاج إلى بناء روائي متماسك ومتسلسل زمنيا، بل وقابل للفهم توضح فيه مسببات العنف وأصوله وتفسيراته، وهو ما يتناقض في الغالب مع تجربة راوي القصة الأصلي، وطريقته في سردها، بكل ما تتسم به من الفوضى وعدم الترابط والانفصال عن المسببات؟ كيف يمكن للحاجة إلى خلق هذه الرواية المتسلسلة زمنيا أن تبلور كيفية طرح الأسئلة وماهيتها قبل كل شيء؟
إلغاء التصورات المسبقة عن الصدمات النفسية
بغض النظر عن بعض الحالات التي يكون فيها الكتاب حاضرين عند وقوع أعمال العنف، توثق معظم القصص بعد وقوع "أحداث" العنف، إلا أن الكتاب نادرا ما يذهبون هناك وهم صفحة بيضاء، فمجموعة التصورات المتجانسة حول شكل المعاناة أو الصدمات النفسية التي يتم تداولها في وسائل الإعلام المعروفة، تؤثر في التصورات والتوقعات المسبقة حول أثر العنف على الناس، وهو ما يصيغ شكل القصص التي نتوقعها والـ "حقائق" التي نعطي لها الأولوية. ولكن هذه التصورات المتجانسة والجاهزة غالبا ما تكون منفصلة عن الواقع، إذ إنه لا توجد طريقة نموذجية للمرور بالتجارب أو لرواية تجربة المرور بصدمة نفسية، كما أن القصة التي قد نعتقد أنها مهمة من وجهة نظرنا ككتّاب، قد لا تكون القصة التي يُعنى الناجون بروايتها.
وفي حين أن المشاركة يمكن أن تكون ذات أثر علاجي بالنسبة للبعض، فإن البعض الآخر يتمسك بذكريات لا يستطيع مشاركتها أو لا يرغب في مشاركتها. وعليه فإن الضغط والإصرار على الحصول على قصة، خاصة ذلك النوع المحدد جدا من القصص الذي يتوافق مع توقعاتنا عن هيئة الضحايا وأنماط تعبيرهم، لا يثير مخاوف أخلاقية خطيرة فحسب، بل ويمكن أن تكون له نتائج وخيمة. ذلك أن الأشخاص الذين لا تنسكب حكاياتهم في القالب الجاهز للطريقة المتوقعة لرواية القصة إما أن يتم تجاهلهم والتشكيك في صحة قصصهم ومصداقيتها، وإما أن تعرض هذه القصص على نحو يسلبها قيمتها، بحيث تكون جافّة وباردة، وعلى مسافة بعيدة جدًا عن الحدث إلى حدّ يوحي بعدم الاكتراث والتعاطف.
خلال إحدى فترات وقف إطلاق النار، قالت لي إحدى النساء اللواتي التقيت بهن في كشمير إنها خرجت لتحمم رضيعها ابن الستة شهور ثم تركته على الشرفة لينام في حين ذهبت هي لتكمل أعمالها المنزلية. وتضيف: "كنا نسمع أن الوضع آمن"، كذلك الذي نعيشه هذه اللحظة". كانت لا تزال في الطرف الآخر من المنزل تقوم بأعمال التنظيف عندما اندلع القصف فجأة ومن دون سابق إنذار، فركضت إلى المخبأ للنجاة ولم تتمكن من الذهاب لإنقاذ ابنها. كان يرفس بقدميه ويصرخ في الخارج حين أيقظته أصوات الانفجارات المدوية، وبعد ساعة غيرت النيران مسارها فتمكنت الأم من الإسراع إلى ابنها، وهي لا تعرف إن كان على قيد الحياة. عندما قدمت هذه القصة ضمن قصص أخرى إلى رئيس التحرير علق قائلًا إنها لا تشي بالصدقيّة والموثوقية، إذ استبعد أن تتمكن أم من ترك وليدها وحده في الخارج، وقال إنه من الصعب تصديق ذلك.
إن تصوراتنا عن الأمومة والتضحية والصدمات النفسية والحماية متأثرة بالصور السائدة حولنا، فالتوقعات المثالية بأن الأم الصالحة الحنون التي ترعى أبناءها ستنقذ طفلها مهما كلفها الأمر قبل أن تنقذ نفسها، تجعل قصة هذه الأم تبدو غريبة وغير قابلة للتصديق وغير حقيقية، كما تضع الأم وتجربتها مع الأمومة موضع الشك والاتهام بالأنانية وغير قابلة للفهم. ولكن علينا أن نسأل أنفسنا: من أين أتت هذه التصورات والتوقعات حول الكيفية التي يتوجب على الناس التصرف وفقها والتي كان ينبغي عليهم أن يتصرفوا وفقها؟ وإلى أي مدى ترتبط هذه التوقعات أو تنفصل عن التجارب الحقيقية التي عاشها الناس؟ ما الذي يعنيه أن تعيش في منطقة نزاع، في وسط قصف عنيف لا تدري فيه إن كنت أنت أو أي من أحبائك ستظلون على قيد الحياة في غضون لحظات؟ وما الذي يعنيه أن تدرك في تلك اللحظة أنك لن تنجو إن ركضت للناحية الأخرى من المنزل لإنقاذ طفلك، وأن تدرك أنكما قد تقتلان كلاكما، وأن الخيار الوحيد لديك هو أن تختبئ وتتشبث ببصيص أمل بأن لا تمزق الشظايا طفلك؟
قد يتفاعل الناس أو لا يتفاعلون، وقد يستجيبون أو لا يستجيبون، وعلى نحو يتوافق مع توقعاتنا عادة. أما الاستجابات للصدمة النفسية فلها عدة تجليّات متباينة، إذ تظهر بطرق مختلفة في أوقات مختلفة. ليس ثمّة طريقة واحدة لاستعادة قصّة ما أو روايتها، لا سيما حين تتعلق بحدث عنيف صادم. بالنسبة للأشخاص الذين مروا بأحداث عنف أو صدمات نفسية لا يعتبر الحدث لحظة ساكنة، وأنه وقع وانقضى وأصبح جزءا من الماضي، بل هو في ذواتهم واقعة متطوّرة، وعملية مستمرّة (process). وبغض النظر عن طول المدة التي تفصل بين التجارب ووقت قصها على المهتمين بالتاريخ الشفوي والكتاب والصحفيين، فإنه يمكن للجروح أن تُنكَأ مجددا بطرق بسيطة، لذلك فمن المهم أن تروى القصص لو توفرت الرغبة في الإفصاح عنها، لكن على ألا يكون ذلك متسقًا مع واقعها كما يراه الراوي، لا كما يتسق مع توقعات السامع، وحتى لو زعزعت رواية الشاهد توقعاتنا عما يمكن أن يكون هو الحقيقة الواقعة.
ثمة أوقات تكون الرواية فيها غير متماسكة ومخالفة لمنطق التسلسل الزمني المتوقع، وتتألف من عبارات قصيرة ووقفات وتنهدات ويتخللها لحظات صمت طويلة، وهو ما يعني ضرورة الإصغاء، لا إلى الكلمات وحسب، بل إلى كل العناصر غير المنطوقة، مع التنبه دومًا إلى أن القصّة غير ملزمة بالشكل المناسب للقالب الجاهز الذي نتوقعه عادة.
لحظة عبور الألم
بالعودة إلى الغرفة في وادي نيلوم في ذلك الصباح الشتوي، غادرت والدة الشاب الكشميري العشريني القتيل، ثم عادت ومعها صورة أخرى لابنها، قربتها إلي مجددا وقالت: "انظري إليه، ما الذي فعله ليستحق الموت؟ قتل في الثانية والعشرين من العمر، الثانية والعشرين فقط". نظرت مليًا في الصورة، فرأيت شابًا حليق الذقن بقميص أزرق يحدق بي، وسرعان ما شعرت باضطراب في معدتي وأنا أتخيل جسده الممزق أشلاء من عظام ولحم. نظرت إليها وامتلأت عيناي بالدموع، في حين كانت هي ترمقني بعيون جافة وملامح مشدودة. تبادلنا النظرات على مدى دقائق، ثم سحبت الأم المكلومة تلك الصورة من بين يدي ببطء وغادرت الغرفة. ظننت أنها لن تعود، لكنها وبعد عشرة دقائق عادت ومعها أكواب شاي ساخن وحلوى.
استأنفنا الجلسة، نأكل ونتبادل أطراف الحديث، بل ورحنا نضحك عند التطرق لمواضيع طريفة عابرة، ولكن روايتها للصدمة النفسية ولما مرت به ظهرت طوال اليوم على شكل ذكريات ملموسة في صور ابنها وفي صمتها وعباراتها القصيرة، وهو ما بدا مخالفًا للتصورات المتوقعة السائدة عن عن المعاناة وحياة الضحايا وعن الشكل المفترض للحزن.
قبل أن أغادر منزلها ذلك اليوم أمسكت بيدي وطلبت مني أن أرى أحد المخابئ معها، قالت: "أريد أن أرى كم من المدة ستستطيعين الصمود في أحدها"، فوافقت بعد تردد وقادتني إلى طريق صخري ويدي مشدودة على يدها. مشينا عبر غرفة ضيّقة ومعتمة. أغلقت الباب خلفنا فانقطع عنا النور والهواء على الفور، وشعرت بالاختناق. ظلت تمسك بيدي وسألتني في ذلك الظلام الحالك: "تخيلي أن تكبري هنا، ما الذي سيفعله ذلك بك؟"
لقد عاشت هذه السيدة خمسة عشر عامًا من الحرب والصراع، وأرادت مني أن أجرب لحظة مما عاشته، لحظة لا يمكن للكلمات أن تصفها أو تفسرها بدقة رغم الساعات التي قضيناها بالحديث ذلك اليوم. كان ذلك هو الواقع الذي عاشته، ولم يكن مجرد قصة أو حدث يمكنها أن تصفه كلحظةٍ مفارقةٍ في الماضي. فما حصل قابع في حاضرها، تكاد تراه في كل شيء.



















![Palestinian journalists attempt to connect to the internet using their phones in Rafah on the southern Gaza Strip. [Said Khatib/AFP]](/sites/default/files/ajr/2025/34962UB-highres-1705225575%20Large.jpeg)