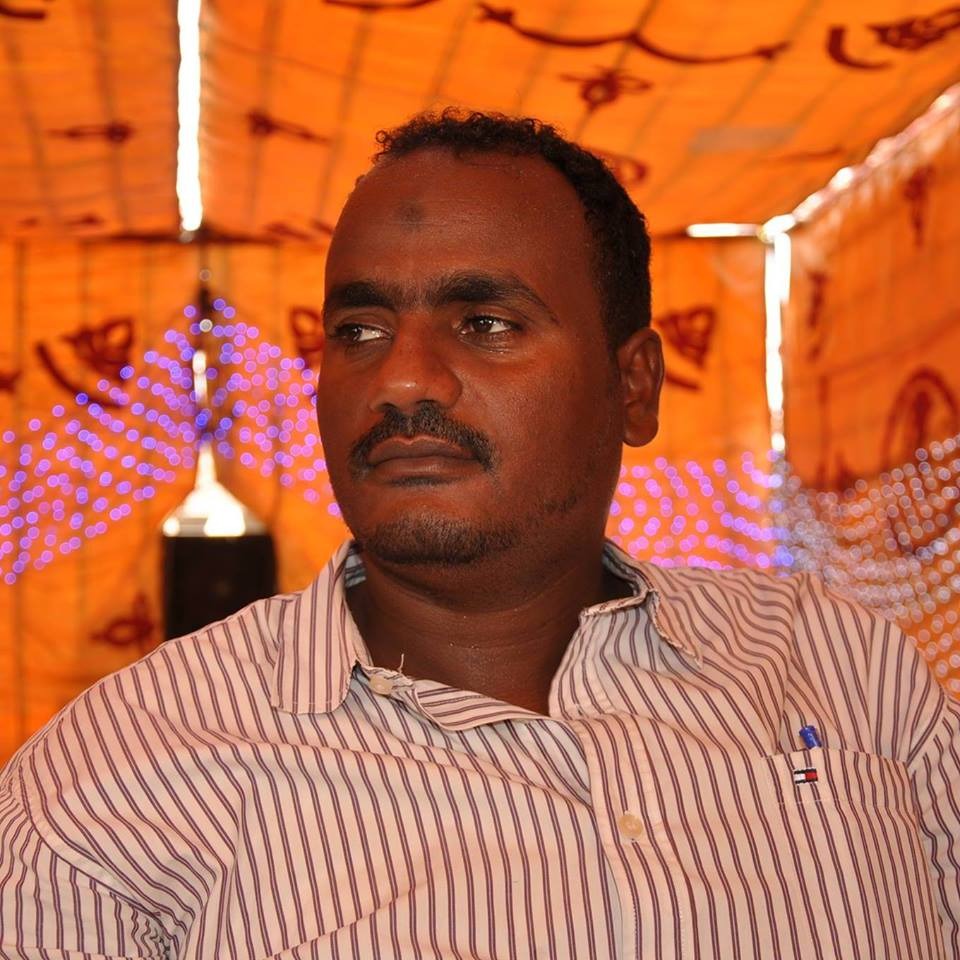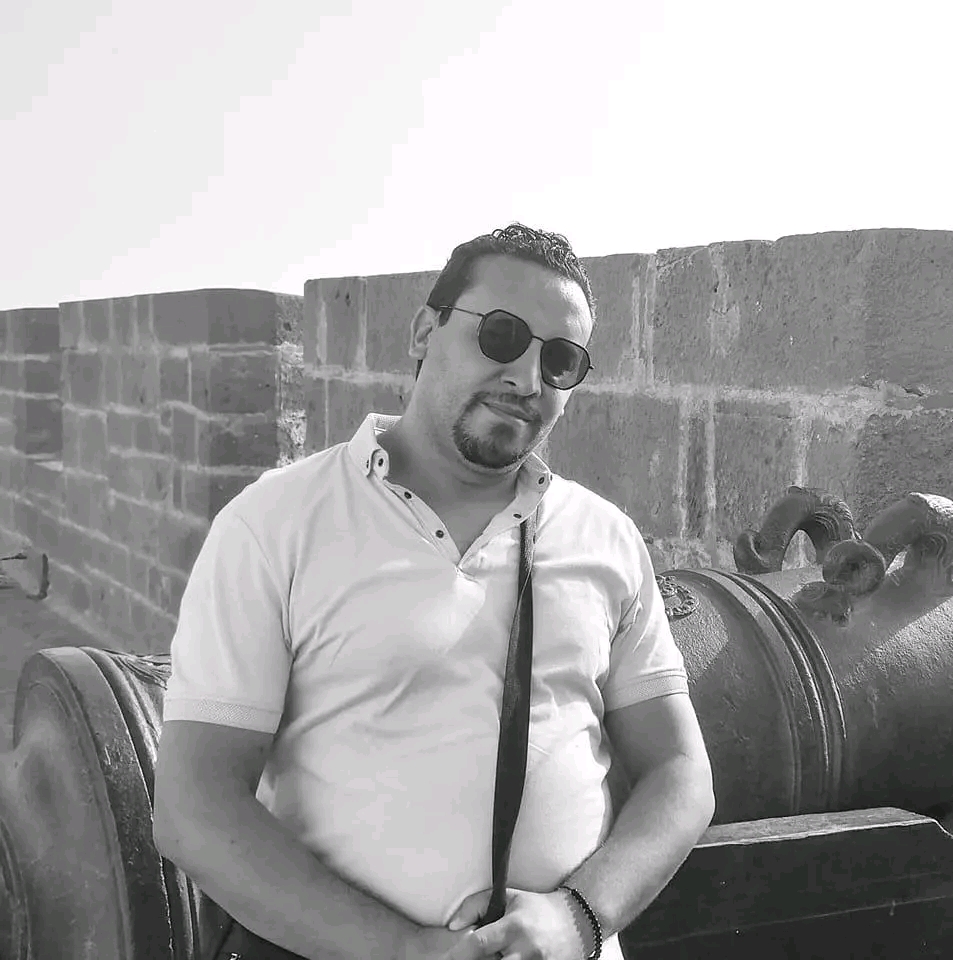دفعتني ملاحظة "التحوّلات الثوريّة" التي شهدتها المنظومة الاتصاليّة وإسهامها في فرض مجموعة من القضايا والإشكاليّات في أسلوب ممارسة مهن الإعلام، إلى التقصّي لمعرفة القواعد التي يتمّ على أساسها إعداد طلاّب الصحافة وتكوينهم في كليّات ومعاهد الجامعات العربيّة، للتعامل مع تلك التحوّلات. هذه الرغبة في التقصي، تجد تفسيرها بسبب سيادة للمنطق التقني على الصناعة الإعلاميّة وأنماط استهلاك المعلومات وإنتاجها ونشرها ومشاركتها، الأمر الذي أوحى بأنّ هناك إقحاماً لمفاهيم جديدة في العمل الإعلامي وآليّات اشتغاله. وأحد أشكال تمظهر تلك "التغيّرات المفاهيميّة"، يكمن في التسطيح الذي يتبدّى في طريقة تغطية الكثير من الصحفيّين ومعالجتهم للأحداث والمواضيع والقضايا. فهي غالباً ما تعكس غياباً كبيرا لخلفيّة معرفيّة وثقافيّة تسمح لهم بالنظر إلى هذه الأحداث بنوعٍ من العمق والدراية وتقديم مضامين صحفيّة "بنّاءة". وإذا كان علماء الاجتماع يكادون يُجمِعون على دورٍ مهول لوسائل الإعلام في تكوين المعرفة والوعي لدى الأفراد وتوجيه سلوكهم، غير أنّ الواقع يُبيِّن أنّ معظم وسائل الإعلام العربيّة لا تزال غير قادرة على تقديم نموذج إعلامي مهني يؤدّي هذا الدور الذي يهدف - بخاصّة - إلى الخدمة العامّة (1).
علم الاجتماع في حَرَم الإعلام
قد يظنّ البعض أنّ للصحافة وظيفة واحدة هي الإخبار، ولتأديتها يتحوّل الصحفيّون إلى مجرّد مستوعبٍ للمعلومات ينقلونها إلى العموم من المصادر والبقاع المختلفة في العالم؛ لكنّهم لا يدركون -على الأرجح- أنّ الصحافة جزء من عمليّة اجتماعيّة أفرزها تفاعل التطوّريْن المادّي والفكري للمجتمع، لتعكس، بدورها، مختلف جوانب ومستويات هذيْن التطوّريْن للمجتمع. فغالبيّة علماء الاجتماع يعرّفون مجتمعاتنا اليوم على أنّها مجتمعات إعلاميّة، بالنظر إلى الوظائف المتعدّدة التي يؤدّيها الإعلام بوسائطه المختلفة؛ فعدا وظيفتها في الإنباء، تؤدي وسائل الإعلام دوراً أساسيّاً في تغيير المعرفة وتبديل المواقف والآراء والاتجاهات والمساهمة في الإثارة الجماعيّة والاستثارة العاطفيّة وتحقيق الضبط الاجتماعي وصياغة الواقع، حتّى وإنْ كان الإعلام نفسه جزءًا من هذا الواقع. يعتمد الإعلاميّون -بطبيعة الحال- في "ممارسة تأثيرهم" وفي كلّ وقت على ظروف الطبقات المختلفة للمجتمع، وعلى حاجاتها وأهدافها؛ خاصّة في هذا العصر حيث فرضت العولمة إشكاليّاتها الكبيرة على وسائل الإعلام والإعلاميّين الذين بات مصطلح "العولمة" ملاذاً لهم (ولغيرهم) يحتمون به عندما يسعون لشرح الظواهر المعقَّدة والمتشابكة (2).
ينشط العِلمان في الحقل ذاته، لكون اللاعب الأساسي في ملعبيْهما واحد: "المجتمع" بلغة علماء الاجتماع، و"الجمهور" بلغة الصحفيّين.
عندما ندرس وسائل الاتصال والإعلام فإننا ندرس -في الحقيقة- واقع الشعوب والمجتمعات؛ وهنا، تبرز الحاجة إلى الاستعانة بعلم الاجتماع الذي لا يكتفي بدراسة جانبٍ أو أكثر من جوانب الإنسان أو المجتمع (مثل سائر العلوم الإنسانيّة)، بل يدرس اﻟﻤﺠتمع ككلّ في ثباته وتغيّره، ويدرس الإنسان من خلال علاقته بالآخرين التي تتحدّد بموجبها سمات هذا اﻟﻤﺠتمع أو ذاك. فهذا العلم (الذي يشتغل في أكثر من ثلاثين مجالاً) يساعد على إقامة تصوّراتٍ حول اﻟﻤﺠتمع، ماضياً وحاضراً وتوجّهاً نحو مستقبلٍ مقصود ومرغوبٍ فيه. وعليه، فإنّه يتناول جميع نماذج العمليّات التي تحدث في المجتمع، كالتعاون والتنافس والصراع والتوافق والتثقيف والتنشئة والتنمية وإدارة الأزمات وغيرها. وكلّها عمليّات يؤدي فيها الفعل الاتصالي، بشتّى عناصره ووسائله، دوراً محوريّاً في "مرحلةٍ ما".
إذاً، يبدو بديهيّاً الارتباط العضوي بين عالميْ علوم الاتصال والإعلام والعلوم الاجتماعية التي تقدّم إضافة جوهريّة ونوعيّة لا تُعطى، في غالب الأحيان، حقّها. وهناك خمسة معطيات تُبرِز هذا الارتباط العضوي بين العلميْن، هي:
1. معظم النظريّات الإعلاميّة ظهرت في كنف العلوم الاجتماعيّة التي كانت من أوائل المنظّرين لطبيعة الوسائط الإعلاميّة منذ ظهورها.
2. تقوم أُسس البحث العلمي الإعلامي (كلّها تقريباً) على نفس المبادئ والمعايير التي يعتمدها البحث العلمي الاجتماعي.
3. يحتاج الصحفيّون إلى "عُدّة" هذه العلوم المفاهيميّة، للقيام بكافّة الوظائف الإعلاميّة (بما فيها الوظيفة الإخباريّة).
4. يعتمد الصحفيّون في إعداد غالبيّة موادّهم على أدوات العلوم الاجتماعيّة (الاستمارة، الملاحظة، المقابلة، زاوية المعالجة أو المقاربة، تحليل المضمون، دراسة الحالة...إلخ)، ولا سيّما الصحفيّون الاستقصائيّون.
5. ينشط العِلمان في الحقل ذاته، لكون اللاعب الأساسي في ملعبيْهما واحد: "المجتمع" بلغة علماء الاجتماع، و"الجمهور" بلغة الصحفيّين (3).
بين الصحفيّين وعلماء الاجتماع.. سوء فهم مستدام
اهتمّ علماء الاجتماع بدراسة وظائف الإعلام ومؤثّراته (أمثال تارد وميرتون ولاسويل ولازرسفيلد وتومسون وتوكفيل ووايت وبورديو وهابرماس وبودريار وپاي ووييڤيوركا)؛ وذلك بدافع اقتناعهم بأنّ العمليّات الإعلاميّة هي أحد أهمّ محرّكات الظواهر الاجتماعيّة، وبأنّ فهم هذه العمليّات إنّما هو ضروري لفهم آليّات الاشتغال في المجتمع. وإذا كان العلماء قد أجمعوا على التغيّرات العميقة التي أحدثتها (وتُحدِثها) وسائل الإعلام في طبيعة حياتنا، لكنّهم ارتابوا – غالبيتهم - من الأدوار التي يمكن أن تؤديها وسائل الإعلام؛ وبلغت ريبتهم هذه، حدَّ اتهام الإعلام (خاصّة التلفزيون) بإنتاج "منتجاتٍ" سهلة ومنمَّطة من شأنها أن تستلب عقول المتلقّين وتقوّض قدرتهم على التفكير النقدي. بالتأكيد، يشعر الصحفيّون والباحثون بتقاربٍ كبير لدى ممارسة أنشطتهم، بحيث يبدو التوازي واضحاً بين أساليب عملهم؛ ومع ذلك، فإنّ هذا التقارب لا يمنع وجود غموضٍ وأخطاءٍ في التقييم، لاسيما فيما يتّصل بالطريقة التي ينظر بها الباحثون في العلوم الاجتماعيّة إلى العمل الصحفي. وبحسب ما بيّنت الدراسات (القليلة) التي بحثت في شكل وحجم ونوع الارتباط الذي يحكم تلك العلاقة، فإنّ هناك، على الأقلّ، ثلاث نقاط حاسمة تتحدّد بموجبها الفروق الجوهريّة بين النهجيْن: العلاقة بالزمن، العلاقة بالأدوات وطريقة استخدامها، العلاقة بالجمهور (4).
غالبيّة المقرّرات التي تُدرَّس تركز كثيراً على التأطير النظري والنواحي التقنيّة، ما يجعلها متقاربة، إلى حدٍ بعيد، مع ما تقدّمه مراكز التدريب الصحفي.
يرتبط تطوّر العلاقات، بين الصحفيّين وعلماء الاجتماع، ارتباطاً وثيقاً بتكثيف الصراعات الرمزيّة في الأنشطة الإنسانيّة، ويمكن، في الوقت عينه، قراءة تاريخ العلاقات بين الطرفيْن كنتيجة لـ"مسار التحضّر" الذي تحدّث عنه عالم الاجتماع الألماني نوربرت إلياس، وكدليلٍ على احتدام النضالات ليس بالسلاح بل بالكلمات، على حدّ تعبيره. ولئن كانت العلاقات بين الطرفيْن كثيفة ومتواترة، لكنّ ذلك لم يمنع من أن يشوبها نوعٌ من الازدواج الناتج عن تواجُه حِرْفَتَيْ كتابةٍ تلتقيان من حيث مراكز الاهتمام؛ لكنّهما تتعارضان من حيث زمنيّتهُما وتتمظهران كشكلٍ من أشكال الصراع القائم بين مختلف الأنشطة التي تدّعي "كتابة الاجتماعي" (5). وعندما تصبح أدوات تكنولوجيا الإعلام والاتصال مادةً للعلوم الاجتماعيّة والإنسانيّة تشتغل عليها وفق مناهجها وتستأنس بها لتطوير هذه المناهج وإنتاج جدليّة التأثير والتأثّر والفاعل والمنفعل، ينفتح المجال واسعاً أمام التفكير والتعمّق في فهم تفاعلات هذه الجدليّة ومدى توظيفها في الحقل الأكاديمي لكليّات الإعلام والصحافة.
كيف يحضر علم الاجتماع في مناهج الصحافة العربيّة؟
في ظلّ التحوّلات الاجتماعيّة العميقة التي شهدها العالم العربي (ولا يزال)، وما تكشّف من تشوّهاتٍ في المجال الإعلامي مع انتقال المنظومة الاتصاليّة إلى الزمن الرقمي؛ أحال العديد من أصحاب الاختصاص جزءًا من أزمة الصحافة وضعف الأداء المهني والأخلاقي لمعظم الصحفيّين وفشل النموذج الاقتصادي لوسائل الإعلام، إلى نُظم التعليم في كليّات الصحافة وطُرق تكوينها للطلاّب. ركّزت أوراق بحثيّة أُعِدَّت في هذا الصدد (لا ترتقي بغالبيّتها إلى مستوى الدراسات) على بقاء معظم هذه المؤسّسات التعليميّة تدور في حلقة مفرغة لخططٍ دراسيّة تقليديّة عاجزة عن تطوير نُظمٍ للجودة الأكاديميّة وللتميّز والمنافسة لدى الخرّيجين. ومن المهمّ الإشارة، إلى أنّ ملاحظات الباحثين وآراءهم ومواقفهم، إنّما تسلّط الضوء على جانبٍ واحد يكمن في إثبات فكرةٍ (مهمّة للغاية بالطبع) مفادها، أنّ كليّات ومعاهد الإعلام والصحافة العربيّة، التي يُناط بها تدريس وتخريج الإعلاميّين والصحفيّين، لا تواكب (برأيهم) التغيّرات الحاصلة في المهنة ولا تستجيب مناهجها للتطوّرات التكنولوجيّة المتعاظمة والمتسارعة في الزمن الرقمي (6).
ما حاولنا فعله، من ناحيتنا، لا يصبّ في هذا الإطار مطلقاً، بل إنّنا قاربنا مضامين تلك المناهج من زاوية مختلفة، بحيث سعينا إلى معرفة الحيّز الذي تمنحه المقرّرات الدراسيّة الإعلاميّة للعلوم الاجتماعيّة. بمعنى أدقّ، لقد تقصّينا في عيّنةٍ جمعناها، من جامعات تسع دول عربيّة فيها كليّات للصحافة، بغية التعرّف على مدى تطبيقها لمنهجٍ "متعدّد التخصّصات" في العلم الذي من المفترض أنّها تدرّسه والمرتبط عضويّاً بعلم الاجتماع (ونعني "علوم الإعلام والاتصال"). انطلقنا من قناعةٍ تقول، بقدرة علم الاجتماع على تقديم مساهماتٍ غير قليلة وفعّالة لتطوير اختصاص "علوم الإعلام والاتصال"، وتزويد طلاّبه (أي صحفيّي الغد) بمقارباتٍ ومنهجيّاتٍ وأساليب يمكنهم توظيفها في ممارستهم المهنيّة، بعدما أصبحنا في زمنٍ تخطّت فيه "الرسالة الإعلاميّة" كلّ الحواجز. يمكن لموادّ علم الاجتماع مساعدة طلاّب الصحافة على تعزيز مهاراتهم في كشف الواقع الاجتماعي الذي يقف وراء شؤون الحياة العاديّة ويؤثّر في تشكّل الأحداث التي يغطّونها وتفاعلها؛ تلك الأحداث التي تُعتبَر نقطة الانطلاق لأيّ كتابةٍ إعلاميّة (الأخبار، التقارير، التحقيقات، الوثائقيّات،..إلخ). إذْ تُعتبَر المعرفة العميقة بالمؤسّسات الاجتماعيّة (الأسرة، التعليم، الدين، الصحّة)، والفوارق الاجتماعيّة (السنّ، الطبقة، النوع الاجتماعي، الحياة الجنسيّة)، والموضوعات المتعلّقة بالتفاعلات الاجتماعيّة (العمل، الصداقة، الحبّ، الزواج) من العناصر التي لا تُعَدّ ولا تُحصى في علم الاجتماع.
غالبيّة المقرّرات التي تُدرَّس، كما استنتجنا، تركِّز كثيراً على التأطير النظري والنواحي التقنيّة والتطبيقيّة، ما يجعلها متقاربة، إلى حدٍّ بعيد، مع ما تقدّمه مراكز التدريب الصحفي (الواقعي منه والافتراضي)، بينما يتبدّى، بالمقابل، نقصٌ واضح في تدريس كلّ ما من شأنه أن يزوّد الطالب بمعارف في المجالات المتداخلة بقوّة مع اختصاصه. ما يلفت في عيّنة المقرّرات التي اطّلعنا عليها، هو التشابه الكبير في طبيعتها ومحتواها وإنْ اختلفت التسميات، أحياناً، بين جامعةٍ وأخرى أو بين مسارٍ أكاديمي وآخر. تحفل المقرّرات المختارة بموادّ تهدف (كما يقول توصيفها) إلى تأطير الطلاّب نظريّاً، وتزويدهم بمعارف عامّة تقف، بمعظمها، على عتبة التعريفات وسرد المبادئ والقواعد والمعايير. ونقع هنا، مثلاً، على عشرات المقرّرات التي "تلقِّن" الطلاّب أُسس مهنة الصحافة وتاريخها ونظريّاتها وقوانينها وأخلاقيّاتها واللغات وكيفية تنظيم وسائل الإعلام والتعرّف على وظائفها وتأثيراتها (المفترضة) في الجمهور وعلاقتها بالمجتمع الذي تنشط فيه.
أمّا الشقّ التطبيقي والتقني، إذا جاز القول، فتركّز مقرّراته على تعليم الطلاّب كلّ ما له علاقة بممارسة مهنة الصحافة (بكافّة فروعها التقليديّة والمستحدَثة). وتتوزّع الموادّ، في هذا الإطار، بين موادّ "ترشد" الطلاّب إلى الطُرق التي يجمعون فيها المعلومات والأخبار، وأخرى تعلّمهم على الكتابة الصحفيّة، بنوعيْها المكتبي والميداني، وكيفيّة استخدامها في كافّة الأعمال الإعلاميّة. وهناك تفاوت في عدد المقرّرات التي تخصّصها بعض الجامعات لمهارات الإنتاج الصحفي والمهارات الفنيّة (التصوير، المونتاج، الإخراج، استخدام الإضاءة والموسيقى والغرافيكس...)، ويبدو أنّ السبب في ذلك يعود إلى مدى توفّر المرافق والبنى التحتيّة الملائمة في الجامعات (المختبرات والأستوديوهات والوسائط الرقميّة..).
ما تدرِّسه كليّات الصحافة العربيّة، قد يكون جيّداً وكافياً لتخريج "صحفيّين" سرعان ما يتحوّلون إلى حاملي ميكروفونات يهرولون وراء السياسيّين والخبراء؛ ويُخفون كسلهم وعجزهم عن مساعدة الناس في فهم الأحداث.
ما تدرِّسه كليّات الصحافة العربيّة، في أيّامنا هذه، قد يكون جيّداً وكافياً لتخريج "صحفيّين" سرعان ما يتحوّلون إلى حاملي ميكروفونات يهرولون وراء السياسيّين والخبراء والمختصّين؛ ويُخفون كسلهم وعجزهم عن مساعدة الناس في فهم ما حصل ويحصل أمامهم من أحداث، في مجتمعاتٍ باتت تضجّ بأفكار وموضوعات ومفاهيم وظواهر لم يعهدوها من قبل. وفي هكذا مجتمعات، لن يجد الصحفيّون أفضل من الركون إلى مقارباتٍ أوسع، تتوفّر في العلوم الإنسانية وفي مقدّمتها علم الاجتماع، لفهم الكثير من الأحداث والقضايا والظواهر الاتصاليّة والإعلاميّة، ولمعرفة كيفيّة التعاطي معها ومع الجمهور المرتبط بها.
المراجع:
1- طارق الخليفي، "سياسات الإعلام والمجتمع"، بيروت، دار النهضة العربيّة، 2010.
2- Francis Balle, "Médias et Sociétés", 4e édition, Paris, Montchrestien, 1988 &
نصر الدين لعياضي، "وسائل الإعلام والمجتمع"، العين- الإمارات العربيّة المتحدة، دار الكتاب الجامعي، 2004.
3- سيرج بوغام، "ممارسة علم الاجتماع"، ترجمة: منير السعيداني، بيروت، المنظّمة العربيّة للترجمة، 2012.
4- Gilles Bastin, "Le journalisme et les sciences sociales: Trouble ou problème?", Revue "Sur le journalisme", (Vol 5), 2016 & Jean-Marie Charon, "Journalisme et sciences sociales : Proximités et malentendus", Revue "Sciences sociales du politique", 1996 & Cécile Van de Velde (animateur de), Débat entre Cyril Lemieux, Laurent Mucchielli, Érik Neveu sur "Le sociologue dans le champ médiatique : diffuser et déformer?", Revue Sociologie, (Vol. 1), 2010.
5- Judith Lazar, "Sociologie de la communication de masse", Paris, Armand Colin, 1997 & Julie Sedel, "Sociologie des dirigeants de presse", Paris, La Découverte, 2022.
6- عمل جماعي، "الإعلام الجديد وعمليّة التغيير الاجتماعي والسياسي في العالم العربي"، بيروت، المركز اللبناني للدراسات، 2006.