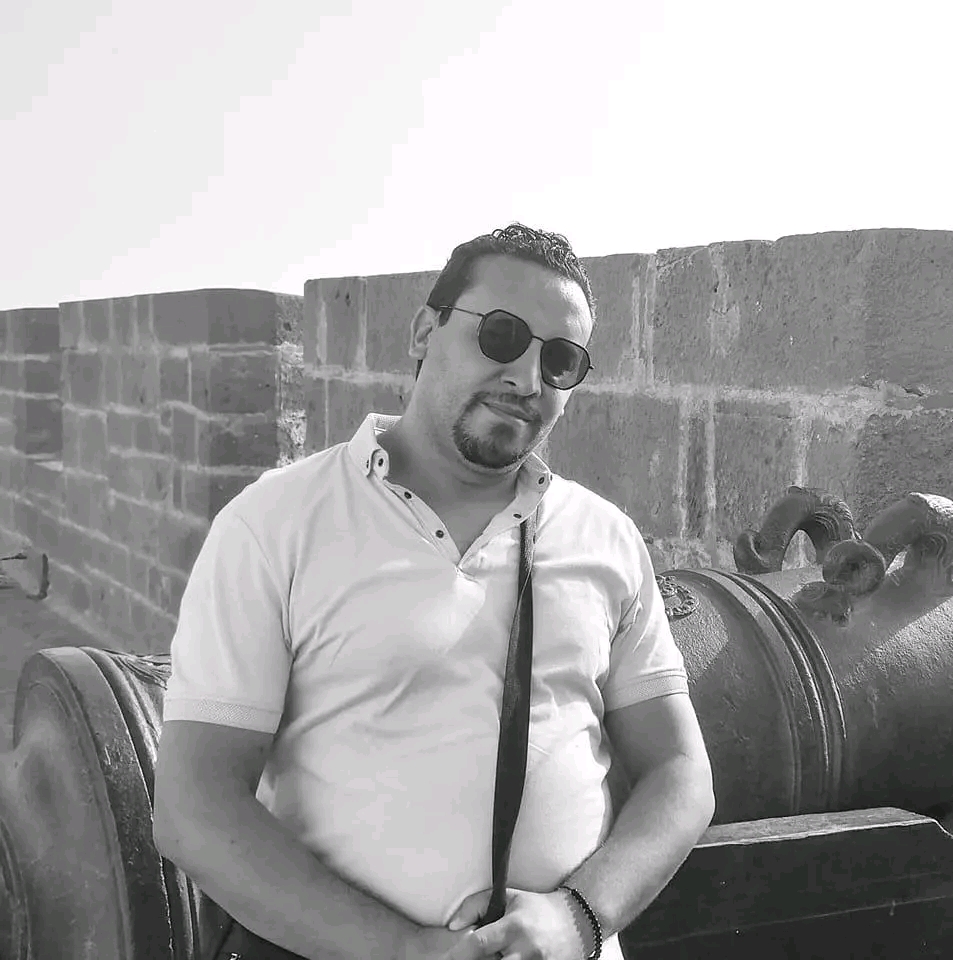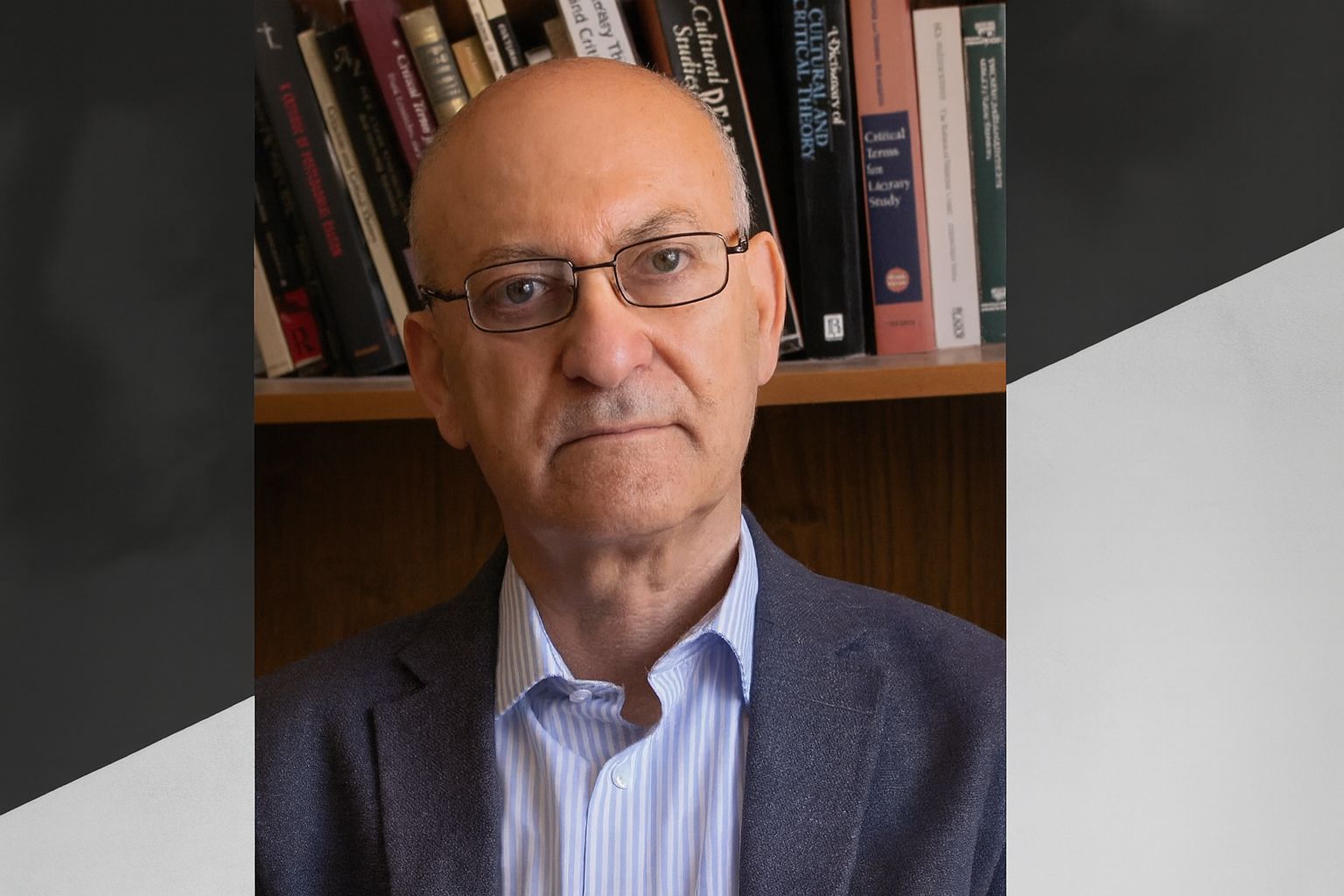في سياق عربيّ بات في أشدّ حالاته هزيمةً وتراجعًا منذ نشوء الكيانات السياسيّة ما بعد-الاستعماريّة في نهاية الحرب العالميّة الأولى، يستدعي الحديث عن الصحافة الثقافية، ودورها في المقاومة ومواجهة النسيان والانهزام، التساؤل عن وجودها وتأثيرها، والسياقات التي يتمّ فيها استيعاب وتحويل ثمّ إنهاء دورها في إذكاء شعلة النقاش والتفكير والنقد وتحريك الرّاكد، والتأمّل في إمكانيّات وأساليب التّغيير والنّهوض.
ثمّ سيستدعي هذا الحديث نقاشًا حول وجود "مشهد ثقافيّ" أصلًا، ووجود فاعلِين ثقافيّين قادرين على تقديم مساهماتهم بحُريّة، وتحويل هذه المساهمات إلى ممارسات ثقافيّة-سياسيّة داخل الفضاء العام، تليها القدرة على أن تأخذ هذه الممارسات شكلًا ماديًّا-حركيًّا تقود إلى نواتج ومحصّلات.
يُجمع المعلّقون - منذ وقت طويل - على أن الصحافة الثقافيّة تمرّ بأزمة شديدة تتراوح بين الإهمال،(1) والمستقبل الغائم،(2) وصولًا إلى المحنة،(3) فالاحتضار،(4) فالموت،(5) الأمر الذي يدفع إلى التساؤل عن جدواها وإمكانية إنقاذها.(6) بل إن هذه الأزمة وصلت إلى حدّ الحديث عن ضرورة وضع وضبط تعريفٍ ما للصحفيّ الثقافي(7) بعد تاريخ للصحافة الثقافيّة العربية يقترب من - أو يزيد عن - مئة عام.
لكنّي أرى أن أزمة الصحافة الثقافيّة تعبير عن أزمة أوسع وأشمل، وناتجة بالتحديد - مثلما هي بقيّة الأزمات في فضائنا العربيّ - عن أزمة الكيانات السياسيّة ما بعد الاستعماريّة، وفشلها المدوّي في إحداث التنمية والاستقلال النّاجز والخروج من دائرة التبعيّة والهيمنة عبر التقسيمات الاستعماريّة التي أنتجتها في أكثر من مئة عام بقليل.(8)
عن التعريف
عند الحديث عن "المشهد الثقافيّ"، فإني أقصد به ذلك الفضاء الذي يعمد الفاعلون فيه إلى نقاش واسع ومفصّل ومتفاعل للواقع الاجتماعيّ والاقتصادي والثقافي والسياسي إلى جانب المنتجات الفكريّة والإبداعيّة التي يقدّمونها؛ بغرض رفد المجتمع بالأفكار والتصوّرات والإبداعات، مثلما يرفد بعضهم بعضاً بالرؤى والإمكانات، محاولين تطوير التجارب في سياق نقاش جماعيّ مادّته نتاجات أعضاء المشهد وتصوّراتهم المعبّر عنها فكرًا، أو أدبًا أو مسرحًا أو تشكيلًا أو سينما، وغيرها من أدوات تقديم الأفكار.
يتطلّب مثل هذا التفاعل والحوار مساحات عامّة حرّة غير خاضعة لرقابة السّلطة وتدخّلها. قد تأخذ هذه المساحات العامة أشكالًا مكانيّة: كالمقاهي والمعارض والمنتديات والجمعيّات والساحات العامة، أو أنّها قد تأخذ أشكالًا تداوليّة، مطبوعة أو مرئيّة أو مسموعة، كالصّحف والمجلّات والبرامج الثقافيّة التلفزيونيّة والإذاعيّة والمواقع الإلكترونية.
أزمة الصحافة الثقافيّة تعبير عن أزمة أوسع وأشمل، وناتجة بالتحديد عن أزمة الكيانات السياسيّة ما بعد الاستعماريّة، وفشلها المدوّي في إحداث التنمية والاستقلال النّاجز والخروج من دائرة التبعيّة والهيمنة عبر التقسيمات الاستعماريّة التي أنتجتها في أكثر من مئة عام بقليل.
الأشكال التداوليّة لم يبق منها شيء جادّ يذكر. فالمجلات الأدبية والفكريّة المطبوعة أغلقت في المعظم أبوابها، وتحوّل بعضها إلى صيغ إلكترونية ضائعة في خضم "الثرثرة الرقمية الطافحة"، أما الملاحق والصفحات الثقافيّة للصحف فمات أغلبها، وما بقي منه تقلّص في الحجم وانحدر في النوع، وصار الباقي منها منصّات لترويج الأدب والفنّ المعقّمين، اللذين تُنتجهما عمومًا الجوائز التي تقف خلفها وتموّلها السّلطات نفسها التي تضرب المغاير والمخالف والناقد بيدٍ من حديد، ليُختزل "المشهد الأدبيّ" في قوائمها القصيرة وفائزيها، وهو مشهد موسميّ مؤقت، إذ ستحلّ محلّه في الموسم القادم "سلع" أدبيّة جديدة فائزة تمحو ما قبلها الذي يصير "خبرًا قديمًا": مادة متقادمة منتهية الصلاحية، وينطبق الحال نفسه على البرامج الثقافيّة في المحطات التلفزيّونية أو الإذاعيّة.
أما المساحات المكانيّة فوضعها أعوص، إذ تحوّلت إلى أدوات تسوّل واحتواء؛ تتسوّل الدعم والمكانة والاعتراف من السّلطة التي تحتويها وأعضاءها بالفُتات الذي لا يمكن له أن يصنع حركة ثقافيّة غنيّة ومبدعة ومستقلّة، فيصبح الشّغل الشاغل لهذه الأطر أن تستنبط قيمة ما لنفسها لعلّ السلطة تنتبه إليها و"تستعملها"، مثلًا "في مواجهة التطرّف" و"الإرهاب"،(9) أو "من أجل بناء هويّة وطنيّة" و"ترسيخ مفهوم الدولة، وحراسة قيمها، والدفاع عن ثوابتها، وضرورة مشاركة المثقف الفاعلة في تحقيق غاياتها"،(10) والسّلطة لا تأبه لا لهذا ولا لذاك من هذه الجوانب، إذ أن هدفها الرئيسيّ والمركزيّ هو البقاء مُستخدمة في سبيل ذلك كلّ العناصر المتناقضة والمتعارضة، مُوظّفة - في كثير من الأحيان - بعض هذه العناصر في مواجهة بعض، ومنقلبة، حين تحين اللحظة المناسبة، على "الأدوات" التي وظّفتها.
والحال هكذا؛ يكون الفاعلون الثقافيّون "مثقّفين"، بالتعريف الاصطلاحيّ الذي قدّمته في دراستي: "الحداثة المُتخيّلة والرّهان على السلطة: المثقّف كظاهرة (ما بعد) استعماريّة، والمفكّر الممارس كإمكانيّة تحرريّة"،(11) وملخّصها أن مصطلح "المثقف" فريد وخاص في السياق العربي، ولا يعادل كلمة "intellectual" الإنجليزية أو "intellectuel" الفرنسيّة؛ إذ أنه نشأ ضمن مسار آخر مختلف، وفي سياق الانبهار بالمنجز الاستعماري، بالتجاور مع نزعة للّحاق به والاستقلال عنه، وبالتزامن مع ظاهرة تقوم على "عبادة الحداثة"، لم تعجز عن نقدها فحسب، بل اعتبرت كل ما هو محليّ متخلّفًا بالضرورة. وبهذا يرفّع المثقف نفسه إلى مرتبة دينيّة-فرديّة، عمادها التبشير بالحداثة ومتطلّباتها، والانطلاق للبحث عمّن ينفّذ مشروعه المثاليّ-المتخيّل. ولأنه يعتبر مجتمعه متخلّفًا لا يمكن الرّهان عليه ليكون رافعةً للنهوض، بل هو موضوع التّغيير، لا يبقى لديه من خيارات قادرةٍ على إحداث التغيير المنشود سوى السّلطة ليعرض عليها رؤيته التحديثيّة، متحوّلًا مع الوقت - من خلال آليتيّ التوسّل والتسوّل - إلى جزء من أدوات استدامتها، وإعادة إنتاج تسلّطها ووظيفيّتها.
الملاحق والصفحات الثقافيّة للصحف مات أغلبها، وما بقي منه تقلّص في الحجم وانحدر في النوع، وصار الباقي منها منصّات لترويج الأدب والفنّ المعقّمين، اللذين تُنتجهما عمومًا الجوائز التي تقف خلفها وتموّلها السّلطات نفسها التي تضرب المغاير والمخالف والناقد بيدٍ من حديد.
وإن كان مثقّفو الأمس (ليس على سبيل التعميم) منشغلين بـ"الحداثة" وكيفية الوصول إليها، فإن مثقفي اليوم مشغولون بأحلام النجوميّة، والانتشار والاعتراف والتّكريس. يبحثون عن سبيل للتحوّل إلى مشاهير عبر استجداء الجائزة والسعي إليها من خلال مسارين:
أ- التخفّف من نقد الحاضر بما يمثله من المجموعات الحاكمة وسياساتها، حتى لا تقف حجر عثرة في سبيل الفوز، والتحوّل -في أحسن الأحوال- إلى نقد الماضي الذي لم يعد موجودًا ولا مؤثّرًا.
ب- غزارة الإنتاج، لعل تذكرة اليانصيب الأدبيّة تُصيب هذه المرّة، الأمر الذي يولّد العاديّة والرداءة والثرثرة، لا بل ويعيد تشكيل مشهد الكتابة والإبداع بالمجمل بعد أن صارت في عمومها طامحة للحصول على الجائزة كهدف أساسيّ من أهدافها، على النسق الذي تختطّه الجائزة بخياراتها، مشكّلة معها أيضًا مشهد الصحافة الثقافية، والنقد الأدبيّ، اللذين يتقيّدان بالمحددات نفسها للحصول على المنافع المرافقة.(12)
بتحوّل "المشهد الثقافيّ" وانحساره، يفقد الفعل الثقافيّ أدواته، ويصبح معلّقًا في الهواء، ويصير نوعًا من أنواع التأقلم المكثّف مع الوضع القائم الذي يتراجع باستمرار، في صيغة: "أعمل في حدود المسموح والمتاح"، مع أن هذه الحدود تصغر وتضيق؛ أو نوعًا من أنواع "الصّراخ في البريّة" المحكوم سلفًا باللاجدوى، باعتباره حالة ضميرية من حالات "قول الحقّ في وجه السلطة" كفرض كفاية يُغني عن العمل في مواجهتها؛ أو نوعًا من الخلاص الذاتيّ الانسحابيّ الذي يتلخّص في التخلّي عن هدف التحرّر الشامل أو المساهمة فيه، إلى هدف بسيط هو الحفاظ على الذات والمبادئ من أن تتأثر بالانهيار الشامل، وتصوير ذلك على أنه فعل نضاليّ مقاومٌ سامٍ بحدّ ذاته.
الصّحافة الثقافيّة جزء من هذا الحال، وتعاني أعراض التداعي ذاتها، وتعكس هذا السائد وتكرّره، فهي محصّلةٌ وليست نتيجة، وإن ادّعى البعض - من موقع "رومانسيّ" مثاليّ متفائلٍ - غير ذلك. الصّحافة تُصنع ابتداءً قبل أن تَصنع، يصنعها مالكوها ومموّلوها والسلطات التي تُخضِعها لقواعدها وتُسيّرها في ظلّها، وما نماذج تزييف أو تعمية التغطية وازدواجيّة المعايير المتعلقة بإبادة غزّة سوى الدليل الفاقع على هذه البديهة البسيطة التي لطالما تخفّت خلف مقولات مثالية نموذجيّة لا موقع لها من الإعراب في أرض الواقع، مثل "الحياد" و"التوازن" و"الموضوعيّة".
أين كل ذلك من أدوار سابقة أدتها الصّحافة الثقافيّة في مراحل تاريخيّة أخرى؟
لا بدّ ابتداءً - وقبل أن نناقش هذا السؤال - من تثبيت قاعدتين مركزيّتين: تفيد الأولى بأن الثقافة والصحافة والصحافة الثقافية جميعها سياقيّة؛ أي أنّها تتأثر وتتفاعل وتنبثق وتعبّر عن السياق الذي توجد فيه؛ وتفيد الثانية بأن الثقافة والصحافة والسياسة لصيقة تلاصقًا تامًّا، وإن ادّعت الثقافة والصحافة رفعتهما وحياديّتهما، فالترفّع عن السياسيّ وادّعاء الحياد أو "عدم الاشتباك المباشر" هو بحد ذاته انحياز سياسيّ لصالح الطرف المُسيطر والوضع القائم من باب السّكوت عنه، وإتاحة المجال أمامه للتمدّد والرّسوخ، وتوجيه النظر الخاصّ والعامّ إلى مكان آخر. لذا: ليس ثمة شيء اسمه "الثقافة اللاسياسيّة"، أو "الإبداع الذي لا علاقة له بالسياسة"، أو ما عُبِّر عنه في فترات سابقة بعبارة "الفنّ للفنّ"، فترفّع الفنّان عن بحث الطاغية وكشفه هو تواطؤ معه واستدامةٌ لقمعه. وعلى نفس المنوال، لا يوجد شيء اسمه الحياد الصحفيّ، فإتاحة المجال لرواية القاتل على قدم المساواة مع - أو غالبًا: بوقع أقوى من - رواية القتيل تعني انحيازًا للأول في أسوأ الأحوال، وتبريرًا له وتخفيفًا لجرائمه في أحسنها.
ما بين غسّان وناجي تقع مقدّمات التداعي الشامل الذي أودى بحياة الثاني بيدٍ ربما كانت غير تلك التي أودت بحياة الأول، فيما يمثل كلاهما هذا اللاانفصال بين الصحفي والسياسي، وبين الفكر والممارسة، وبين الفكر المواجه للاستعمار الاستيطاني الصهيوني ومواجهة الاستعمار الاستيطاني وأدواته.
لذا من غير المستغرب أن تعبّر الصحافة الثقافية في مراحل صعودها خلال فترة ما سمّي بـ"التحرّر الوطنيّ" أو "التحرّر من الاستعمار" عن مزاج عامّ تحرّري، وإن كان مضبوطًا - كما في مصر عبد الناصر مثلًا - بإيقاع المُتسلّط الحاكم وحدوده، وحدود رؤيته للمساحة السياسيّة المتاحة، وحدود المناوشة الممكنة أو المُتحمّلة للفاعلين فيها، فما مثّله شخص مثل غسّان كنفاني (1936 – 1972) هو وليد سياق اللحظة التاريخية التي وجد فيها وكان فاعلًا فيها، وهي لحظة أتاحت حدودًا وشكّلت تحولّاتٍ يمثّلها أيضًا صحفيّ آخر نشط في مبحثٍ آخر من مباحث الصّحافة، هو ناجي العلي (1936 – 1987). لكن، ما بين غسّان وناجي تقع مقدّمات التداعي الشامل الذي أودى بحياة الثاني بيدٍ ربما كانت غير تلك التي أودت بحياة الأول،(13) فيما يمثل كلاهما هذا اللاانفصال بين الصحفي والسياسي، وبين الفكر والممارسة، وبين الفكر المواجه للاستعمار الاستيطاني الصهيوني ومواجهة الاستعمار الاستيطاني وأدواته؛ هذا اللانفصال الذي تفكّكت عراه تمامًا اليوم في الحقول الثقافيّة، والفكريّة، والصحفيّة أيضًا.
ولهذا السّبب نفسه، ليس من المستغرب أن نعاين اليوم خفوتًا كبيرًا في دور الصحافة الثقافية، فالعصر هو عصر التسليع والترفيه والتسطيح و"التفاهة"، عصر الأنانيّة والركض خلف الرّائج والدّارج، مثلما هو عصر التّفتيت والتّفكيك وترسيخ التبعيّة والإلحاق، عصر التّطبيع الإبراهيمي مع الاستعمار الاستيطاني الصهيوني، والاستثمار فيه باعتباره مركز القوّة الكاسحة في المنطقة، عصر إخضاع الصحف والثقافة والكاتب والكتابة، واحتوائها جميعًا في خطّ السكوت عن النقد، والالتحاق التابع من باب الإغواء بالمال والمكانة والشهرة.
فوق ذلك كلّه، تبرز تحدّيات أخرى كبيرة تخصّ الصّحافة في عمومها والصحافة الثقافيّة على وجه الخصوص، إذ يتراجع الاهتمام العام والصحفيّ بالمادة الثقافيّة أمام فروع الصّحافة الأخرى السياسيّة والاقتصاديّة والرياضيّة، وينتشر الابتسار والسرعة المرافقين للمادة الإعلاميّة في طورها "السوشال-ميدياويّ" ( نسبة إلى وسائل التواصل الاجتماعي) والمعتمدة على الأخبار القصيرة والخفيفة والصورة والفيديو، مقابل العمق والإسهاب والجديّة المطلوبة في مواد ومراجعات الصحافة الثقافية، إضافة إلى الضّحالة والاستسهال اللذين باتا يميّزان المشتغلين في الشأن الثقافي، سواءً من جهة الإنتاج الإبداعي-الثقافي نفسه، أو من جهة من يفترض فيهم تغطيته والكتابة عنه وفيه، ومعها أيضًا فقدان "المركزيّة" التي كانت في جانبٍ منها تخدم التحكّم والسيطرة وسلطة الاعتراف والتّكريس، لكنّها - في جانب آخر - كانت تخدم تركيز الاجتماع والحوار والتعرّف في مكان عموميّ متاح للمهتمّين والجمهور كوجهة.
يروى عن الكاتب والصحفي فتحي غانم بعد حادثة عزل الرئيس المصري الأسبق أنور السادات له عن موقعه في رئاسة تحرير مجلة روز اليوسف، لانزعاجه مما تنشره المجلة، يقول غانم إن السادات وصف المجلّة بعد تخليصها منه ومن المنغّصات النقديّة بأنها "بقت ممتازة خالص، ما فيش فيها حاجة تتقري"
في عام 1988، كتب أمجد ناصر مقالة عنوانها: "الصحافة الثقافيّة شلليّة وامتثال"،(14) تحدّث فيها عن "التشابه المريب في المادة "الثقافية"، وفي صنع نجوم نافسوا الممثّلين والمطربين على العناوين والصور والأخبار، وفي خلط الحابل بالنابل والغثّ بالثمين،" مثلما تحدّث عن الفرق بين الصحافة الثقافية العربيّة في خمسينيات وستينيات القرن العشرين التي قدمت "أبرز الأسماء والظواهر في الثقافة العربية" كقصيدة التفعيلة وقصيدة النثر، والانعطافات الجديدة في القصة القصيرة، وبين الصحافة الثقافية في سبعينيات وثمانيّات القرن نفسه التي قطعت الطريق على "المغامرة الفنيّة"، وعزّزت "الاتجاهات السلفيّة"، وتحدث فيه أيضًا عن "الشلل الثقافية" التي تتبادل المنافع وتمدح كتابات بعضها البعض، وتفتح النار على الآخرين، وهي السياقات نفسها التي يتحدّث عنها شريف الشافعي(15) في شرحه الوصف المكثّف والمختزل والمعروف في المشهد الثقافي المصريّ: "الحظيرة"، وهو التعبير الناشئ في "عهد وزارة فاروق حسني، ولا يزال منسحبًا على اللحظة الحاليّة" باعتباره دالًّا على أولئك المنخرطين في "منظومة التوجيه السلطويّ، أو دائرة الاستقطاب والتدجين، أو شلل المصالح الضيقة والانتفاعات المتبادلة"، والحظيرة بهذا المعنى تضمّ في ثناياها الصّحافة الثقافية باعتبارها معملًا للترويج والتسويق اللذين يعتبرهما روجيه عوطة قتلًا لتلك الصحافة التي تنحدر إلى مستوى الإعلان، حيث "الجميع يتقاسم مع الجميع الحلم الهابط نفسه، حلم الرّواج".(16)
يروي شريف صالح طرفة عن الكاتب والصحفي فتحي غانم تتعلّق بحادثة عزل الرئيس المصري الأسبق أنور السادات لهذا الأخير عن موقعه في رئاسة تحرير مجلة روز اليوسف، لانزعاجه مما تنشره المجلة، إذ يقول غانم إن السادات وصف المجلّة بعد تخليصها منه ومن المنغّصات النقديّة بأنها "بقت ممتازة خالص، ما فيش فيها حاجة تتقري".(17)
إذًا، الأزمة ليست جديدة، بل متفاقمة في ظل استمرار الانحدار العام السياسيّ-الاقتصاديّ-السياديّ، ولعلّ أكبر تعبير عن الأزمة يقع من خلال فاعلي الصحافة الثقافية أنفسهم، فها هو فخري صالح رئيس القسم الثقافي الأسبق في صحيفة الدستور الأردنيّة ومدير تحرير الدائرة الثقافية الأسبق فيها، يكتب مقالًا في الصحيفة نفسها، يشكو فيه من غياب الحوار في الصحافة الثقافية وافتقاد "حكّ الأفكار بالأفكار، ما أفضى إلى نوع من الكسل الثقافي والفكري"،(18) في حين حارت مواقع وملاحق ثقافيّة جادة في إيجاد دور لها خلال المجزرة الصهيونية الأخيرة والمتواصلة على غزة وفي عموم فلسطين، إذ يتساءل سليم البيك محرّر موقع رمّان الثقافي عن دور وجدوى الصحافة الثقافيّة في زمن الإبادة،(19) وهو وإن حوّل الموقع بالكامل ليصبح نوعًا من جبهة إسناد ثقافية لغزّة - وهو ما فعله أيضًا نجوان درويش المحرر السابق للقسم الثقافي في صحيفة العربي الجديد - إلا أن هذه الاستثناءات تؤكد القاعدة، وتعيد طرح التساؤل المستمر المتعلّق بالتفكير في الدور المطلوب؛ لغياب هذا الدور بالتحديد.
المراجع:
-
محمود، عبدالرحمن. "واقع الصحافة الثقافية العربية وسبل تعزيزها." شبكة الصحفيين الدوليين. 25 أغسطس2023. https://shorturl.at/pE2bd.
-
حماد، خالد. "مستقبل الصحافة الثقافية من واقع مأزوم إلى مستقبل غائم." الدستور. 8 سبتمبر 2021. https://www.dostor.org/3564778.
-
الخصار، عبد الرحيم. "محنة الصحافة الثقافية في المغرب." الميادين نت. 7 يوليو2021. https://www.almayadeen.net/investigation/1489921.
-
مفرح، سعدية. "الصحافة الثقافية العربية تحتضر." العربي الجديد. 2 فبراير 2023. https://shorturl.at/5wMwm.
-
الفيتوري، أحمد. "موت الصحافة الثقافية! (1-2)." الوسط. 4 فبراير 2020. https://alwasat.ly/news/opinions/272256.
-
السيد، هيثم. "هل يمكن إنقاذ الصحافة الثقافية؟." مكة. 22 سبتمبر 2018. https://makkahnewspaper.com/article/1086307.
-
الإذاعة الوطنية التونسية. "السلطة الرابعة مع نبيلة عبيد: الصحافة الثقافية بين الموجود والمنشود – الصحفية شادية خذير." 9 أغسطس 2024. فيديو فيسبوك. https://www.facebook.com/radionationaleTun/videos/1725934194609774. إذاعة السيدة. "قراءة في واقع الصحافة الثقافية، تحدياتها وأهدافها، مع الصحفية أماني بولعراس." 23 يناير 2025. فيديو فيسبوك. https://www.facebook.com/EssaidaFm/videos/455496987639029.
-
البستاني، هشام. الكيانات الوظيفيّة: حدود الممارسة السياسيّة في المنطقة العربية ما بعد الاستعمار. بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 2021.
-
من هذه الجهود مثلًا المؤتمر الأخير للجمعية الفلسفية الأردنية الذي انعقد بدعم من وزارة الثقافة ومهرجان جرش بعنوان "التفكير والفلسفة في مواجهة التكفير". انظر: وكالة الأنباء الأردنية (بترا). "افتتاح المؤتمر الفلسفي العربي الـ13 ضمن فعاليات مهرجان جرش." 24 يوليو 2025. https://petra.gov.jo/Include/InnerPage.jsp?ID=7765&lang=ar&name=culture_news. وأيضًا، ضمن المنطق نفسه: انظروا ملاحظة عبد الكريم المقداد وهو يتساءل عن دور الحكومات في تهميش المثقفين رغم أن هؤلاء يستخدمونها في محاربة التطرّف واجتثاثه، والواردة في: موسى، عماد الدين. "الصحافة الثقافيّة.. بين مطرقة السلطة وسندان التمويل؟ (1)." ضفة ثالثة. 6 سبتمبر 2019. https://shorturl.at/m1XB1.
-
المشروع الثقافي الوطني الأردني: خطوة نحو ثقافة وطنية إيجابية." الدستور. 7 يونيو2022. https://www.addustour.com/articles/1285386.
-
البستاني هشام. "الحداثة المُتخيّلة والرّهان على السلطة: المثقّف كظاهرة (ما بعد) استعماريّة، والمفكّر الممارس كإمكانيّة تحرريّة." المستقبل العربي 548، عدد 47 (أكتوبر 2024): 61–79.
-
المادّتان الناقدتان المذكورتان هما: ذويب، عبد القادر. "حرب الكلب الثانية: رواية خيال علمي تفتقر للخيال." ألترا فلسطين. 22 مارس 2018. https://shorturl.at/p4rqN. خالد، الشيماء. "حرب الكلب الثانية.. هل تعمد إبراهيم نصر الله ’ثقوب‘ روايته؟." 24. 9 يوليو 2018. https://24.ae/article/450612.
-
لم يُفض تحقيق الشرطة البريطانية في اغتيال ناجي العلي في لندن عام 1987 (وأعيد فتحه عام 2017) إلى نتائج، لكن الشكوك لم تدُر فقط حول تورّط الموساد الإسرائيلي في الواقعة، بل حول منظمة التحرير الفلسطينية أيضًا التي انتقدها العلي في رسوماته بحدّة. Quitaz, Suzan. “Who Killed Naji al-Ali, Palestine's Most Beloved Artist?” The New Arab. 29 August 2017. https://www.newarab.com/analysis/who-killed-naji-al-ali-palestines-most-beloved-artist.
-
ناصر، أمجد. "الصحافة الثقافية شللية وامتثال." 1988. معاد نشرها في الوطن. 13 يونيو 2024. https://www.alwatan.com.sa/article/1148535.
-
الشافعي، شريف. "الصحافة الثقافية المصرية.. الوجع الخاصّ في قلب أزمة عامّة." المدن. 15 سبتمبر2021. https://shorturl.at/Rs7xW.
-
عوطة، روجيه. "قتل الصحافة الثقافية." المدن. 27 سبتمبر2018. https://shorturl.at/ifRkR.
-
موسى، عماد الدين. الصحافة الثقافيّة.. بين مطرقة السلطة وسندان التمويل؟ (1)." ضفة ثالثة. 6 سبتمبر 2019. https://shorturl.at/m1XB1.
-
صالح، فخري. "الصحافة الثقافية وغياب الحوار." الدستور. 20 مايو2010. https://www.addustour.com/articles/451976.
-
البيك، سليم. "الصحافة الثقافية وزمن الإبادة… في تجربة 'رمان الثقافية'." سين 48. 1 فبراير2024. https://faraamaai.org/articles/belkhat-alareed/alshaf-althkafy-ozmn-alabad-fy-tgrb-rman-althkafy