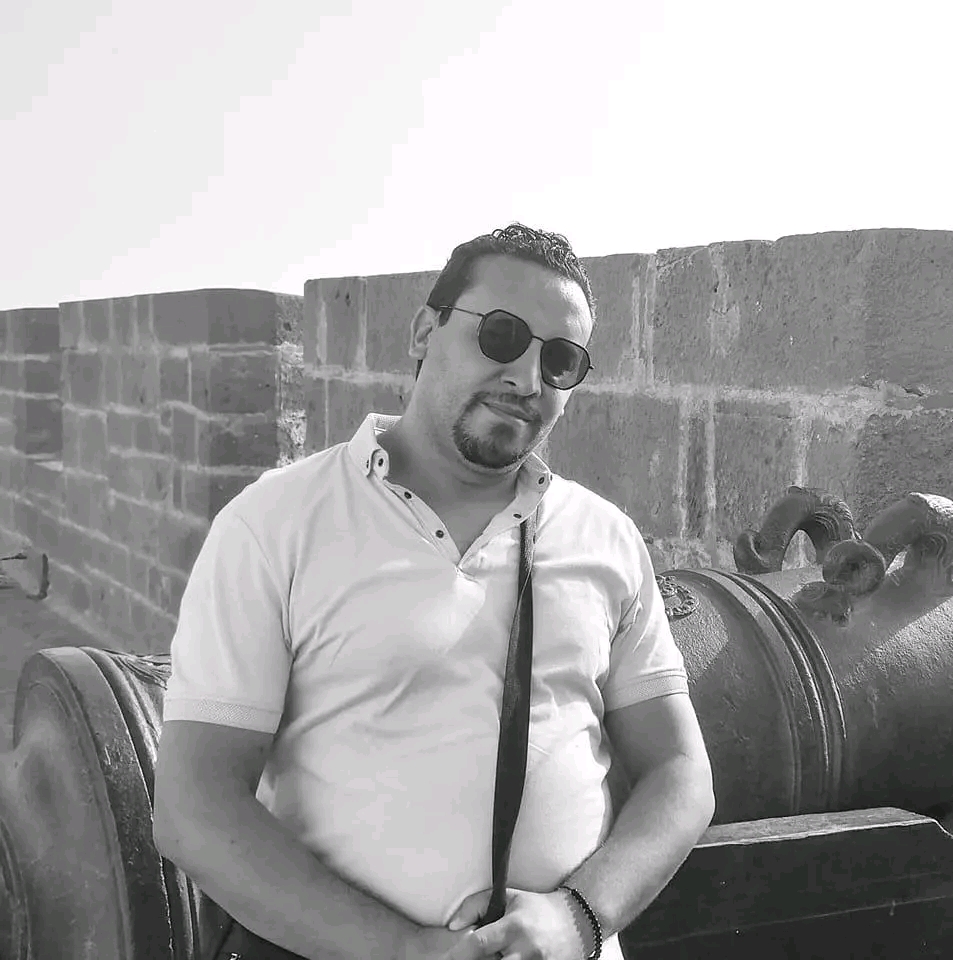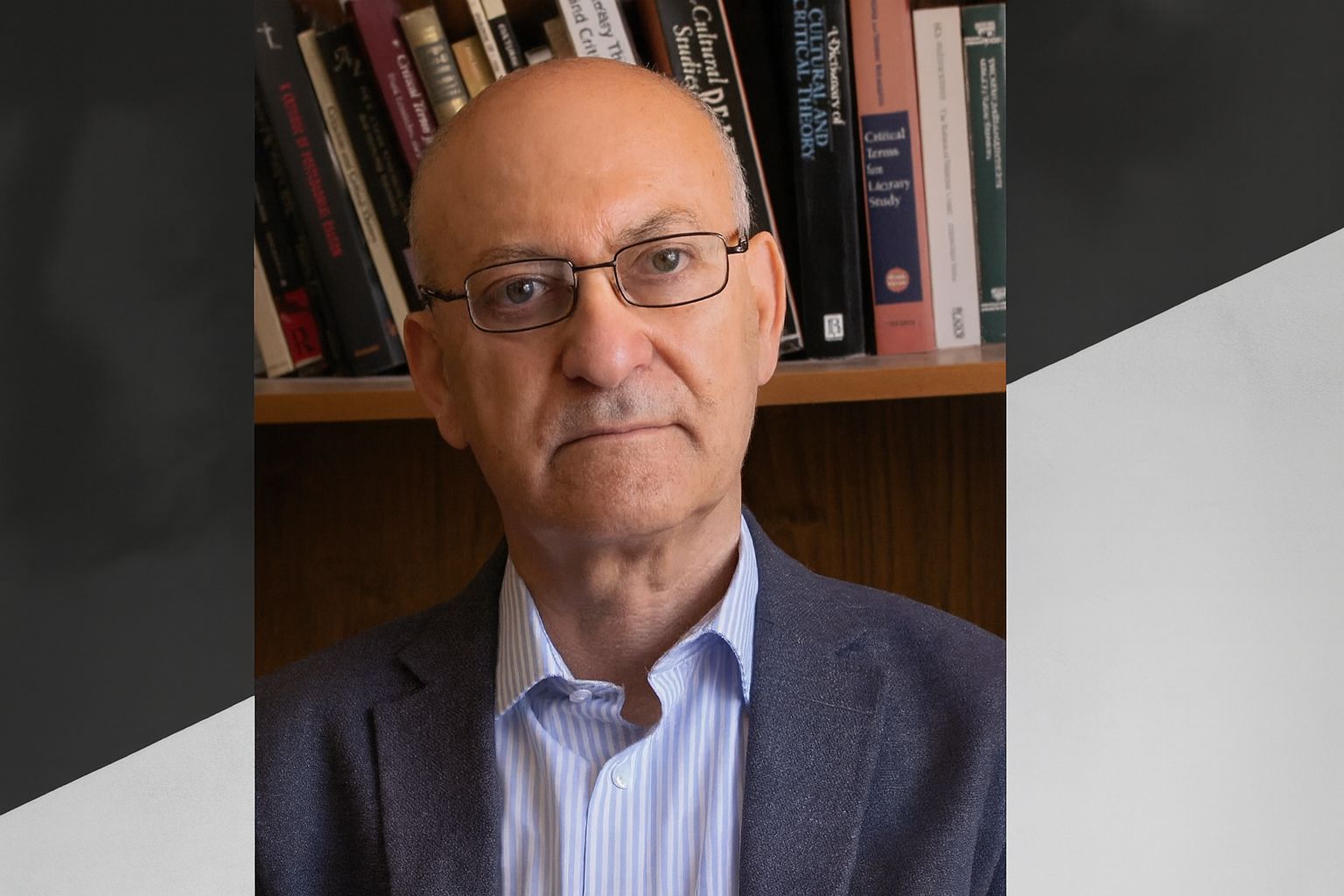طموح أي ثقافة ومن يمثلها ليس طموحا شخصيا، ولكنه جماعي عبر إشاعة هذا المناخ المتسائل الذي يضع الإنسان والمجتمع أمام أزماته الحقيقية؛ لذا تتأثر فاعلية الثقافة بالأجواء التي تحيط بها والقائمين عليها من حرية التعبير وتداول المعلومات بجانب الموهبة والتخصص المهني. على هذا النحو فإن الصفحات الثقافية تضطلع بدور الضمير الجمعي أو العقل الجمعي الذي يستشعر الأعطال في جسم أي ثقافة ويحدد أزماتها وربما احتياجاتها، ولا يتم هذا غالبا إلا بالتفاعل والجدل الدائم بين هذا الجزء الذاتي الذي يمثله الصحفي الثقافي صاحب الرسالة الصحفية والجزء الموضوعي الذي يمثل العقل الجمعي من الثقافة.
رغم حالات التضييق والظروف الاقتصادية والتقدم التكنولوجي الذي أثر على بقاء الصحافة الورقية وإقبال الناس عليها إلا أن هناك منارات ثقافية سواء كانت مجلات أو صفحات انتفاضات ثقافية ربما تمثل استثناء؛ حافظت على وظيفة الضمير الجمعي ورافقت مسيرة تكوين الوعي لأجيال عدة وصاغت عقل وقلب الكثيرين من أمثالي.
هناك جهد عصامي لكل مثقف سواء كان منتِجا أو مستقبلا للثقافة في الحصول وإنتاج المعرفة، وهو ما سوف أتتبعه في هذا المقال سواء من ناحية علاقتي الشخصية بالصحافة الثقافية أو من ناحية من يقوم بإنتاجها سواء كانوا أفراد أو مؤسسات، وربما يرجع السبب في الجدل الدائم فيما بينهما أن ثمة ثوابت فكرية وثقافية واضحة كالتنوير والتحرر -على سبيل المثال- اتُفِق عليها في تأصيل رحلة الصحافة الثقافية مع قرائها.
في تشريح الأزمة
إن أغلب الصفحات الثقافية المتميزة أو المجلات الجادة ظهرت في ظل أنظمة شمولية بعد التحرر؛ فكان المهجر أحد المنافذ لنقاش جاد وحر لقضية الحرية وهي إحدى قضاياها الأساسية، فمنحت صفحاتهم هذه الشحنة الإنسانية الخاصة بجانب أصالة الموهبة. على سبيل المثال يمكن تتبع رحلة الصحفي والكاتب الفلسطيني بلال الحسن الذي ساهم في إصدار جريدتي: السفير في بيروت، ثم مجلة اليوم السابع في باريس التي كانت بمثابة استثناء ضمن الصحافة الثقافية، وتوضح مدى تأثير وفاعلية البعد الشخصي في تمثيل ضمير جمعي.
هذا الضمير الجمعي بدأ يتلقى ضربات قوية مؤشراتها الأساسية انحسار الطبقة الوسطى التي كانت تشكل جوهره أمام انسداد الأفق أمام أبنائها وانحدار مستواهم التعليمي، لينتج عن ذلك تراجع النخب الثقافية عن القضايا الأساسية في المجتمع. يضاف إلى ذلك - في سياق شرح أزمة الصحافة الثقافية - غياب المشترك الثقافي لما يُسمى ثوابتَ العقلِ الجمعي كالرغبة في التنوير والتحرر.
إن أغلب الصفحات الثقافية المتميزة أو المجلات الجادة ظهرت في ظل أنظمة شمولية بعد التحرر؛ فكان المهجر أحد المنافذ لنقاش جاد وحر لقضية الحرية وهي إحدى قضاياها الأساسية، فمنحت صفحاتهم هذه الشحنة الإنسانية الخاصة بجانب أصالة الموهبة.
ولعل من الأسباب التي تفسر أزمة الصحافة الثقافية غياب التخصص وضعف الوعي النقدي وكذلك الموهبة السطحية للصحفي الثقافي؛ فاختفت لغة النقد وفارقت التجربة الثقافية بأنواعها الأدبية والفنية وتُركت الساحة للهواة، وسيطرت مكانها في العقود الأخيرة الثقافةُ الشعبوية الخالية من لغة النقد واستدعت نوعا من السطحية في تناول القضايا. أصبحت هناك ثوابت جديدة شكلية أو بمعنى أصح "لا ثوابت" تتحكم في الثقافة، ففقدت ميراثها في النقد والمهنية والجدية وأصبحت قريبة من حالة التسلية.
هناك عامل مهم قد يشرح هذه الحالة وهي السيولة الفكرية التي حدثت في التسعينيات بعد سقوط حائط برلين وغياب أحد القطبين كفكر وكرأسمال رمزيّ غذى جزء منه الوعيَ النقدي فيما قبل وساند قضايا التنوير، وبغيابه فُقد التوازن وحدثت الهزة في الصحافة الثقافية وبالطبع في شتى مناحي الحياة الإنسانية.
فتحت السيولة الفكرية لمرحلة ما بعد انهيار القطبية وحرب الخليج وتأثيرها الواسع المجال لدخول الكثير من الأفكار المتعارضة، فلم يعد العالم الخارجي - والعربي بشكل خاص - واضحا كما كان من قبل، وهو ما أظهر الحاجة لصحافة ثقافية من نوع متخصص يلبي قلق اللحظة وتغير الثوابت، والأنواع الأدبية والثقافية واتجاهاتها.
إن حالة السيولة أو اللايقين كانت تحتاج لوجود صحفي مفكر يجترح الأسئلة ويشارك في صياغة وتفسير مآل هذا السيولة، وهي الكوادر التي لم توفرها الثقافة داخل البلدان العربية مع وجود استثناءات قليلة؛ ربما كانت اللحظة تحتاج لزوايا نظر جديدة لأن هذه السيولة أو اللاثوابت أو اللايقين أنتجت جموعا مستهلكة للثقافة ليس لها تأسيس نظري أو انحيازات واضحة، فسادت حالة من سوء التفاهم المزمن بينهما - بين مرسل ومستقبل المادة الثقافية - وبذلك انشطر هذا الضمير الجمعي الذي كان يوحدها من قبل.
فتحت السيولة الفكرية لمرحلة ما بعد انهيار القطبية وحرب الخليج وتأثيرها الواسع المجال لدخول الكثير من الأفكار المتعارضة، وهو ما أظهر الحاجة لصحافة ثقافية من نوع متخصص يلبي قلق اللحظة وتغير الثوابت، والأنواع الأدبية والثقافية واتجاهاتها.
تطبيع ثقافي
بعد مرحلة ما بعد القطبيّ وحرب الخليج تعددت المنابر الثقافية الخليجية كصفحات ومجلات، فالوضع الجديد للسيولة أوجد فراغات لممارسة الحريات في بعض هذه البلدان. أصبحت بلدان الخليج بمثابة المتحكم في لحظة التحول هذه. ربما ورثت هذه الصحافة الثقافية الحس المهني الذي جاء به صحفيو لبنان وباقي الدول العربية الذين انتقلوا للعيش فيها بسبب الأزمات الاقتصادية في بلدانهم لتظهر ملاحق ثقافية مهمة محترفة في الإمارات؛ في جرائد مثل الخليج والبيان والأيام وغيرها.
في الثمانينيات بدأ ظهور دكاكين الصحافة الخليجية الثقافية في مصر عبر شبكة من الصحفيين والكتاب الثقافيين المصريين. بدأت مرحلة تطبيع ثقافي مع دول الخليج التي كانت مجهولة أو تمثل هامشا "رجعيا"، التي فتحت ذراعيها لطيف من أهم الكتاب والفنانين العرب كانوا يعملون في غرف تحرير صحفها بالتزامن مع بدايات حركة شبابية شعرية بدأت في الإمارات منذ الثمانينات، صدر عنها بعض المجلات الشعرية بمبادرات خاصة أو عن طريق اتحاد كتاب الإمارات.
ثقافة جريدة الأهرام
في الثمانينيات ومع اشتباكي الفعلي مع الثقافة، كنت أواظب على قراءة الصفحة الثقافية في جريدة الأهرام الرصينة بحكم العادة وارتباط بيوت الطبقة المتوسطة بها. صفحات ثقافية أسبوعية مخصصة لمقالات كتاب كبار من أجيال الثلاثينيات الأربعينيات الخمسينيات المزدهرة: توفيق الحكيم يوسف إدريس عبد الرحمن الشرقاوي لويس عوض علي الراعي وغيرهم. ذلك أن جميعهم كانوا يمتلكون تجربة فكرية ثرية ووعيا جماليا مدربا على النقد مع موهبة ذاتية يمكنها الوصول للقارئ العادي والنخبوي في آن واحد، لقد عزّز هذا قوةَ القضايا التي كانت تناقشها الصحافة الثقافية.
اتسمت هذه الكتابات بالمزج الأسلوبي بين لغة الصحافة والطرح الأكاديمي المتخصص، بين الثقافة والقضايا الفكرية للمجتمع، ومراجعات الكتب، ومناقشة ظواهر ثقافية ومجتمعية؛ مثل السجال الذي دار بين الشيخ الشعراوي وكلٍّ من توفيق الحكيم ويوسف إدريس كلٌ على حدة. اختفى بالتقادم هذا النوع من الكتّاب أو الأدباء الموسوعيين الذين كانوا يغطون على ضعف أسلوب نموذج الصحفي الثقافي التقليدي -الموظّف- الخالي من الروح.
لعل من الأسباب التي تفسر أزمة الصحافة الثقافية غياب التخصص وضعف الوعي النقدي وكذلك الموهبة السطحية للصحفي الثقافي؛ فاختفت لغة النقد وفارقت التجربة الثقافية بأنواعها الأدبية والفنية وتُركت الساحة للهواة، وسيطرت مكانها في العقود الأخيرة الثقافةُ الشعبوية.
الدوحة واليوم السابع
في عقد الثمانينيات حيث كان المجتمع المصري في حالة كمون اضطراري، كانت لاتزال هناك ثوابت ثقافية وقضايا فكرية تدور حول التنوير وعلاقة الحاضر بالتراث الإسلامي تناقش في بلدان أخرى وبزوايا نظر جديدة. تعرّفتُ وقتئذ على مجلتين في غاية الأهمية: مجلة الدوحة في سنوات رئاسة رجاء النقاش للتحرير فيها، ومجلة اليوم السابع التي أسسها الكاتب والصحفي الفلسطيني بلال الحسن.
أهمية مجلة الدوحة هو انفتاحها على التجارب العربية في الكتابة والفن، ودمجها الأسلوبي بين الأدبي والصحفي، وخاصة السير الذاتية لكتاب وشعراء مثل فدوى طوقان، واستحداث أبواب وموضوعات ثقافية كسِيَر الأدباء المنتحرين (مثل خليل حاوي). ربما تمثل " الدوحة" نقلة نوعية لمجلة العربي الكويتية التي كان يرأس تحريرها أحمد بهاء الدين.
كذلك مجلة "اليوم السابع" التي صدرت في باريس بين 1983 و1991 برئاسة تحرير بلال الحسن المقرب من ياسر عرفات؛ حيث كانت تمولها منظمة التحرير الفلسطينية بعد خروجها من لبنان والذهاب إلى تونس.
حملت المجلة روح الصحافة اللبنانية التي تعتمد على المهنية مع المتعة والتنوع مع مساحة واسعة من طرح الأفكار الحديثة والقضايا السجالية؛ كسجالات عابد الجابري وحسن حنفي حول موقعنا من التراث وتجديد الفكر العربي، بالإضافة إلى أبواب متخصصة في السينما والمسرح والنقد والأدب ومراجعات الكتب.
انبنت التجربة على استكتاب كتاب على درجة عالية من التخصص الثقافي، وأغلبهم كانوا مهاجرين على خلاف مع حكوماتهم؛ مثل جوزيف سماحة ومحمود درويش وكاظم جهاد وصبحي حديدي وعابد الجابري وحسن حنفي وبيير أبي صعب وبرهان غليون...
في عام 1984 برزت تجربة حزبية ثقافية مميزة؛ تمثلت في مجلة "أدب ونقد" التي كان يصدرها حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي اليساري. تميزت المجلة وقتئذ بجرأتها في النقد السينمائي وباختياراتها النوعية للأفلام التي تناولتها بالتحليل، في مقابل مطبوعات الدولة مثل مجلة "فصول" التي كانت غارقة في تشيئ لغة النقد والانشغال بالتنظير البنيوي.
الحياة والناقد
في التسعينيات كانت عناصر الحيوية الثقافية والمهنية والتنوع تنهل من الصحافة العربية المهاجرة، أو التي انتقلت إلى الخليج خاصة بعد حرب الخليج الثانية التي أضفت سيولة على مفهوم الحرية نفسه وعلى مفهوم الهجرة الذي لم يعد مرتبطا بموقف سياسي بل برؤية اقتصادية. في هذه الفترة ظهرت صحافة ثقافية ورقية وأيضا رقمية عبر مواقع وصفحات شخصية لكتابها مع بداية الألفية الجديدة.
صدرت صحيفة الحياة في لندن سنة 1988 التي شكلت رئة جديدة وحقيقية بالنسبة للصحافة الثقافية في العالم العربي؛ من حيث حداثة الموضوعات الثقافية وعمقها وتنوعها. خاطبت المجلة قارئا عربيا نوعيا يختلف عن القارئ العادي، ورغم تكرار بعض المواضيع أو عدم حدوث تغير جذري في التبويب ضخت دماء جديدة في معالجاتها التحريرية. ومع بداية التقنيات الحديثة في الطباعة والاتصالات كثرت عدد مكاتبها ومراسليها في البلدان العربية مما سهل الحصول على تغطية لهذا العقل أو الضمير الجمعي الثقافي للعالم العربي.
ظل للجريدة تميزها الثقافي بسبب المهنية والتخصص، خصوصا الفترة التي كانت تصدر فيها من لندن، وربما ضمنت لها المسافة عن العالم العربي وأزماته أيضا البعدَ عن التورط السياسي أو التماهي مع إشكالياته الثقافية ومشاكله السياسية فحفظ لها مكانة خاصة.
ظل لجريدة الحياة تميزها الثقافي بسبب المهنية والتخصص، خصوصا الفترة التي كانت تصدر فيها من لندن، وربما ضمنت لها المسافة عن العالم العربي وأزماته أيضا البعدَ عن التورط السياسي أو التماهي مع إشكالياته الثقافية ومشاكله السياسية فحفظ لها مكانة خاصة.
لا أنسى أيضا ملحق "آفاق" الأسبوعي الذي كان يحرره الروائي اللبناني ربيع جابر لطبعة الحياة اللندنية بداية من 2001، حيث تميز بفرادة خاصة وحرية في تناول الأفكار وابتكار أشكال للتغطيات الصحفية بداية من القصص الصحفية المصورة وصولا إلى النقد.
ثمة أيضا تجربة مجلة الناقد اللبنانية الصادرة عند دار رياض الريس التي كانت تشكل نقلة سواء من ناحية إنجازها الشعري الذي توج بجائزة يوسف الخال القيمة وأيضا معاركها وملفاتها الثقافية، بجانب الحس الأدبي الرفيع لباب خواتم لأنسي الحاج الذي ارتبطت به على نحو ما هذه التجربة. ولابد أن نستحضر "السفير الثقافي" وكتابات عباس بيضون وعناية جابر وإسكندر حبش وغيرهم ومحاولتهم لتوفير هذا "الصفاء الوجودي" الثقافي لمقالاتهم.
أهمية هذه المجلات أنها كانت تحاول المحافظة على مسافاتها المنضبطة والمستحيلة مع الواقع السياسي المشتبك ومع مصادر تمويلها كالمحلق الثقافي لجريدة الأخبار المميز؛ لذلك انطوت على تناقضات سياسية ظهرت في الطريق، وهي أحد أقدار الثقافة العربية التي حالت دون تطورها.
الكتب ووجهات نظر
هناك تجربتان في الصحافة الثقافية المصرية في غاية الأهمية بالنسبة للكثيرين ظهرتا في الألفية الجديدة ما بين 2000- 2010: "الكتب.. وجهات نظر" ولعل جزءا أساسيا من اهتمام المجلة كما يظهر في العنوان هو مراجعات الكتب، وكذلك صفحة الثلاثاء في صحيفة الأهرام "غذاء العقول" للأستاذة ماجدة الجندي تلميذة مدرسة صباح الخير الثقافية، وهي من الصفحات القليلة المتخصصة التي كانت تهتم بعرض وتحليل الكتب.
ربما أهمية "وجهات نظر" تحت رئاسة تحرير الكاتب القدير سلامة أحمد سلامة أنها كانت بالفعل كما ظهر في منشور افتتاحيتها: تعميق للحوار وتقاليده بين المثقفين والأكاديميين وقادة الرأي، وهو الثلاثي الذي يحمي مفهوم الثقافة ويغذيه بالأفكار والاحتياجات ويشير لأعطابه؛ فالاسم يحمل فكرة التعدد وهو المفتقد في الحياة السياسية والثقافية في مصر.
كان هناك التزام صارم بمفهوم المهنية ودرجة جودة المقالات، والمزج بين الرأي الخاص والدراسة المعمقة، وعدم السعي وراء الأفكار السهلة أو المعالجات التي ترضي الثقافة الشعبوية، إلى درجة أنها شُبِّهت من ناحية رصانتها بالمجلة الفكرية الأمريكية "نيويورك ريفيو أوف بوكس".
نجحت المجلة منذ عددها الأول في اكتساب شهرة واسعة ومكانة مميزة بين المثقفين والأكاديميين وصناع القرار في العالم العربي وكذلك المهتمين بالمنطقة في المؤسسات الأكاديمية الغربية.
تميزت المجلة بالمقال السردي الطويل الذي يجمع بين الحس الذاتي وروائية الموهبة داخل سياق اجتماعي أو سياسي واسع، وهو الأسلوب الذي تبناه الكاتب محمد حسنين هيكل في افتتاحياته للمجلة.
هذا الحس الذاتي للكاتب في مناقشته للقضايا العامة أو الذاكرة الجمعية للمصريين وجدته عند الأستاذة ماجدة الجندي في صفحة "غذاء العقول" بجريدة الأهرام، إنه صدى ذاتي مشحون بالمشاعر الشخصية دون ضغط أو توجيه لعاطفة القارئ؛ لأنه يتضمن دقة بلاغية في رصد الأفكار والتعبير عنها مقترنة بسعة اطلاع على الصحافة العالمية.
الفن السابع والفيلم
كان في الألفية الجديدة نصيب للسينما والصورة عبر مجلتين إحداهما أصدرها الفنان محمود حميدة؛ وهي "الفن السابع" (1997- 2003) التي تخصصت في صناعة السينما، وهدفها السعي للتخصص وتناول جوانب المهنة المتعددة وليس فقط حياة الممثل الاجتماعية؛ فصناعة السينما بكل أطرافها أصبحت جزءا من اهتمامات المجلة: التمثيل والإخراج والإنتاج، وكان الغرض منها هو إنتاج معرفة في هذه التخصصات يمكن أن تساعد على تحسين جودة المنتج السينمائي وتطويره.
ويمكن أيضا أن نشير إلى مجلة "الفيلم" وهي غير دورية صدرت 2014 عن جمعية النهضة بجيزويت القاهرة تهتم بثقافة السينما وفن الصورة، ومن اهتماماتها أيضا عرض نماذج لسينما مختلفة تكسر هيمنة الفيلم الأمريكي.
إن استعراض هذه التجارب من الصحافة الثقافية يبرز مدى ارتباطها بالتحولات السياسية والاجتماعية في العالم العربي؛ إذ لا يمكن بأي حال من الأحوال الفصل بينهما، ومع تطور المنصات الرقمية يمكن أن نطرح هذا السؤال: هل ستحرر هذه المنصات مساحات جديدة للصحافة الثقافية أم تلتهم ما تبقى منها؟