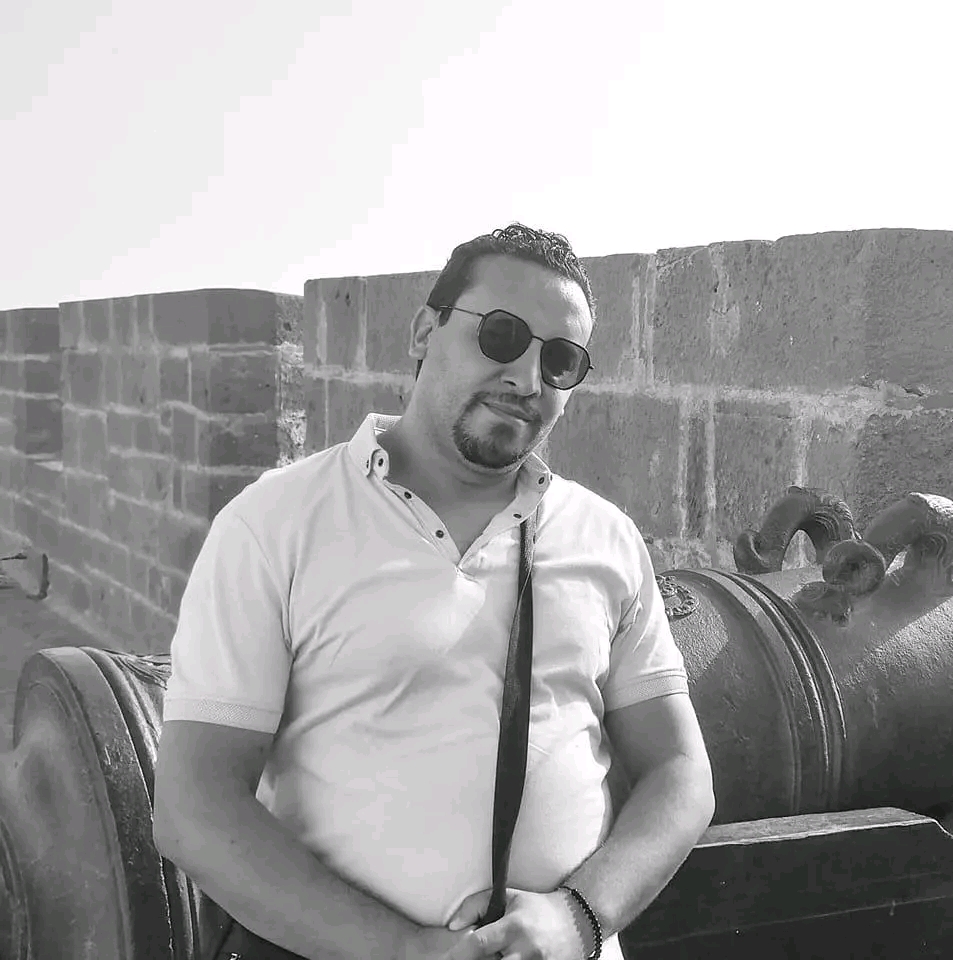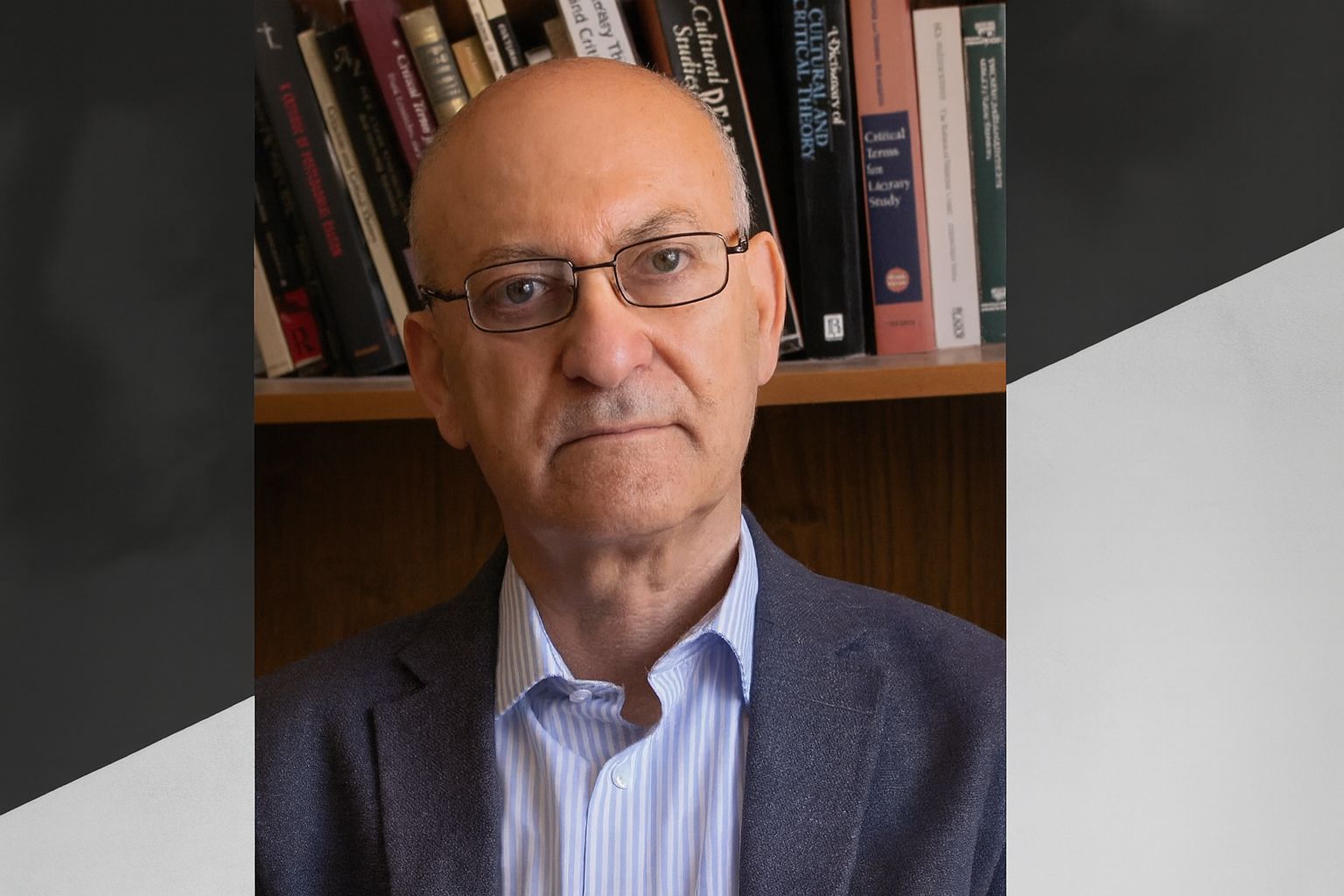تطرح علاقة الثقافة بالتلفزيون في سياقنا الإعلامي العربي أكثر من سؤال على أكثر من مستوى وذلك لطبيعتها الإشكالية. فالأمر يتعلق – أوّلًا - بالتلفزيون خالق الفرجة ووسيلة الترفيه بامتياز. وكلُّ ما يقدِّمه التلفزيون يجب أن يكون للفرجة مَهما كانت طبيعته ومضمونه، بدءًا بالإنتاج الدرامي والمُقابلة الرياضية حتى الحوار السياسي والبرنامج الثقافي. لكنَّ غياب الوعي بخصوصية هذا الوسيط قد يورِّط أحيانًا بعض من يخوض غماره من أهل الثقافة في التعالي عليه واحتقار منطق الفرجة الذي يحتكم إليه. وفيما يتشبّث هؤلاء بشرف الثقافة وجدّية قضاياها وأسئلتها وضيوفها، تراهم يُقدّمون مادّة متجهّمة قد يُقبِل عليها المُتابع المُتخصّص فيما يتبرّمُ منها المشاهد العادي ويجدُها الجمهور العام عسيرةَ الهضم. وكثيرًا ما يستغلُّ مسؤولو التلفزيونات العربية - عموميةً أو خاصّةً - تبرُّمَ الجمهور من هذه المادةِ "عسيرةِ الهضم" ليعاقبوها بالمزيد من التضييق على البرامج الثقافية، بدءا بتقليص مساحتها والتّقتير عليها إنتاجيًّا، وانتهاءً ببرمجتها خارج أوقات الذروة، غالبًا خلال الجزء الثاني من السهرة. وبما أن زمنَ البثِّ ومساحتَه سُلطتان حاسمتان تُرجِّحان الكفَّة لصالح فئات ضدّ أخرى، تصير النماذج التي يتمُّ تسويقُها في فترات الذروة أهمَّ - في تقدير العموم - من تلك التي لا تُبَثّ إلا في منتصف الليل بغضِّ النظر عن رؤية هذا وخطاب ذاك. هكذا ينشَدُّ الجمهور العام أكثر فأكثر لتلك الفئات التي تستأثر بالذروة وتستفيد من الزمن التلفزيوني بحتمية لافتة: ممثلين حتى ولو كانوا مبتدئين، فكاهيّين حتى ولو كانوا مجرّد مهرّجين، مطربين ومطربات حتى ولو كانوا من الدرجة الثانية، سياسيين وحزبيين حتى ولو كانوا مجرد تُجّار انتخابات. لكنَّ منطق التلفزيونات العربية قدَّر -مع الأسف- أن هؤلاء أقرب إلى الوجدان العربي وأقدر على مُخاطبته من نخبة ثقافية وأدبية وفكرية "مُتحذلقة" "تدّعي" أنها هي من يصنع الوجدان.
ينشَدُّ الجمهور العام لتلك الفئات التي تستأثر بالذروة وتستفيد من الزمن التلفزيوني بحتمية لافتة: ممثلين حتى ولو كانوا مبتدئين، فكاهيّين حتى ولو كانوا مجرّد مهرّجين، مطربين ومطربات حتى ولو كانوا من الدرجة الثانية، سياسيين وحزبيين حتى ولو كانوا مجرد تُجّار انتخابات. لكنَّ منطق التلفزيونات العربية قدَّر أن هؤلاء أقرب إلى الوجدان العربي وأقدر على مُخاطبته من نخبة ثقافية وأدبية وفكرية "مُتحذلقة" "تدّعي" أنها هي من يصنع الوجدان.
لكن، هل المادة الثقافية تخاصمُ الفرجة وتفتقر إلى أسبابها كما يزعمون؟ أم أنّ الفُرجة تُصنَع، وصناعتُها تحتاج إلى استثمار قلّما تحظى به البرامج الثقافية المُتخلّى عنها إنتاجيا؟ للإجابة عن هذا السؤال، يسوق الباحث المغربي في الخطاب السمعي البصري الدكتور محمد طروس في كتابه "رهان الجودة في التلفزيون العربي" مثال مباريات كرة القدم المُتلفَزَة التي يُشيدُ الباحث بـ "مقاربتها الإخراجية الدرامية وتقطيعها الدقيق وتأطيرها المتنوّع"، فيما يصف نقلَها التلفزيوني كالتالي: "تتعدّد زوايا النظر ومواقع الكاميرا؛ ليتمكن المُشاهد من التموقع في كل مكان، يُلِمُّ بكل صغيرة وكبيرة، ويتماهى مع الإيقاع المُتنامي، ويصل إلى أقصى درجات المتعة".(1)
لكن لنتصوّر - يضيف د. طروس - أنّنا نتلقى المباراة نفسها "من كاميرا واحدة ثابتة، وزاوية نظر أحادية تُماثل وضعية المتفرّج داخل الملعب"، حينها سينتفي التقطيع وحركة الكاميرا وستفقد المباراة أهمّ مقوّمات الفرجة. لذلك، يصعب توقُّع الفرجة من برنامج ثقافي يُقدَّم في أستوديو صغير وديكور متقشف يتّخذ هيئة مكتبة في الغالب، بكاميرتين لا ثالثة لهما. فالعبرة ليست بالمضمون وحده مهما كان المضمون جادًّا، وإنما بالشكل الفنّي والجودة التقنية والأسلوب البصري التي تتحكّم فيها إلى حدِّ كبير شروط الإنتاج وإمكانياته دون أن ننسى أنّ هناك علاقة جدلية بين الإنتاج والبرمجة. فالبرنامج الذي يبث في وقت ميّت هو بالضرورة برنامج ضعيف المشاهدة محدود التأثير، فالجمهور العام يعتبر البرمجة معيارا من معايير جودة البرامج وتفوّقها. هكذا مع البرمجة في غير أوقات الذروة يفقد البرنامج الثقافي ثقة الجمهور. وهذا ينال من قيمته وإشعاعه. وطبعًا لا يمكن لإدارة عاقلة أن تغدق على برنامج لا إشعاع له، ليجد البرنامج الثقافي نفسه عالقا في ورطة أشبه ما تكون بمسألة البيضة والدجاجة.
تجاوُز هذا الوضع الإشكالي يتطلّب أن يُراجع الطرفان معًا أوراقهما. ولنبدأ بالتلفزيون ومَن يُديره. طبعا للتلفزيون حساباتُه المشروعة؛ فالمنافسة على أشُدِّها بين القنوات، والمُشاهد مَلول متبرِّم وشدُّ انتباهه وضمانُ ولائه يحتاج إلى مجهود جبار. لأجل ذلك تبذل إدارات التلفزيونات العربية قصارى جهدها لكي تظل دائما عند حسن ظن "مُشاهديها الأوفياء"، خصوصًا أنّ الوفاء اليوم صار قابلا للقياس؛ فللمتابعة نِسَبٌ معلومة والمُعلِنون يتعاملون مع المحطات التلفزيونية بناء على هذه النسب لتتطوّر الأمور باتجاه مقاربة تشاركية صار معها المعلنون ينتجون برامجهم أحيانا أو يفرضون نجومهم خصوصا في الدراما والكوميديا الرمضانية، وكل ذلك في سياق عربي نعرف أعطابه السياسية والاقتصادية وتردِّي وضعه التربوي والاختلالات التي طالت منظومة القيم لديه. وإذا كان سعي التلفزيونات الخاصة إلى الربح يبرِّر لها هذا التوجُّه فإن وضع التلفزيونات العمومية مختلف؛ لأنها مطالبة بما نطالب به باقي المرافق العمومية من خدمات يجب تقديمها للمواطنين لتسويغ ما تحصل عليه من دعم مالي مموَّل من جيوب دافعي الضرائب. لذلك نتجرّأ على طرح السؤال التالي: ماذا عن دور الوسيط التلفزيوني في بلدان تحتاج إلى تأهيل حضاري وتنمية بشرية كبلداننا؟ أوليس مطالبا بالاضطلاع بمهام الإعلام والتربية والتثقيف، إلى جانب التّرفيه طبعا؟
لذا، نتصوّر أنّه ليس من حقّ التلفزيونات المطالِبة بالخدمة العمومية تتويجُ نسبة المشاهدة قيمة القيم، ليصير المضمون الجاد والعمق الفكري والوظيفة التربوية مجرد كلام فارغ لا يصمد أمام ديكتاتورية نسبة المشاهدة. والغريب أننا نتابع منذ فترة ليست بالقصيرة كيف حمِيَ وطيس المنافسة -التجارية والإشعاعية- بين القنوات العمومية داخل البلد الواحد أو بين البلدان العربية دون أن ننتبه إلى أن هذه المنافسة تتمُّ أصلًا في المُعترك الخطأ. وذلك لأن التنافس يكون على رفع نِسَب المشاهدة بجميع الوسائل والمواد، حتى لو كانت خردة مسلسلات مكسيكية أو تركية أو مجموعة من السيتكومات الملفّقة، والفوز بأكبر نصيب ممكن من كعكة الإعلانات حتى ولو جاء ذلك على حساب هوية القناة والتزاماتها إزاء المجتمع، مثل هذه المنافسة لا نجد فيها رابحًا؛ ببساطة لأننا قد نكسب المزيد من المشاهدين وبالتالي المزيد من الإعلانات لكننا نخسر الإنسان.
ماذا عن دور الوسيط التلفزيوني في بلدان تحتاج إلى تأهيل حضاري وتنمية بشرية كبلداننا؟ أوليس مطالبا بالاضطلاع بمهام الإعلام والتربية والتثقيف، إلى جانب التّرفيه طبعا؟ لذا، نتصوّر أنّه ليس من حقّ التلفزيونات المطالِبة بالخدمة العمومية تتويجُ نسبة المشاهدة قيمة القيم، ليصير المضمون الجاد والعمق الفكري والوظيفة التربوية مجرد كلام فارغ لا يصمد أمام ديكتاتورية نسبة المشاهدة.
وأعتقد أن قنواتنا، خصوصا تلك المُلزَمة بواجب الخدمة العمومية أو المشغولة بهواجس التحديث والتنوير، معنية بمصاحبة المشروع المجتمعي الشامل في مجال التنمية البشرية؛ إذ لا يمكننا فتح ورشات عمل اقتصادية وتنموية، خصوصا على مستوى التنمية البشرية دون أن يساهم الإعلام -والتلفزيون بالخصوص- في مصاحبة هذه الورشات بمجهود محسوس في مجال تأهيل الإنسان على المستوى الثقافي والتربوي والقيمي. وهنا لا أتصوّر أنّ بإمكان المسلسلات المكسيكية أن تفي بالغرض مهما علت نسب مشاهدتها. لا بدّ من إنتاج أصيل أوّلًا، ولا بدّ من مواد وفقرات أكثر جدية ومسؤولية: دراما وطنية عميقة وذكية تنصت لتحوّلات المجتمع وتفتح عيون مشاهديها على خيارات هادفة وتُروِّج من خلال أبطالها لقيم إيجابية سواء انتمت إلى المنظومة القيمية الأصيلة كقيم التكافل والتآزر والقناعة، أو إلى المنظومة الحديثة بكل ما تكثفه من قيم المواطنة والحرية والاختلاف واحترام الآخر. برامج إخبارية تُقارب مادّتَها بموضوعية ومهنية وبروح تحليلية نزيهة. وبرامج ثقافية تَصدُر عن اقتناع بأولوية الثقافة في معركة التنمية البشرية وبناء المواطنة الفاعلة وتأخذ بعين الاعتبار أهمية وحساسية دور الوسيط التلفزيوني في تثقيف المجتمع خصوصا مع اكتفاء الغالبية العظمى من مواطنينا بالتلفزيون بصفته وسيطا يقدّم الأخبار والمعرفة في ظل تراجع القراءة في مجتمعاتنا. لذلك، يجب تعزيز البرمجة الثقافية في كل التلفزيونات العربية الواعية بدورها الحضاري والتربوي. يجب أن تكسب الثقافة مساحات جديدة على الشاشة لأنّ التلفزيون بصفته وسيطا صار يلعب اليوم دورًا محوريًّا في صناعة الرّأي العام والوجدان الجمعي. وعلينا أن نختار: هل نريد شعوبا يقظة لها حدّ أدنى من المعرفة والوعي والقدرة على التمييز؟ أم نريد كائنات استهلاكية هشة لا مناعة لها ومستعدة لابتلاع أيّ خطاب مهما كان سطحيا حتى لو كان خطيرا، وتتلقى الفرجة السطحية والتفاهات برِضًا وتسليم؟
عمومًا، حاجة التلفزيون إلى الثقافة وأهمية الوسيط التلفزيوني في الترويج للثقافة والخطاب الثقافي يفتح أمامنا نقاشا جدّيا نحن مهزومون فيه إذا ما واجَهَنا خبراءُ نِسَب المتابعة بمنطقهم وحساباتهم وما يسوّغون به اختياراتهم التجارية المحضة من إكراهات. لذلك نحتاج وباستعجال إلى قرارات سياسية شجاعة من أصحاب القرار إذا كانت لديهم مشاريع مجتمعية حقيقية وكانوا يحتاجون شعوبهم فعلا في معارك المستقبل وفي تحدّيات بناء الإنسان.
يجب أن تكسب الثقافة مساحات جديدة على الشاشة لأنّ التلفزيون بصفته وسيطا صار يلعب اليوم دورًا محوريًّا في صناعة الرّأي العام والوجدان الجمعي. وعلينا أن نختار: هل نريد شعوبا يقظة لها حدّ أدنى من المعرفة والوعي والقدرة على التمييز؟ أم نريد كائنات استهلاكية هشة لا مناعة لها ومستعدة لابتلاع أيّ خطاب مهما كان سطحيا حتى لو كان خطيرا؟
لقد شاهَدْنا كيف لعبت بعض الفضائيات العربية لعبة الإعلام السياسي التحريضي وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية ونجحت في ذلك سياسيا وتجاريا، وكيف ردّت عليها فضائيات أخرى مهمة بالمسلسلات المكسيكية الماراثونية المُدَبلجة وهو ما وجدت فيه بعض الأنظمة السياسية والقنوات الرسمية التابعة لها فرصة لاسترداد المشاهدين خصوصا من النساء وغير المتعلمين وفئة الشباب والمراهقين. أعتقد أن الوقت قد حان لكي يجرّب التلفزيون العربي طريقا ثالثا لا تحريض فيه ولا تبلّد. والثقافة هي عنوان هذا الطريق الثالث. لكنّ جزءا مُهمًّا من الإعلام المرئي العربي يعيش في انفصالٍ تامٍّ عن أية خلفية ثقافية، وبدأ يبتعد بالتدريج عن مقاربة قضايا السياسة والمجتمع والفن انطلاقا من منظور ثقافي رغم أن للثقافة دورا جوهريا في تأطير المجتمع وتخليق الحياة العامة وتحصين المجال السياسي من التطرف والمذهبية المنغلقة، وكذا في إضفاء المعنى والروح والدّلالة على الإنتاج الفني بمختلف أصنافه. والإحساس بأن بإمكاننا اليوم أن نتطوّر ونتقدّم ونساهم في تحديث الفن والمجتمع والعمران والسياسة بدون حاجة إلى الثقافة وبدون خلفية ثقافية تؤطر ذلك كله أمرٌ يدعو فعلًا إلى القلق.
لكن، هل كل ما نطلبه اليوم من تلفزيوناتنا العربية هو مضاعفة المادة الثقافية وتعزيزُها بمساحات أوسع في خرائط البرمجة؟ هل كل ما نحتاجه هو تمتيع البرامج الثقافية بمواعيد بث أفضل تتيح لهم التواصل مع أكبر عدد من المواطنين؟ قد يكون هذا صحيحًا، لولا أنّ الحاجة إلى الثقافة في التلفزيونات العربية تتعدّى هذه المطالب إلى تحديات أكثر جوهرية. فما نحتاجه اليوم باستعجال هو توسيع مجال الثقافة أوّلًا لتتجاوز حدود الأدب والإنتاج الفكري والفلسفي. نحتاج فعلا إلى إخراج البرامج الثقافية من شرنقة النظرة الأدبية الضيقة إلى الأفق الثقافي الواسع. فإضافة إلى الانشغال بالأسئلة الأدبية والإبداعية والفكرية، من المهم أن تتحوّل البرامج الثقافية إلى منابر يمارس من خلالها الفاعلون الثقافيون في البلاد العربية حوارهم مع المجتمع وقضاياه. فتبنّي المقاربة الثقافية لقضايا المجتمع يمكنه أن يحتلّ مكانة محورية في صلب السياسة التحريرية لبرامجنا.
نحن في أمسِّ الحاجة إلى صوت المثقف ليدلي بدلوه في الشأن السياسي والديني والاقتصادي والاجتماعي، وليقترح تحليله الخاص لمختلف الظواهر السياسية والاجتماعية. وهناك اليوم العديد من الموضوعات المطروحة للنقاش المجتمعي في العالم العربي، نتصوّر أن المقاربة الثقافية قد تُنْصِفها أكثر مما تفعل لغة السياسة وذرائعية السياسيين. إن الديمقراطية أفكار ورؤى ونقاش، وهي تصدر عن الفكر وتأتي من الكتب مهما تغزَّلنا بحيوية المجتمع وحراك الشارع السياسي. إنّ الديمقراطية حوار أفكار وصراع مشاريع مجتمعية وبناء مؤسسات، قبل أن يكون غضبًا وشعارات، تصويتًا وانتخابات. والتلفزيون اليوم مُطالب بإتاحة المجال أمام النقاش المعرفي بطريقة تخدم إعمال العقل وتعيد للتفكير النقدي موقعه داخل الفضاء التلفزيوني العمومي وداخل المجتمع، والمراهنة على الحوار لكي نذهب به أبعد من الشعار.
ما نحتاجه اليوم باستعجال هو توسيع مجال الثقافة أوّلًا لتتجاوز حدود الأدب والإنتاج الفكري والفلسفي. نحتاج فعلا إلى إخراج البرامج الثقافية من شرنقة النظرة الأدبية الضيقة إلى الأفق الثقافي الواسع. فإضافة إلى الانشغال بالأسئلة الأدبية والإبداعية والفكرية، من المهم أن تتحوّل البرامج الثقافية إلى منابر يمارس من خلالها الفاعلون الثقافيون في البلاد العربية حوارهم مع المجتمع وقضاياه.
هذا هو المعنى الأشمل للثقافة في التلفزيون. وهو أمر لا يجب أن يوكل إلى التقنيين وخبراء نسب المتابعة. لكن بالمقابل نحتاج الخبرة والدعم التقني في الخطط والمشاريع والعمليات الداخلية لصناعة البرامج الثقافية بما يرفع من شكلها الفني وجودتها التقنية وأسلوبها البصري. هذه الخطة تبدأ من إعداد الأرضية الأساس التي يتحكّم في بلورتِها الصحافيون الثقافيون والمثقفون الذين يشتغلون بالتلفزيون.
ولعل أول عنصر يجب الاشتغال عليه هو اللغة. لا بدّ من بلورة لغة إعلامية رشيقة لا تتنازل عن فصاحتها ولا تتعالى مُتفاصِحَةً على المشاهدين. فالأجدى أن نتعاون جميعا لبلورة لغةٍ قادرة على النفاذ إلى قلوب الناس وعقولهم. لغة تختلف عن لغة الكتب والأطروحات الجامعية. ثم لا بد من ضرورة تحرير الخطاب من الأجهزة المفاهيمية ولغة التخصّص والمرجعيات والإحالات والأسماء الطنانة التي يتوخّى منها البعض إبهار المشاهدين بينما هم في الواقع يعرقلون التواصل معهم ويدفعونهم دفعا إلى التبرّم من برامج الثقافة وحوارات المثقفين. فالجمهور العام يريد أفكارًا واضحة، وهذا حقّه. وإذا لمسنا لديه استعدادًا لبذل مجهود في المتابعة فلا يجب علينا إحراجه بالمفاهيم المُستغلِقة والتحليلات المعقدة، أو طرده خارج مدار النقاش بالإغراق في اللغة الأكاديمية أو بالانغلاق داخل عربية مُتفاصِحة بالغة الجزالة.
إن اللغة الرّشيقة والبناء المشوّق أساسيان، لكن لا بدّ من تعزيزهما - في المنطلق - بكتابة تلفزيونية إبداعية قادرة على خلق الفرجة المطلوبة لاستقطاب جمهور المشاهدين وتوسيع قاعدته. لهذا لا يكفي أن يشتغل صاحب البرنامج بجدية في إعداد حلقاته، ولا أن يجتهد في أداء دور المُذيع المتمكّن، بل عليه أن يكون مُؤلِّفا صاحب مشروع تلفزيوني يصنعُ للفرجة. ولقد عرف المشهد التلفزيوني الثقافي العربي مشاريع صادرة عن هذا الوعي. أدرج هنا على سبيل المثال برنامج "المشّاء" الذي يقدمه الإعلامي والأديب التونسي جمال العرضاوي ويقدّم من خلاله أوتو- بورتريهات لمبدعين عرب مع تعريفٍ بحواضِرهم. يُحاورهم "المشاء" وهو يتجوّل معهم. ويُوضّح الإعلامي والكاتب التونسي حسن مرزوقي من فريق البرنامج هذا الاختيار قائلا: "خرجنا إلى الشارع والمدينة والسوق والناس. وأردنا من فكرة المشي أن يتفاعل المثقف مع محيطه ومدينته وعالمه، وربما يحاور الحجر والشجر والتاريخ"(2). ثم يضيف أنّ فكرة المشي والتجوال "تعطي إمكانات بصرية جمالية على مستوى الصورة وحركة الضيوف في الأمكنة وتنوّع الكادرات وزوايا التصوير". هذا بالضبط هو ما نسمّيه الفرجة، رغم أنّ الجوانب الفنية والتقنية فيها على أهميتها ليست حاسمة. الأهمّ في اعتقادي هو التأليف. القدرة على إبداع كتابة تلفزيونية جميلة تجدّد روح البرنامج الثقافي وتعطيه شخصية وتمنحه حيوية وتضفي عليه جانبا حكائيا دراميا يشدُّ المشاهد ويستحوذ على الجمهور.
لا بدّ من بلورة لغة إعلامية رشيقة لا تتنازل عن فصاحتها ولا تتعالى مُتفاصِحَةً على المشاهدين. فالأجدى أن نتعاون جميعا لبلورة لغةٍ قادرة على النفاذ إلى قلوب الناس وعقولهم. لغة تختلف عن لغة الكتب والأطروحات الجامعية، ولابد من تحرير الخطاب من الأجهزة المفاهيمية ولغة التخصّص والمرجعيات والإحالات والأسماء الطنانة التي يتوخّى منها البعض إبهار المشاهدين بينما هم في الواقع يعرقلون التواصل معهم ويدفعونهم دفعا إلى التبرّم من برامج الثقافة وحوارات المثقفين.
في برنامج "بيت ياسين" الذي كنت أعدّه وأقدّمه على شاشة قناة "الغد" حاولت بدوري أن أراهن على الجانب الجمالي، وأقدم كتابة تلفزيونية تمتح من الكتابة السينمائية. هكذا اخترنا فضاء البيت وتصوّرنا أن الأدباء والمفكرين والمثقفين والفنانين الذين نقدمهم للجمهور ضيوفٌ يزورون صديقا خلال يوم عطلة. ندردش قليلا، نتناول وجبة الغداء مع بعض أمام الكاميرا، نسكن إلى المكتبة قليلا حيث نشرب الشاي، ثم تنسحب الكاميرا لتترك جلستنا مستمرة متواصلة فيما يمكن اعتباره نهاية مفتوحة للبرنامج. ومنذ مشهد انتظار الضيف بالشرفة، ثم استقباله بالباب حتى نهاية البرنامج نتصرف أنا والضيف كشخصيّتين حكائيتين. لا أحد منا يحدّق في عين الكاميرا، فالبرنامج ليس برنامجا، ليس لقاء تلفزيونيا يفتتحه مذيع يخاطب المشاهدين عبر الكاميرا "سيداتي سادتي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم". فقد انصبّ اجتهادنا في التأليف على أن نُقنع المشاهد بأن الأمر لا يتعلق ببرنامج تلفزيوني حواري؛ فالبيت الذي كنا نستقبل فيه الضيوف لم يَعُد ديكورا بل صار فضاءً حكائيًّا. وطبعا يأتي دور الإخراج وحركة الكاميرا والتصوير وزواياه والتأطير ودوره في بناء اللقطات ثم المونتاج فيما بعد وغير ذلك من العناصر الفنية والتقنية لتُعزّز طابع الفرجة في البرنامج.
لكنَّ تجاربَ من هذا النوع تحتاج إمكانيات إنتاجية ليست متاحة دائما. لهذا تبقى التجارب التي تمكنت من تحقيق الفرجة من خلال المادة الثقافية في مشهدنا السمعي البصري العربي محدودة ومعدودة. وقليلا ما يُكتب لها الاستمرارية؛ لأن صبر مسؤولي القنوات على الثقافة في قنواتهم قليل، ثم إنهم سرعان ما يغلقون قوس الثقافة ليعودوا إلى "الجِدّ": إلى السياسة وأخبارها على مدار الساعة، وإلى الحوارات السياسية المتلاحقة عبر النشرات المتتالية. والحال أنه لا يمكن للبلدان العربية أن تتقدّم نحو المستقبل فقط بنخبتها السياسية؛ فالنخبة الثقافية تبقى ذات دور أساسي لأنّ المثقفين يُنتجون الأفكار التي تحرّك المجتمعات، ومن الضروري تحقيق نوع من المُصالحة بين منتجي الأفكار ببلداننا والتلفزيون الذي يبقى القناة الأكثر فعالية في مجال الترويج للأفكار وتقريبها من مدارك المواطنين. لذا فردْمُ الهوة بين المثقف والمجتمع يجب أن يُعْتَمَد هدفا مركزيا لكل القنوات الحريصة على خدمة مشاهديها وعلى استقرار بلدانها. ثم إنّ السياسة عابرة والثقافة دائمة. السياسة تفرّق فيما الثقافة توحّد. فما ضرَّ قنواتنا التلفزيونية لو استثمرت قليلا في الثقافة التي تنشغل بالأساسي الذي يشكّل وجدان الشعوب العربية. والدفاعُ عن البرامج الثقافية في التلفزيون هو دفاعٌ عن حقّنا نحن النخبة الثقافية - في زمن إدمان الإعلام على بثّ الفُرقة وإثارة النعرات - في هوامش نحاول من خلالها حراسة الوجدان وترميم المشترك.
المراجع
(1) محمد طروس، بيت ياسين: رهان الجودة في التلفزيون العربي، دار العين، القاهرة 2022، ص 17.
(2) حسن مرزوقي، المثقف والتلفزيون: عن الهوامش الثقافية والفكرية في الفضائيات العربية، كتاب جماعي، إشراف وتقديم بدّي المرابطي، منشورات ضفاف والاختلاف، بيروت 2023. ص 135.