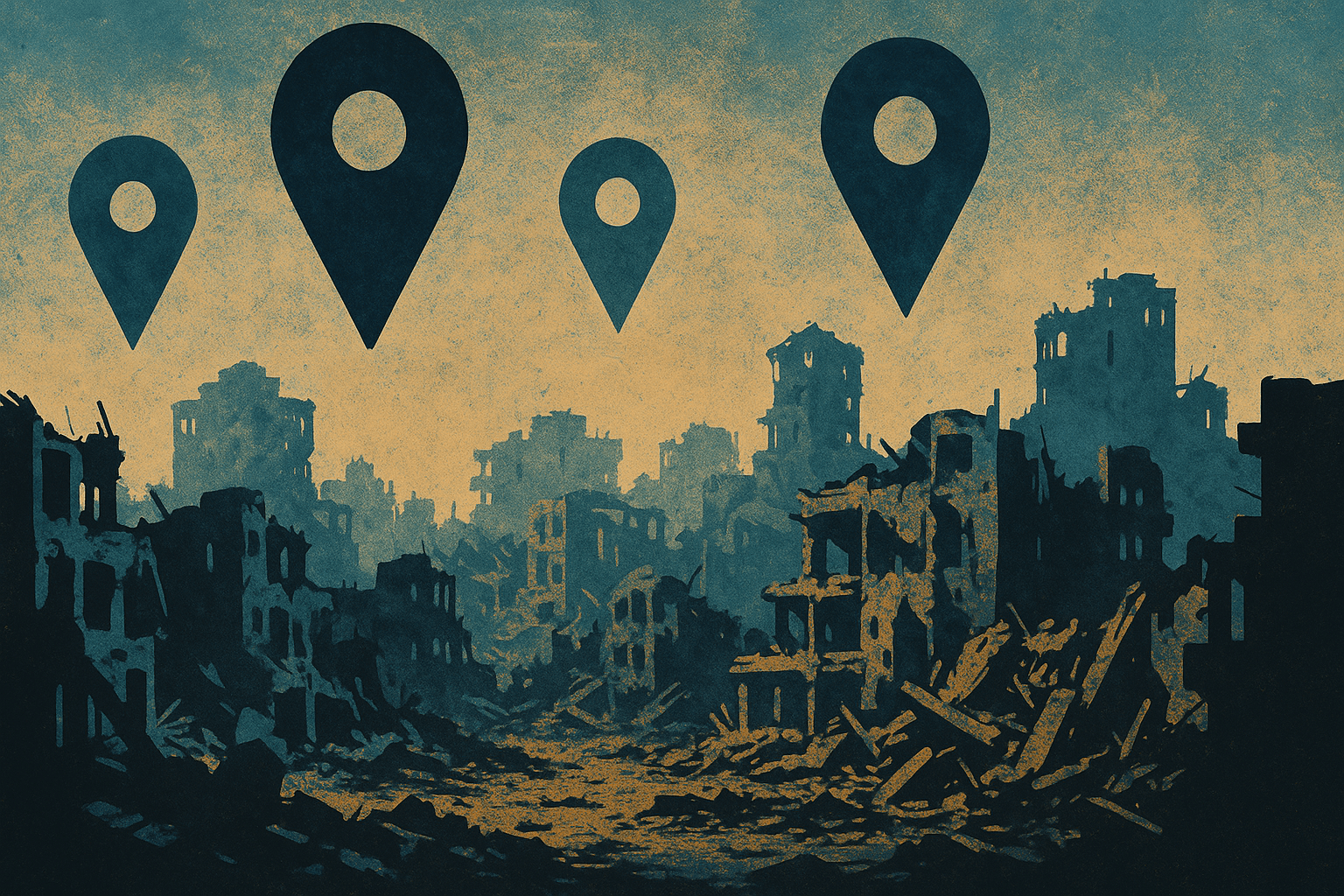ترجم بالتعاون مع نيمان ريبورتس
حدّثتني أمّي أنها ما أرادت قطّ العمل في الصحافة، وإنما امتهنتها من باب البحث عن وسيلة لدعم شغفها الموسيقي. وأخبرتني منذ عهد قريب: «لا أستطيع التباهي بأنني درست في كلية الصحافة، ولكنني شققت طريقي في هذه المهنة».
حدث ذلك في سبعينيات القرن الماضي حين عاشت أمي في مدينة نيويورك. كانت حديثة التخرج في قسم اللغة الإنجليزية من دون مهارات عملية، وشعَرَتْ آنذاك كأنها «تترنح على هاوية العدم». فما أرادت في ذلك الحين سوى امتهان العزف على الفيولا (آلة موسيقية).
أخذت أمي تلتمس شتى السبل لامتهان الموسيقى، وبحثت في أثناء ذلك عن وظيفة تقليدية، فوقعت عينها على إعلان في صحيفة نيويورك تايمز لدار نشر متواضعة؛ فيها شريكان ومحاسب. حدّثتني أمي: "لقد أرادوا ببساطة شخصا آخر في المكان، فجعلوني مساعدة تحرير في الصفحة الأولى؛ فجلّ همهم الإتيان بأناس لملء المكان".
ما كانت أمي شخصا بلا فائدة، وإنما عملت موظفة استقبال ومارست أعمالا حقيقية. بيد أنّني ذُهلت حقا من كلمتها "شخص آخر"؛ فهذه المجلة الصغيرة امتلكت الموارد لتوظيف شخص جديد حتى تكبر في عيون الآخرين؛ بل إنها وظفت شخصا غرّا ليس متحمسا ولا شغوفا بالمهنة.
أصبحت والدتي «نادين بوست» في عمر الرابعة والسبعين (الصورة)، وهي الآن من أشهر الصحفيين في قطاع البناء. لقد تقاعدت من مهنتها بعد 52 عاما، قضت جلّها في مجلة (Engineering News-Record)، حيث كتبت 4,000 قصة، منها 300 قصة غلاف للمجلة المطبوعة. وحازت أمي جوائز كثيرة لتميزها في صحافة قطاع الأعمال.
أخذت أمي تلتمس شتى السبل لامتهان الموسيقى، وبحثت في أثناء ذلك عن وظيفة تقليدية، فوقعت عينها على إعلان في صحيفة نيويورك تايمز لدار نشر متواضعة؛ فيها شريكان ومحاسب. حدّثتني أمي: "لقد أرادوا ببساطة شخصا آخر في المكان، فجعلوني مساعدة تحرير في الصفحة الأولى؛ فجلّ همهم الإتيان بأناس لملء المكان".
لو تدبرنا المشهد الإعلامي في الوقت الراهن، لكان من الهزل انضمام والدتي إلى عالم الصحافة في أيامنا؛ فقد أخبرتني أنّ الصحفيين في زمنها كانوا يعملون وقتا طويلا مقابل أجر ضئيل، وعزت بعض نجاحها إلى طبيعتها غير المتذمرة ولا المثالية (هاتان من صفاتي بزعمها). فلا شك أنّ الظروف أسوأ بكثير للأجيال اللاحقة؛ فالمراسلون الشباب يعملون اليوم مجانا، ويقترضون المال، ويصبرون على انعدام الثقة والكراهية في وسائل التواصل الاجتماعي، ويُطلب منهم إتقان تقنيات معقّدة لتقديم أسلوب يميزهم عن نظرائهم. هذه المشقة كلها في سبيل وظيفة براتب ضئيل ومتواضع، وأوقات عمل طويلة، هذا لو ابتسم لنا الحظ وحظينا بها حقا!
ولكنّنا في هذا الباب مختلفون عن والدتي؛ فمعظمنا لا يمتهن الصحافة لإشباع شغفه، وإنما نزاولها لأنّها شغفنا.
بعدما بلغت من العمر أوسَطه، كان الشغف دافعي الوحيد لتغيير مهنتي ومزاولة الصحافة. كانت لديّ وظيفة مستقرة براتب جيد ضمن منظمة بيئية غير ربحية، ولعلني برعت خلالها في طرح الأسئلة الشائكة وإثارتها، بيد أنّها لم تكن الوظيفة المنشودة. لقد انهمكت في قراءة قانون ولاية نيويورك، وغايتي توضيح جانب معين من سياسة الطاقة الشمسية، غير أنني ألفيت نفسي في متاهة من الأسئلة الفلسفية عن الإعفاءات الضريبية ورسم السياسات. ولطالما أردت التعمق في هذه المسائل، وظننتني سأبلغ مرادي بمزاولة الصحافة، بل تخيلت نفسي مثل «إيرين بروكوفيتش»؛ أتسلل وأستخرج العينات من الأحواض الملوثة.
لو تدبرنا المشهد الإعلامي في الوقت الراهن، لكان من الهزل انضمام والدتي إلى عالم الصحافة في أيامنا؛ فقد أخبرتني أنّ الصحفيين في زمنها كانوا يعملون وقتا طويلا مقابل أجر ضئيل، وعزت بعض نجاحها إلى طبيعتها غير المتذمرة ولا المثالية.
وسعني أن أتتبع شغفي لامتلاكي بعض المدخرات، ولمساندة عائلتي ودعمها في هذا المسار المهني الجديد كليا. أذكر أنني هاتفت أمي بعدما شاركت حديثا مُبكيا مع زميلة صحفية؛ إذ أخبرتني أنها هجرت المجال بعد أن تعذر حصولها على وظيفة بدوام كامل، فأحبطت لكلامها بعد حسمي قراري بالانتساب إلى كلية الدراسات العليا في الصحافة. لكنّ أمي قالت: "إذا أسعدك القرار، فهذا المهم حقا، أما المال فيأتي لاحقا".
حسنا لا أزال أنتظر قدومه! فهذه سنتي الثانية بعدما تخرجت في كلية الدراسات العليا، وأكاد أجني من المال قدرا يكفي معيشتي. إنني أعمل الآن أستاذة مساعدة في الصحافة بعقد متجدد كل فصل دراسي، وأعمل محررة بدوام جزئي، وأعمل عملا مستقلا لصالح بعض المنصات الإعلامية. ولو أنجبت طفلا، فالظاهر أنني لن أحظى بإجازة أمومة مدفوعة، فأنا أتلقى «راتبي» من عملي بدوام جزئي، فلا مزايا أنالها، ولا أمور يسعني التنبؤ بها.
لكل زملائي المستقلين ظروف وأحوال خاصة تؤهلهم الآن للعمل صحفيا، بيد أنني لما سمعت قصصهم، سعدت كثيرا لأنني حسمت قراري قبل محادثتهم، فقد رأيتهم متشككين، ومحبطين، ومثقلين بالديون، وهم إلى ذلك يعملون في وظائف أخرى ويعيشون براتب لا يكاد يكفيهم. وما يحزّ في النفس سماع بعضهم يلوم نفسه ويشكك بها.
أصدقكم القول إنّ وضعي ليس بهذا القدر من السوء؛ فلدي درجتا ماجستير، والسبل ميسرة أمامي للعثور على عمل آخر. وأحظى بدعم والديّ إن نويت شراء منزل، فدخلي المالي لا يخولني شراءه وحدي. بيد أنّ هذه الحال ينبغي ألا تُفرَض على الصحفيين الجدد ممن يريدون مزاولة هذه المهنة؛ فالصحافة لن تكون يوما المهنة المربحة، ونحن نعيش زمنا صعبا؛ فنجاة البشرية مرهونة بطرح الأسئلة الشائكة عن تغير المناخ، وسرد قصص الناس المهمشين، وإيصال الحقيقة. لذلك لا يسعنا التعويل على سيناريوهات استثنائية لتقديم صحفيين ينهضون بعبء هذه المسؤولية؛ فالأمر ليس منصفا للصحفيين المتفائلين المدفوعين بالشغف، وليس منصفا للجمهور.
قررت سؤال أترابي عن أوضاعهم، وهم على شاكلتي مؤمنون بقدرتهم على تكريس عقولهم، وقلوبهم، وبراعتهم السردية في مجال قد يصون ديمقراطيتنا من التداعي. ولكل منهم ظروف وأحوال خاصة تؤهله الآن للعمل صحفيا، بيد أنني لما سمعت قصصهم، سعدت كثيرا لأنني حسمت قراري قبل محادثتهم، فقد رأيتهم متشككين، ومحبطين، ومثقلين بالديون، وهم إلى ذلك يعملون في وظائف أخرى ويعيشون براتب لا يكاد يكفيهم. وما يحزّ في النفس سماع بعضهم يلوم نفسه ويشكك بها.
لا فرق أكانت حالتهم الوجدانية ملائمة لامتهان الصحافة أم لا -أي العمل الذي يحبونه ويبرعون فيه، والذي بات حاجة ماسة لنا- فإنهم يجسدون حال الصحفيين في وقتنا، ولكن بأي ثمن؟ وحتّى متى؟























![Palestinian journalists attempt to connect to the internet using their phones in Rafah on the southern Gaza Strip. [Said Khatib/AFP]](/sites/default/files/ajr/2025/34962UB-highres-1705225575%20Large.jpeg)