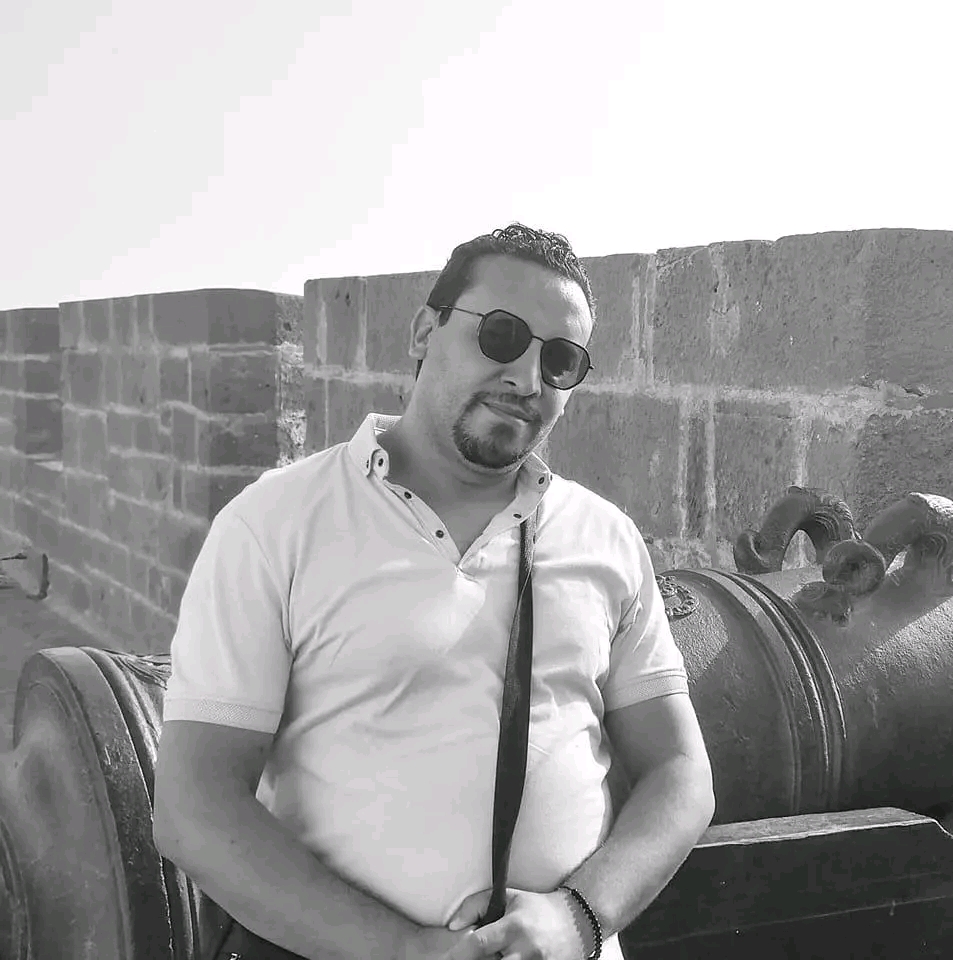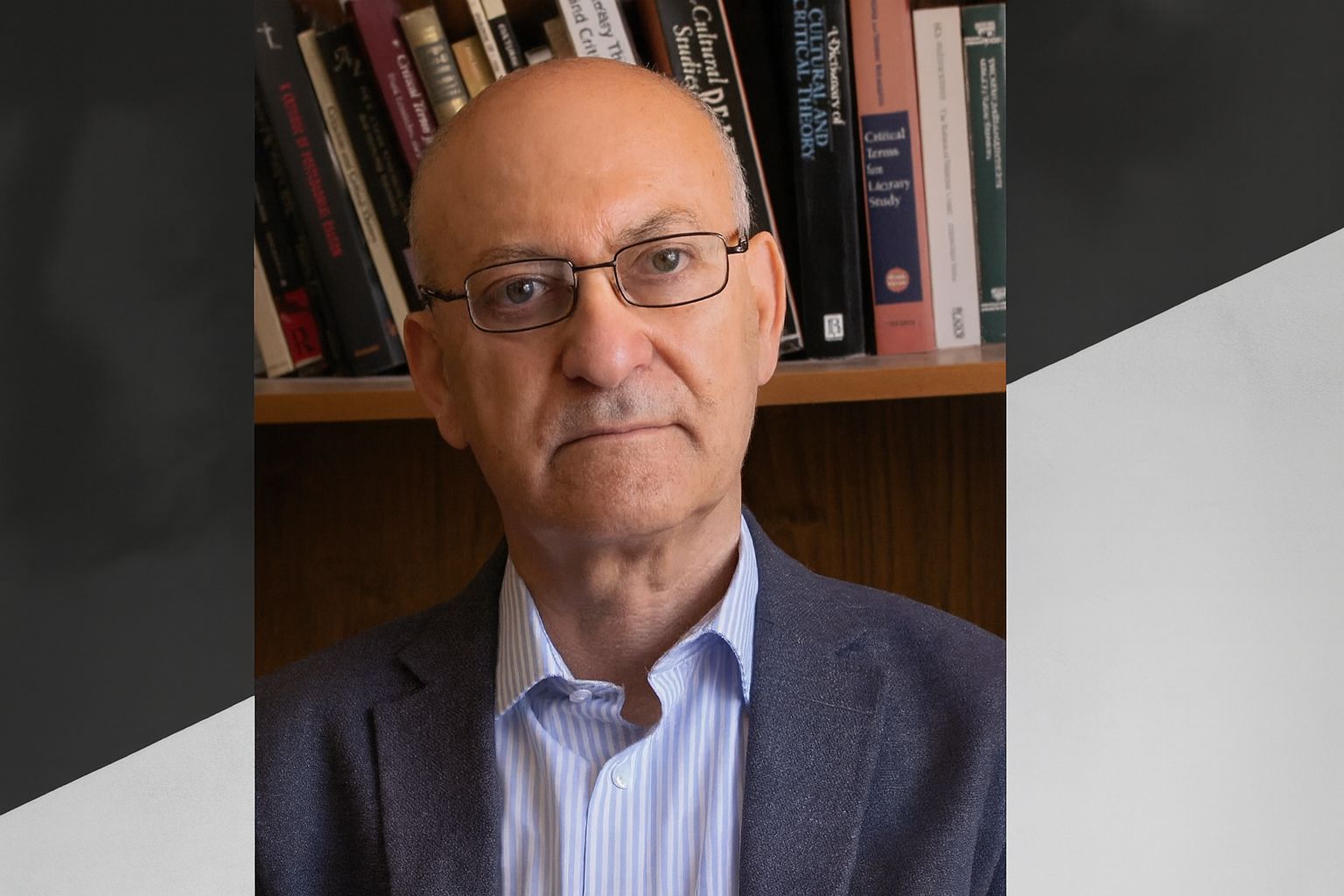مقطع فيديو مربك.. شاب يراوح العشرين يضرب ملتقط الصورة بحزامه ويصرخ بكلمات عربية بذيئة، ناعتا إياه باليهودي. التصوير المهتز ما لبث أن انتشر بقوة في الأوساط الصحفية والسياسية الألمانية في أبريل/نيسان 2018، خاصة أن أحداثه وقعت في أحد شوارع برلين، وذلك في وقت تعوّد فيه التيار اليميني الشعبوي على تحديد عناوين الخطاب العام والأجندات الإعلامية في البلاد.
ردود الأفعال كانت كما كان متوقَعا لها، فبعد اتهامهم بأسلمة أوروبا وتهديد أمنها وتكليف ألمانيا أكثر من وسعها اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، أصبح اللاجئون العرب والمسلمون يُحمَّلون مسؤولية عودة مزعومة لشبح معاداة السامية في ألمانيا -كأن البلاد قد شفيت أصلا من هذا الوباء- وأصبح الخبراء والصحفيون يعللون ذلك بأن دين الوافدين الجدد، وثقافتهم وسياسة بلدانهم الأصلية، تحمل في طياتها "الحمض النووي للجرثومة المسؤولة". وعاد السياسيون ليتسابقوا على اقتراح أفضل الإجراءات الردعية ضد اللاجئين، وصلت حدّ ربط منحهم حق اللجوء في ألمانيا بشرط اعترافهم بحق إسرائيل في الوجود.
وسط هذا الجو الذي أقل ما يمكن وصفه بأنه هستيري، كُلّفتُ بإنجاز تقرير تلفزيوني حول تداعيات الحادثة وسط العرب والمسلمين في برلين. بعد جهد، تمكنت من إقناع عضو في جمعية تعنى بمحاربة معاداة السامية وسط المهاجرين بالمشاركة في التقرير، فمعظم من اتصلت بهم قبله رفضوا الإدلاء بتصريحات، نظرا لعدم ثقتهم في الصحافة التي فقدت الكثير من براءتها في ألمانيا، وصار الكثير من العامة ينعتونها بالكاذبة. اللقاء مع الخبير كان مثمرا، فبالإضافة إلى تصريحاته الدقيقة، زودني بمعلومات وإحصائيات رسمية تفيد بأن أكثر من 90% من الاعتداءات المعادية للسامية يرتكبها اليمين المتطرف، أي من الألمان الأصليين، وأن هذا النوع من العنصرية لا يشهد انتشارا واسعا وسط المهاجرين مقارنة بانتشاره وسط الألمان الأصليين.
أثناء سيري في ما يسمى "شارع العرب" بالعاصمة برلين لرصد آراء العامة، لاحظت ما يدعم هذه الإحصاءات. فباستثناء أحد المراهقين الذي فضل التركيز على عدائه لإسرائيل وما يعانيه أهله هناك، وعجز -مع ذلك- عن الربط بين شعوره تجاه إسرائيل وحادثة برلين، ندد البقية بهذا الاعتداء بينما اكتفى أحدهم بالتشكيك في الخبر، منبها إلى كثرة الأخبار الزائفة المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي.
حتى تلك اللحظة كنت أشعر أني سأتمكن من إنجاز تقرير متوازن متمايز، يسلط الضوء على عدة زوايا مهمة من مشكل معقد دقيق مثير للعواطف، وأني سأقدم قيمة مضافة في ساحة إعلامية صارت تلهث وراء جذب الانتباه، مضحية بقيمها ودورها الأساسي في الكثير من الأحيان.
ما حصل بعد ذلك صدمني، رغم كل ما عايشته طوال سنين عديدة في مهنة المتاعب، فبعد انتهائي من إعداد النسخة الأولية تفاجأت بمحرر ألماني لا أعرفه، كُلّف بمراجعة التقرير عملا بمبدأ "العيون الأربع" المعمول به في المؤسسة، فقرر أن التقرير لا يتناسب وسرديته الشخصية التي تمثل نسخة طبق الأصل للاتجاه العام للإعلام في ألمانيا، الذي أجمع على ضرورة وضع اللاجئين في قفص الاتهام بخصوص جريمة يعرف القاصي والداني تاريخ البلاد الفظيع حيالها. تلا التشخيص الأولي صراع مرير على كل كلمة ومعلومة. رفضت إقحام مظاهرات يوم القدس التي نُظم في برلين ضمن التقرير، وأخذها كمثال على فعالية عربية معادية للسامية، ووضحت له أن مؤسس هذه الفعالية هو الزعيم الروحي الإيراني روح الله الخميني. وفي المقابل رفض هو أن يحتوي التقرير على رسم بياني يوضح أن تسعة أعشار الاعتداءات ضد اليهود في ألمانيا يرتكبها بنو جلدته، بينما فرض أن تتضمن النسخة الألمانية مقطعا يتناول يوم القدس، بالرغم من أن الشاب المعتدي على من اُعتِقدَ أنه يهودي (واتضح فيما بعد أنه عربي إسرائيلي قرر التجول في برلين مرتديا القلنسوة اليهودية لاختبار ردود أفعال الناس حسب قوله)، لا علاقة له بيوم القدس هذا.
استغرقت المعالجة عدة ساعات، محققة رقما قياسيا شخصيا في مشواري من حيث المدة. خرج كل منا خاسرا من معركة كان يفترض أن تكون تعاونا من أجل إنجاز أفضل تقرير ممكن. وربما عزّى كل منا نفسه بأنه لم يسمح للآخر بفرض روايته خالصة. وكنوع من إعادة الاعتبار لنفسي، أسقطت مظاهرات يوم القدس من النسخة العربية، وكتبت تقريرا عما حصل في شكل مقال صحفي وأرسلته إلى بعض المسؤولين.. دون أي رد فعل.
قد يقول البعض أن ما حصل يمثل انزلاقا يتيما، نتيجة موضوع شائك يثير العواطف من جانب وآخر. ويهمني للأمانة توضيح أن الحادث يمثل بالفعل انتهاكا استثنائيا من حيث جسامته لحقوقي كمحرر، في وسط تعودت على احترامه لقواعد العمل الصحفي إلى حد بعيد. كما يهمني أيضا أن يتضح أني عملت في مرات لا تحصى مع زميلات وزملاء من مختلف الجنسيات يتمتعون بالمهنية والانفتاح على الآخر، إلا أن تراكم الحالات التي يمكن اعتبارها انعكاسا سلبيا لسرديات الإعلام والثقافة والسياسة المحلية على أعمالي الموجهة للمتلقي العربي أو الدولي، تعدى بوضوح ما يمكن وصفه بالحالات الاستثنائية.
لعل أهون هذه الحالات هو إسقاط محرر ألماني لجملة صرح بها لاجئ سوري تتضمن بعض المصطلحات السياسية والاقتصادية، خشية منه أن يضر هذا التصريح بمصداقية التقرير. فاللاجئ حسب تصوره، إنسان يجب أن يكون "بائسا"، فر من ويلات الحرب والجوع والقمع والجهل، ومن غير المعقول أن يتفوه بمصطلحات لو ترجمت إلى الألمانية لعبرت عن ثقافة معتبرة للمتحدث.
الأدهى من ذلك، هي الحالات التي ترفض فيها المقترحات بدون ذكر سبب. ويتضح مع تكرار الحالات أن قاسمها المشترك يكمن في أنها تقدم سرديات تناهض الصورة النمطية التي تعود عليها المسؤولون في التخطيط، كوجوب اقتران ظاهرة الحجاب بالتشدد الديني والتمييز ضد المرأة وقمعها، مما يجعلهم لا يتحمسون لقصة مصممة أزياء متحجبة تتحدث -بثقة عالية في الذات- عن طموحها في تحقيق نجاح عالمي بشركتها المتخصصة في تصميم الأزياء المحتشمة مثلا.
لماذا اخترتُ هذه المقاربة الذاتية المعرضة للتشكيك في شرعية تمثيلها لواقع عشرات الصحفيين الناطقين بالعربية والعاملين لدى مؤسسات إعلامية غربية؟
اخترتها لأنها تتطابق مع العديد من الروايات التي أسمعها من زملاء وزميلات يعملون في خطوط التماس بين "نحن الغربيون" و"هم الشرقيون"، أو بين ما يَتفادى العَديدون قوله بصراحة "نحن المتحضرون المتنورون" (التي تشمل الكثير من الغربيين ومن تَنَوَّرَ بفضلهم من الشرقيين) و"هم غير المتنورين" الذين "لم نَتمكَّن من تنويرهم بعد".
اخترتها لأنها تعكس ثقافة إعلامية محلية، خلصت الدراسات العلمية إلى أنها تذكر الإسلام في 80% من الحالات، في سياق العنف والإرهاب والتعصب وقمع المرأة والتخلف، وتضخيم الظواهر النادرة جدا، كارتداء النقاب والبرقع في ألمانيا، لتبدو تهديدا حيويا للسلم الاجتماعي.
ونظرا لكون هذه الثقافة لا تتسرب فقط عبر محتوى النصوص المترجمة إلى العربية في الأقسام الناطقة بهذه اللغة في المؤسسات الغربية، وإنما أيضا عبر المواضيع التي يتم اختيارها طبقا لنظرية ترتيب الأولويات، فأعتقد أن دور الصحفي الناطق بالعربية يكمن في مناهضة الخطاب السلطوي في الغرب، سواء كان صريحا أو متخفيا، تماما كما يعمل على فضح ممارسات الأنظمة والبنى المجتمعية المتسلطة في المنطقة العربية. وأن يفعّل بانتظام أهمّ غريزة يتمتع بها باعتباره صحفي، ألا وهي التشكيك في المسلمات وطرح الأسئلة باستمرار.