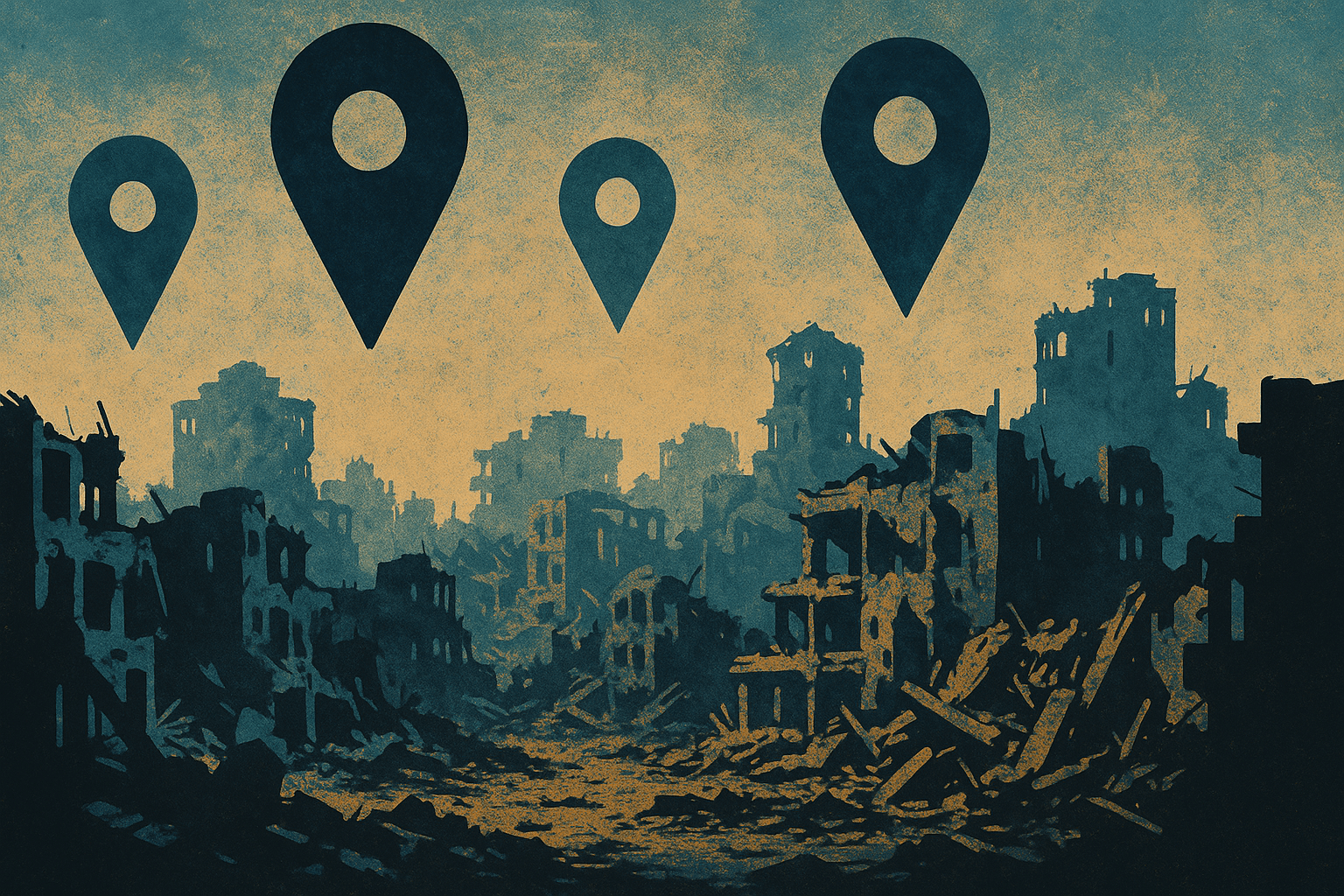جاءت المنصات الاجتماعية الرقمية بمفهوم النشر السريع للجميع، ولن ينكر أحد، إلّا المستبدون الخائفون من النقد، أفضالها الكبيرة في خلق مساحات للتعبير الحر بعيداً عن الرقابة وعن حاجة الناس لوسيلة إعلام جماهيرية حتى تصل أصواتهم. لكن كذلك، لا يظهر أن هذه المنصات فكرت في كيفية التعامل السريع مع الإشكاليات الأخلاقية ومع مسؤوليتها كأداة للنشر، خصوصاً عندما تتحوّل الكثير من المنشورات إلى أخبار كاذبة وإلى حملات كراهية.
كنت أبحث عن مقالات تحليلية تتفاعل مع ما كُشف من فضائح فيسبوك مؤخراً، وصادفت مقالاً مميزاً قبل أيام في موقع ويرد للكاتب جيلاد إديلمان (1) يتساءل فيه إذا ما بات مهماً أن تستفيد منصات التواصل الاجتماعي من تجارب وسائل الإعلام في التعامل مع قضايا أخلاقية متعددة، إذ يمكن لهذه المنصات أن تنسى التنافس بينها وبين الإعلام التقليدي في جذب الجمهور -وهو أمر تفوّقت فيه بالتأكيد منصات التواصل، بل لم يعد لكثير من وسائل الإعلام حياة خارجها- وأن تعود إلى دروس التاريخ كي تدرك أن احترام الأخلاقيات مفيد على المدى الطويل.
يخلُص الكاتب إلى ضرورة اقتناع هذه المنصات بأهمية الفصل بين "الدولة" و"الكنيسة"، ويحيل هنا على الفصل بين ما هو تجاري محض (أي أرباح هذه المنصات من الإعلانات والترويج)، وبين ما يتعلق بالتدبير اليومي لما ينشره مستخدموها، مؤكداً أن ما ينقص هذه المنصات هو "الالتزام العام بمجموعة متماسكة من المبادئ التي يمكنها حلّ النزاعات بين الضرورات المالية والمسؤولية المدنية".
أهمية هذا الاقتناع لا يمكن فرضها من خارج هذه المنصات، أي بتدخل مباشر من السلطات الثلاث، إذ يمكن للدولة الأمريكية (بما أنها تحتضن المقرات الرئيسية لهذه المنصات) أن تتدخل لأجل منع الاحتكار وكذلك عدم استغلال بيانات المستخدمين خارج القانون، لكنها لا تستطيع أن تفرض على عمالقة الإنترنت معايير أخلاقية معينة. الأمر ذاته وقع مع الصحافة في الغرب التي كان توجهها نحو اعتماد مبادئ أخلاقية، ومنها الفصل بين التحرير والإشهار، أمراً ذاتياً إلى حد كبير، بسبب ما تعطيه الدساتير المحلية من هامش كبير لحرية الرأي والتعبير.
الأخلاق ليست ترفاً
لا أتحدث هنا عن الأخلاق بمفهوم فلسفي أو حتى تربوي، بل بمفهوم يقلّل ضرر المنصات الاجتماعية. مثال: مراهقان كانا يسترقان القبل في فجوة بين سيارتين، وكانا يحاولان التأكد أن لا عين تراقبهما في طقسهما الخاص، لكن هاتفاً من إحدى النوافذ ترصّدهما ووثق لحظاتهما الحميمية بالكامل ثم نُشر الفيديو على مواقع التواصل.
حاولتُ أن ألعب دور حارس البوابة بالمعنى الإيجابي وأشعرت فيسبوك لما صادفت هذا الفيديو في قائمة الفيديوهات المقترحة (لم تكتف خوارزميات فيسبوك بنقله إلى جمهور الصفحة التي نشرته). لم أصادف الفيديو لاحقاً ولم أتوصل بتأكيد ما حول اتخاذ قرار بشأنه، ولا أدري هل سبقني مستخدم ما وقام بتبليغ فيسبوك، لكن ما أتذكره أن الفيديو تجاوز أكثر من مليون مشاهدة.
حتى ولو اتخذ فيسبوك قراراً ما بشأن الفيديو، ألن يكون متأخراً ما دام قد شوهد بهذا الحجم؟ يمكن رفع الفيديو مرة أخرى وإجراء تعديلات بسيطة عليه كي لا تتعرف عليه خوارزميات المنصة ثم يصل مرة أخرى لمليون أو أكثر قبل حذفه. الضرر يتعاظم، ففي النهاية قد تتعرف المنصة بشكل تلقائي على فيديو إباحي أو فيديو بشع لقتل إنسان وتمنعهما من الظهور، لكن الخوارزمية لن ترى في فيديو يتضمن مشاهد قد تكون أموراً عادية في الغرب، سببا لحظره تلقائياً. بل أكثر، كيف ستتعرف هذه الخوارزمية على فيديو آخر يُظهر حشداً من الناس يمنعون سيدة (وجهها ظاهر) من مغادرة أحد المنازل، بحجة أنها عاملة جنس، ويجب حضور قوات الأمن مع كل ما يتضمنه الفيديو من تشهير؟
جلّ التدخلات التي قامت بها منصات التواصل فيما يخصّ إشكاليات أخلاقية، جاءت بعد انتشار المحتوى. كيسي فيسلر، خبيرة في أخلاقيات التكنولوجيا، تؤكد في مقال على موقع فوربس (2) (موّجه لشركات التكنولوجيا الصاعدة) على ضرورة التفكير بشكل استباقي لمواجهة الخطأ، وليس انتظار حتى يقع، ثم التحرك لإصلاحه، ففي النهاية "الضرر وقع"!
تُحيل كيسي هنا على الجدل الذي رافق خوارزميات يوتيوب عندما كانت تقترح مقاطع فيديو (Suggested Videos) متشبعة بنظرية المؤامرة وبالمعلومات الكاذبة أو المبالغ فيها أو المبتورة من سياقها على متابعي المنصة التي لم تتحرك إلا بعد إشعارات كبيرة، لتقوم بتعديلات سمحت بتواري هذا المحتوى إلى الوراء مع استمرار وجوده.
ضُعف تدخل هذه المنصات جعلها أكثر من مرة منطلقاً لخطاب كراهية وصل حدّ انتهاك حقوق الإنسان كما وقع في ميانمار، عندما وثق مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان كيف أججت المنصات الاجتماعية، وخاصة فيسبوك، الكراهية ضد أقلية الروهينغا. وصرّح مسؤول أممي أن هذه المنصات كان لها "دور حاسم" في النزاع، ساهم "بشكل جوهري في مستوى حدة الصراع" (3).
مشكلة وسائل التواصل الاجتماعي أنها تعمل في مواجهة التحديات الأخلاقية كشركات صغيرة لا تجارب لها ولا مستشارين ولا ميزانيات للبحث لديها، وتحاول دائماً بناء مواقفها في السماح بالمحتوى أو حظره بعد تراكم قضايا جدلية، رغم أن المطلوب من قياديي التقنية، حسب كيسي، أن يفكروا بشكل مسبق في الفئات الضعيفة: "أنتم تعرفون أن هذا سيحدث، وجزء من مسار الشركات أن تفكر كيف ستقوم فئات "شريرة" باستخدام هذه التقنية، وبالتالي جعل هذا الأمر صعباً عليها".
لكن هل يمكن الاستفادة من الصحافة؟
في الصحافة التقليدية، من شبه المستحيل أن يُنشر مقال أو يبث خبر دون العودة إلى رئاسة أو إدارة التحرير أو على الأقل زميل آخر. خفت القيود نوعاً ما في الصحافة الرقمية، وتعددت مع هذا التخفيف انتهاكات أخلاقيات المهنة، لكن وسائل الإعلام ذات المصداقية لا تزال تعتمد على قاعدة أربع عيون إن لم يكن أكثر، قبل نشر مادة ما.
هل هذا التشاور المسبق يمكن أن ينطبق على منصات التواصل التي هي بوابات للنشر والتواصل مع العالم، لاسيما أنها هي الأخرى تحمل لفظ "ميديا" (يمكن ترجمته بوسائط الإعلام أو فقط بالإعلام)، وهو الاسم الأكثر انتشاراً لها؟
ليس بالإمكان أبداً أن تخلق هذه المنصات رقابة قبْلية وإلا فنحن لا نعيش عصر الإنترنت، فهي مفتوحة للجميع وهذا من حقهم طبعاً، كما ليس بالإمكان أبداً أن يتشبّع كل صُناع المحتوى، ومنهم من يتابعهم الملايين، بأخلاقيات الصحافة كما وردت في المواثيق ذات الصلة، ومن ثمة سيبقى إشكال النشر ثم التدخل حاضراً. لكن التحدي هنا يكمن في التدخل في حد ذاته وكيفية التعامل مع منشور ما، تبين أن فيه مشكلا أخلاقياً أو حتى قانونياً.
مثال على ذلك، وسيلة إعلامية لن تنشر مقطعاً غنائياً من معارك الراب التي وقعت بين جزائريين ومغاربة قبل مدة وتضمنت إساءات وشتائم واستباحة للأعراض وتحريضاً على العنف، لكن يوتيوب من جانبه ليس لديه مشكل في ترك هذا المحتوى، بل ليس لديه مشكل حتى في السماح في استفادته من الإعلانات، كأنها وصفة سهلة لكل من يريد نصيباً من أموال "أدسنس": اهجُ الناس كما تشتهي ولا تلق بالاً للأخلاق، وخذ ما تريد من مكاسب.
وعموماً فقرارات يوتيوب ليست جديدة، ولا يزال فيديو "براءة المسلمين" المسيء (لا يمكن وصفه بأنه فيلم) منتشراً على يوتيوب، وكل ما قامت به الشركة أن حجبته في بعض الدول الإسلامية.
منصات التواصل غالباً ما تعمل بمنطق فضفاض فيما يتعلق بحرية التعبير، وقد تسمح بمقاطع مشابهة، لكنك ستجدها حازمة جدا ضد ما تراه يهدّد الحياة العامة الأمريكية، ومن ذلك حظرها بشكل نهائي لحسابات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، عوض حذف تغريداته ومنشوراته أو حظره بشكل مؤقت، مع ما رافق ذلك من ضجة حول مدى صواب قرار الحظر النهائي.
كيف يمكن للصحفيين المساهمة؟
يربح عمالقة الإنترنت الأمريكيين المليارات، فخلال الربع الثالث من هذا العام، بلغت مبيعات شركة "ألفابيت" المالكة لـ"غوغل" و"يوتيوب"، 65.1 مليار دولار أمريكي (4) منها 53.1 مليار دولار من الإعلانات التي زادت بنسبة 41 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. مثال آخر هو فيسبوك الذي بلغت حجم مداخيله 29 مليار دولار بزيادة 35 بالمئة (5).
لكن كل هذه الإيرادات لا تنعكس على حجم العمل داخل هذه المنصات. فتقارير كثيرة تؤكد وجود نقص فادح في عدد العاملين لديها وفي كمية الضغط عليهم. منصات التواصل لا تملك مكاتب أو حتى موظفين في كل بلد، رغم ما تلتهمه من إعلانات محلية لها أثر بشكل كبير على مداخيل الصحافة، وتكتفي غالباً بمكاتب إقليمية لا تراعي التنوع الجغرافي للمستخدمين.
وهنا يبرز السؤال: هل يعرف موظفو الشركة معنى منشور مكتوب بلهجة أو لغة محلية بعيدة عنهم بآلاف الكيلومترات حتى يتخذوا القرار المناسب عندما تصلهم إشعارات تطالب بحذفه؟ كثيراً ما يفاجأ مستخدمون بحظر منشوراتهم بسبب كثرة التبليغ حتى وإن لم يكن فيها ما يخرق القانون، إذ يفترض العامل وراء الحاسوب بشكل أوتوماتيكي أن هناك خرقاً ما حتى ولو لم يعرف معنى ما كُتب!
الحل هنا ليسَ فقط توظيف تقنيين يعالجون يومياً آلاف الصور والفيديوهات والنصوص التي يتم التبليغ عنها، الحل كذلك في توظيف صحفيين بخبرات كبيرة في أخلاقيات النشر داخل كل بلد، بحيث يساعدون الشركة على فهم السياق المحلي لما ينشر في توافق مع مبادئ وأخلاقيات الصحافة كما هو معمول بها عالمياً، ويستطيعون من ناحية أخرى الوصول إلى قرارات تخصّ المحتوى الجدلي بحيث يتم التفريق بين محتوى يتم التبليغ عنه لمجرّد تصفية حسابات أو لتصادمه مع عقليات معينة، وبين محتوى مسيء فعلاً يفترض التدخل.
وأكبر ما يمكن أن يساعد عليه الصحفيون في هذه المنصات، هو التدخل فيما يخصّ نشر الأخبار الكاذبة، ليس فقط من طرف مستخدمين عاديين، منهم من يختلق خبراً ومنهم من ينشره بحسن نية، بل كذلك فيما تنشره مواقع صحفية لها جمهور كبير. إن خطر هذه الأخبار واضح، فدراسة لمجلة "ساينس" خلصت بعد فحص 126 ألف قصة خبرية بين الصحيحة والكاذبة تم تغريدها على تويتر، أن الكاذبة منها تنتشر بشكل أسرع وأوسع بين المستخدمين البشر وليس الحسابات الآلية (6).
صحيح أن فيسبوك مثلاً بدأ شراكة مع بعض المؤسسات الصحفية لفحص محتويات إخبارية رائجة والتحقق من محتواها، لكن التجربة محدودة بشكل كبير ولا تشمل كل البلدان، بل إن بعض المنصات كتويتر مثلا لا تتيح حتى خاصية التبليغ بوجود محتوى مضلّل -الخاصية متوفرة في دول قليلة- (7)، لذلك لا عجب أن تكون هذه المنصة أشهر حواضن الذباب الإلكتروني.
باختصار، منصات التواصل تجاوزت الصحافة بشكل كبير في الوصول إلى الجمهور، لكن لا ضرر في أن تستفيد منها لتجاوز إشكاليات المحتوى. الاستدراك مهم هنا أنه ليس كل محتوى على هذه المنصات هو محتوى صحفي، والاختلاف بين أنواع المحتوى أمر محمود ومرغوب فيه حتى لا يختلط التدوين واليوميات والانطباعات وغير ذلك بالصحافة المحترفة، كما لا يمكن لصحافي أن يقيّم محتوى بعيدا عن اختصاصه، لكن الحل ليس تجاهل دور الصحافة كأشهر وسيلة جماهيرية للتواصل مع الرأي العام في القرون الماضية.
على الأقل يمكن لمنصات التواصل أن تضع كرسياً بين مراقبي المحتوى لمن يمتلك خلفيات إعلامية، ليس لمزيد من الرقابة، ولكن لأجل جعل منصات التواصل أقل ضرراً، وليس بالضرورة أكثرَ إفادة!
المراجع:
1- https://www.wired.com/story/what-social-media-needs-to-learn-from-traditional-media/
3- https://time.com/5197039/un-facebook-myanmar-rohingya-violence/
4- https://www.theverge.com/2021/10/26/22747193/google-q3-2021-earnings-re…
5- https://www.cnbc.com/2021/10/25/facebook-fb-q3-earnings-report.html
6- https://www.science.org/doi/full/10.1126/science.aap9559?cookieSet=1
7- https://twitter.com/TwitterSafety/status/1427706890113495046




















![Palestinian journalists attempt to connect to the internet using their phones in Rafah on the southern Gaza Strip. [Said Khatib/AFP]](/sites/default/files/ajr/2025/34962UB-highres-1705225575%20Large.jpeg)