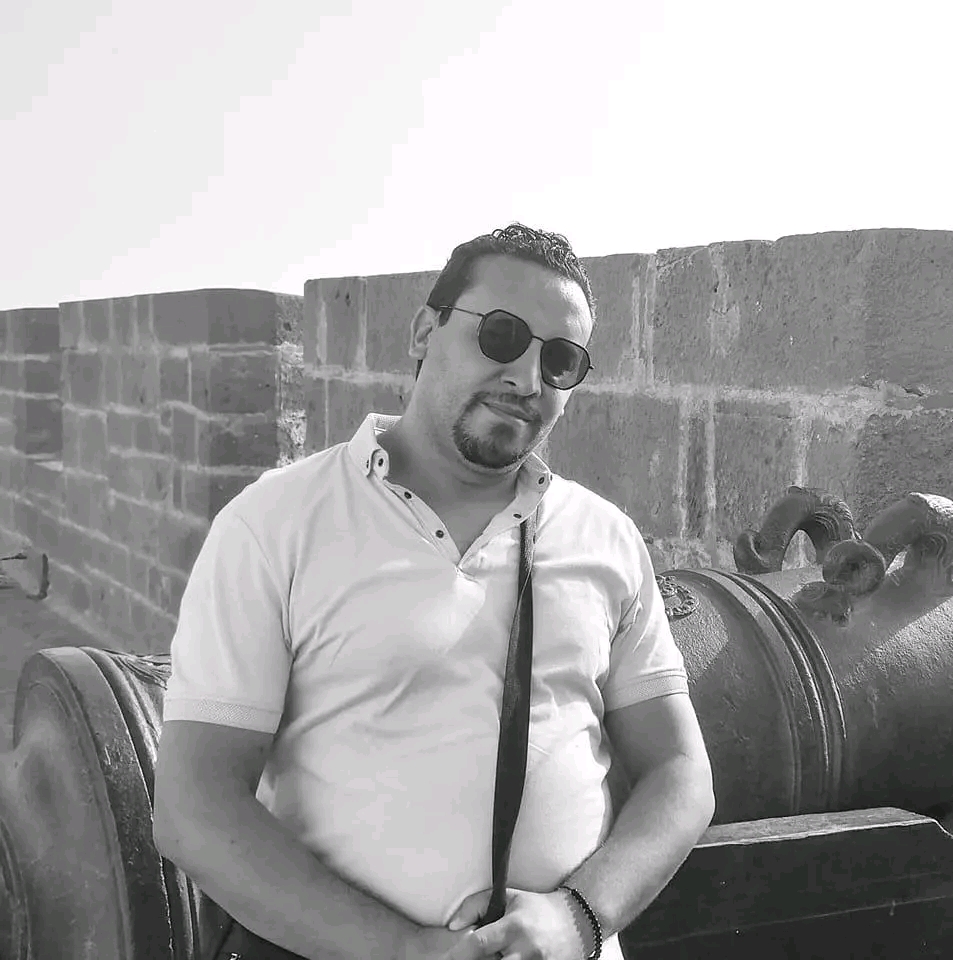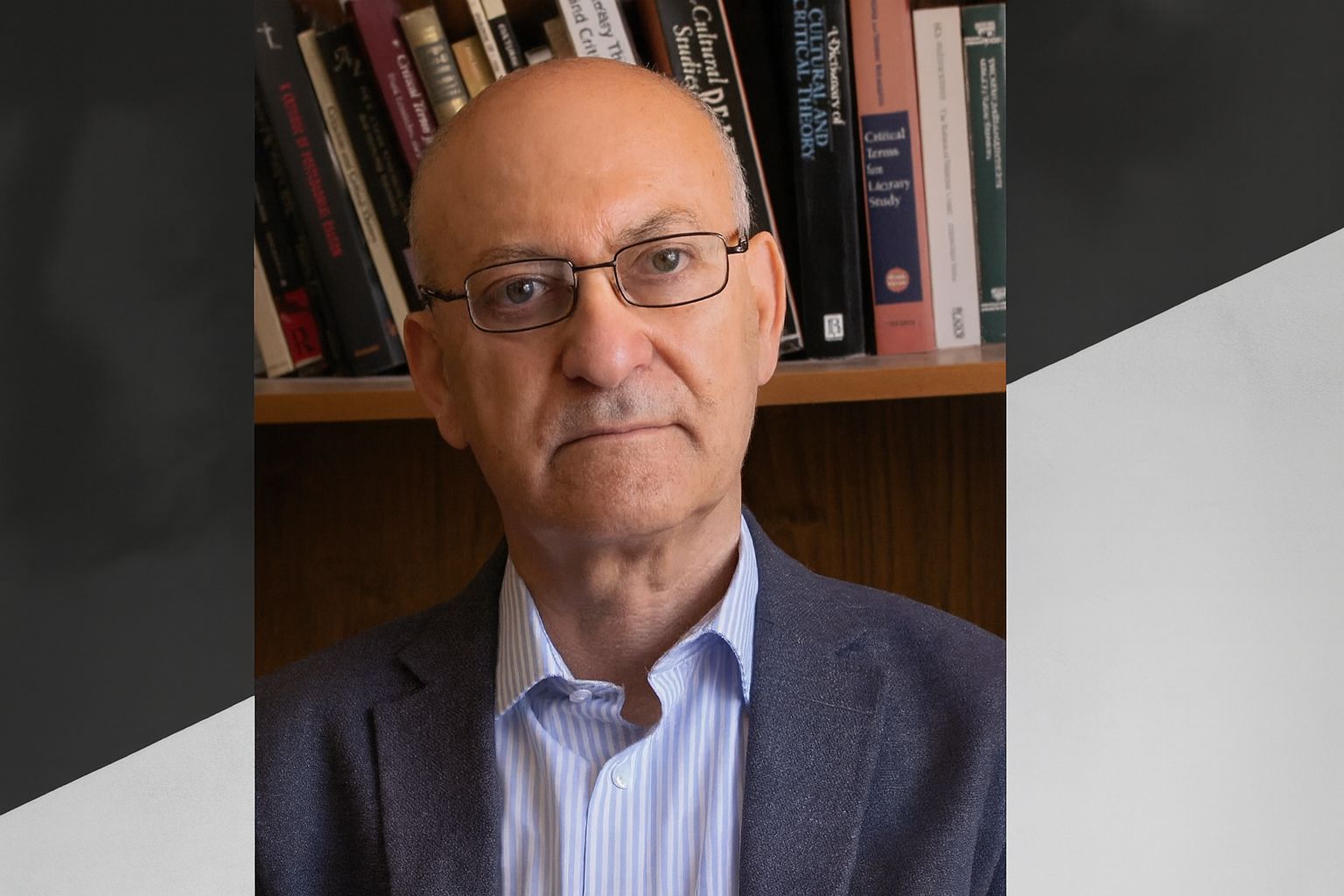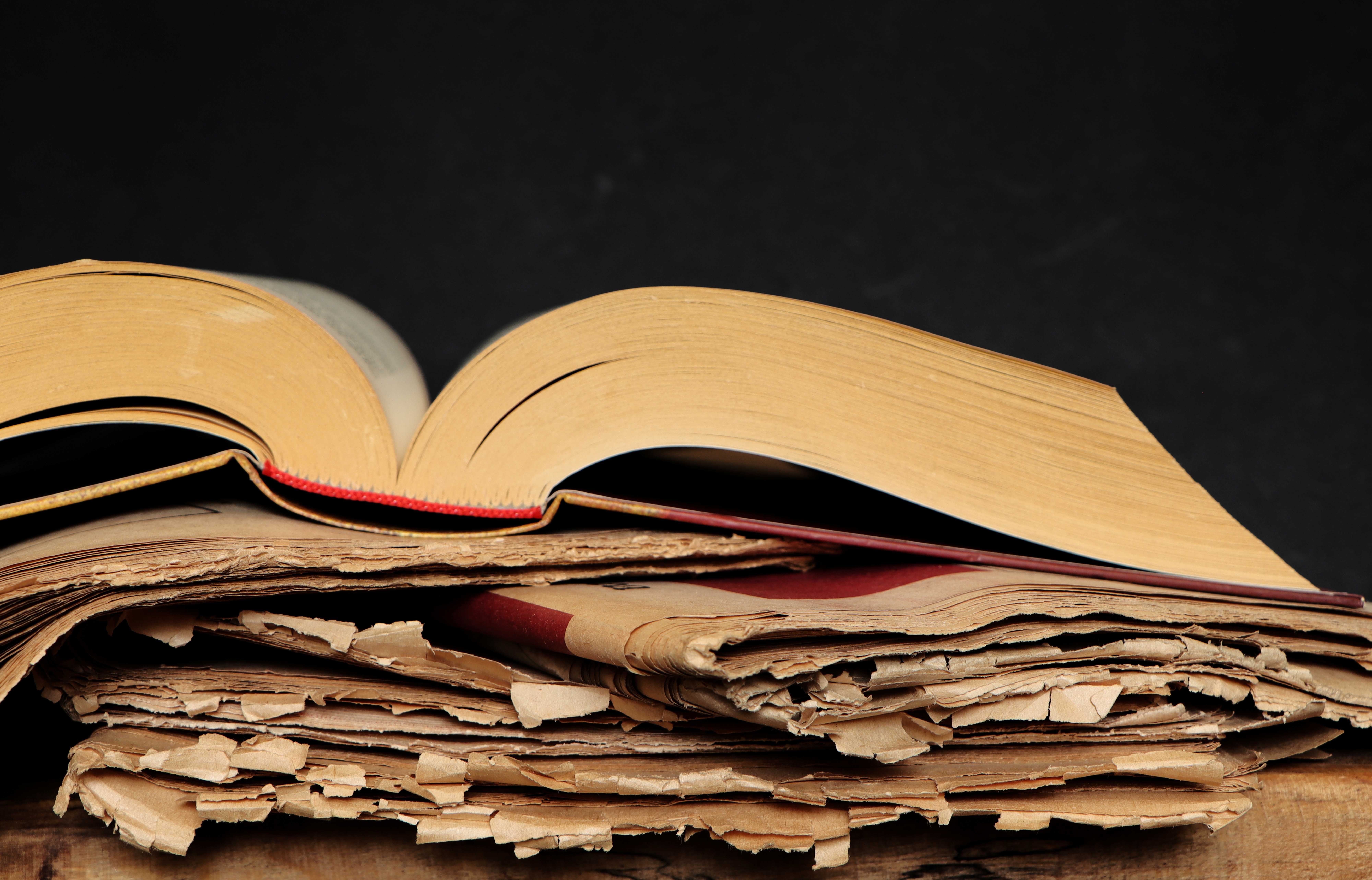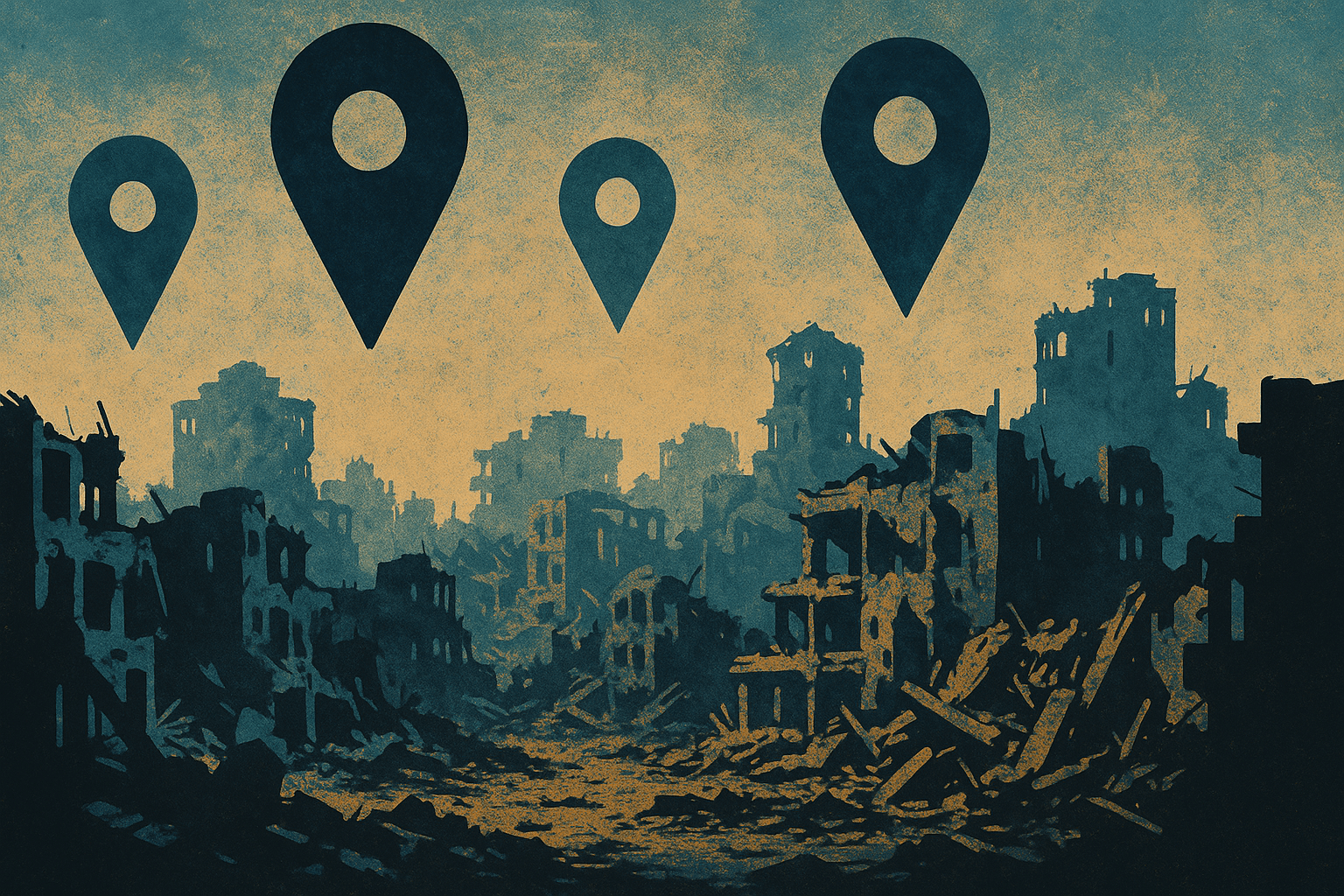إنّ العلاقة بين الصحافة والعلوم الاجتماعية تخضع لصيروة جدلية متلازمة ومستمرة في آن؛ فهي محكومة على الدوام بضرورة الغايات والوسائل، وهو ما يجعلها تتقاطع دائمًا على مستوى الأدوات التي يستثمرها الباحث والصحفي. وفي صميم هذه العلاقة تنبثق مسألة "الاقتباس" التي تشكل نقطة التقاء بينهما، بوصفها آلية إبستمولوجية، وليست مجرد عملية نقل وانتقال للمعلومات فقط، بل هي جزء أساس في فهم تطورها وتفاعلها. ومن هذا المنطلق، يحاجج هذا المقال عن "الاقتباس" بوصفه ضرورة لفهم التطورات الحاصلة في الصحافة والعلوم الاجتماعية اليوم، ومن جهة أخرى يسعى إلى إبراز محددات العلاقة، من خلال التمايزات الدلالية والمنهجية والميدانية بين الحقلين.
في طبيعة الاقتباس ودلالاته:
تحضر مسألة "الاقتباس" بوصفها آلية إبستمولوجية بين الحقول والعلوم بصفة ضرورية. ولمّا كانَ جوهر العلوم هو "الاقتباس" فإنّ الأنساق العلمية الكبرى التي تفرعت وراء أزمة العلوم الأوروبية (1) قد خضعت لهذا "الاقتباس" متأثرة بصلابة العلوم الطبيعية ومناهجها ونتائجها، هكذا تطورت العلوم الاجتماعية أيضًا، ولقد كانت فكرة "الاقتباس" مرحلة مفصلية في بنائها.
على هذا النحو، امتد نقاش وصل حد السجال بين الباحثين في حقل العلوم الاجتماعية وغيرها حول مدى التأثير الذي تمارسه هذهِ العلوم على حقول أخرى مثل: الصحافة التي تستمدُ حدودها (تعريفها) من جهةِ الممارسة فقط، هكذا في المجمل ما تخلصُ إليهِ النقاشات بينهم. (2)
لن يكونَ الجدَلُ مثمرًا في ظل أحكام مترسبة حول ما يمكنُ أن تكونَ عليه الصحافة اليوم إذا انزاحت عن وظائفها التقليدية المعهودة التي استقرت بالقوةِ والفعل، وهو ما تعجزُ عنه الرؤى المتمترسة حول "نقاء العلوم"، (3) وردّ أو ر فض فاعلية الاقتباس.
كما لن يكونَ النقاش جديرًا - في سياق المقالة - لدحض تلكَ الحجج؛ لأن التأثير والتأثر تحصيل حاصل، ويزدادُ حضوره كلّما تحرر "العقل" الإبستمولوجي من فكرة "النقاء المنهجي" ومما قد يعيق دينامية "الاقتباس". وعلى هذا الأساس، فإن قضية الصحافة والعلوم الاجتماعية من القضايا التي ينبغي النظر فيها ضمن سياق إعادة إنتاج أبنية نظرية جديدة تكتسي فيها علاقة الحقلين تواشجًا نظريًا ومنهجيًا، قياسًا على التحولات في البنى الاجتماعية وفي التحولات الرقمية اليوم.
في غمرة هذه الدعوة، ينبغي التركيز على ديناميات الاقتباس لا التماهي - كما قد يُفهم - لأن "الاقتباس" هو ما يمكّن من إعادة النظر وتقليبهِ بوصفه ممارسة ضرورية لإبراز هذه التقاطعات الحيوية المثمرة.
ولإعطاء بُعدٍ عملي لهذا التوجّه/ الدعوة فإن المناهج الاجتماعية وما تتيحهُ من أدوات، تساهم في تفسير العديد من المعطيات وتأويلها وإعادةِ إنتاجها بوصفها حقائق اجتماعية تعدُ مدخلاً حقيقيًا للاقتباس وللتعاطي النظري والمنهجي والمفاهيمي مع هذه العلاقة.
ومن هذا المنطلق؛ فإن النظر في الممارسات المهنية لمختلف الوضعيات الميدانية في عمل الصحفيين اليوم، من شأنها تفسير جملة من آليات الاقتباس التي تؤطر عملهم، وتجسدُ ذلكَ التداخل البيني بين الحقول.
إنّ عملية "الاقتباس" بين الصحافة والعلوم الاجتماعية ليست فعلاً ميكانيكيا للنقل بين الحقول، بل هي إعادة بناء وتأويل مستمر للمعرفة، حيث تتجاوز الحدود التقليدية بين العلوم؛ فالصحافة في سعيها إلى فهم الواقع وتفسيره تستفيد من أدوات البحث الاجتماعي، ولكنها تتعامل معها ضمن سياقات مرنة وقيمية تختلف عن تلك التي تهيمن على الممارسات العلمية الأكاديمية.
في ضرورة الاقتباس:
تعتمدُ الصحافة على نتائج العلوم الاجتماعية لتفسير مختلف الظواهر التي تتعاطى معها، وتلجأ في كثير من الأحيان في إطار وظيفتها "التبسيطية" وإيصال المعلومة إلى اختزال العديدِ من المفاهيم ووضعها في دائرة غير منسجمة مع دلالاتها المرادة منها، وهو ما يثير ردود فعلٍ رافضة لهذا "الاختزال"، وهذا هو جوهر الاعتراض (4) على هذهِ الممارسة، بيد أنّ هذا الاعتراض ينطلق من خلفيات تفسيرية منافية لدينامية الحقول، كما أنّ هذا التوجه يمنع من رؤية البنى الداخلية التي تفرزها الممارسة الصحفية وتسهم في إعادة قراءة ظواهر وتفسيرها بناء على نتائج أعمال صحفية بلورت إعادة إنتاج حقائق اجتماعية أو ثقافية أو غيرها.
إنّ "الاقتباس" ليسَ فعًلا "تسويغيًا" لمحاولة وضْع الصحافة داخل دينامية رمزية تعيد ترتيب ما هو أعلى وما هو أسفل، إنها هيمنة ضيقة فقط! تتأسس على ضرورتين:
- الضرورة المنهجية: تتمثل في الأدوات التي تستعمل في الإنتاج الصحفي اليوم، من سرد ومقابلات ومنهجيات التحليل الكمي والكيفي.
- الضرورة السيوسيولوجية: أصبح الحقل الصحفي ذاته مجالاً لإنتاجِ ظواهر من داخل بنيته، وهو ما جعله محلاً للدرس والتفسير والتنبؤ، وهو ما يعني أنه يفرز ويساهم في إنتاج دينامية معرفية تساهم في إغناء حقول العلوم الاجتماعية.
تشكل هذهِ الضروراتُ دلالاتٍ مركزيةً في فهم "الاقتباس" وتطوير تفاعلاتهِ أيضًا، بما يجعلُ من الصحافة حقلاً تتقاطعُ فيه المقاربات والنظريات، كما يسمحُ ذلك بإعادة إنتاجِ هذه الأدوات واختبارها بما يضمنُ ماهية الصحافة المرنة، أي تلكَ التي تخضعُ لدينامية متفاعلة بفعل السياقات والتحولات.
تعتمدُ الصحافة على نتائج العلوم الاجتماعية لتفسير مختلف الظواهر التي تتعاطى معها، وتلجأ في كثير من الأحيان في إطار وظيفتها "التبسيطية" وإيصال المعلومة إلى اختزال العديدِ من المفاهيم ووضعها في دائرة غير منسجمة مع دلالاتها المرادة منها، وهو ما يثير ردود فعلٍ رافضة لهذا "الاختزال"، وهذا هو جوهر الاعتراض على هذهِ الممارسة.
"التعقيد" وديناميات الحقلين:
لفهمِ التحولات التي تسري بينَ العلوم والحقول خاصة في العلوم الإنسانية والاجتماعية، ينبغي استحضار بُعد "التعقيد" (5)- بوصفه منهجًا مؤسسًا - في التعاطي مع موضوع الصحافة والعلوم الاجتماعية أساسًا، وعليه يتأسس أي نقاش بينهما.
إن استحضار هذا البعد يعني الانتصار للنزعة الاتصالية أو الاستمرارية ومنازعة المدرسة الانفصالية، وهو مدخل لتقويم علاقة العلوم الاجتماعية بالصحافة، بكونها جزءا لا يتجزأ من صيرورة العلوم أو على الأقل مختبرًا حيويًا لتجريب مجموع النظريات والأدوات التي تميز العلوم الاجتماعية.
لقد كان روبرت بارك (Robert Park) (6) الصحفي ومؤسس مدرسة شيكاغو للسوسيولوجيا مؤمنًا بأن "الأخبار هي شكل أولي من أشكال المعرفة؛ فهي بمثابة إعلان عن الأحداث بدلاً من تفسيرها، كما أنها [الأخبار] تُمثل معرفة (غير منهجية، حدسية، أقرب إلى الحس السليم) بدلاً من المعرفة المُعمقة بشيء ما (شكلية، تحليلية، منهجية، علمية)". (7)
من هذا الاقتباس، تأتي دعوة إعادة التصور الذي بني عن الصحافة وإعادة النظر فيه، قياسًا إلى "التعقيد". هكذا ينفتحُ منعطف آخر في طبيعة هذه العلاقة، ويعيدُ أيضا تعريف الصحفي اليوم، ليسَ بوصفه ناقلاً للمعلومة وفقط، بل فاعلاً فيها، خصوصا في ظل "سيولة" المعلومة وتدفقها؛ إذ أصبحَ بمكنةِ الجميع تلقي المعلومة وحملها، بيدَ أن الصحافي هو من يستطيع وضعها في سياقها وقراءتها وتحليلها، وهي كلها ممارسات من صميم المعرفة، لكنها معرفة مُحددة بالإطار المهني الذي يشتغلُ فيهِ الصحفي.
لقد كان روبرت بارك (Robert Park) الصحفي ومؤسس مدرسة شيكاغو للسوسيولوجيا مؤمنًا بأن "الأخبار هي شكل أولي من أشكال المعرفة؛ فهي بمثابة إعلان عن الأحداث بدلاً من تفسيرها، كما أنها تُمثل معرفة (غير منهجية، حدسية، أقرب إلى الحس السليم) بدلاً من المعرفة المُعمقة بشيء ما (شكلية، تحليلية، منهجية، علمية)".
الأدوات: اشتراك في "الفعل" لا في "الصفة":
يتطابق البحث بينَ الصحفي والباحث في العلوم الاجتماعية من جهةِ فهم الواقعِ ومحاولة تفسيره، هذا هو جوهر عمل الباحث الذي يتقصدُ "الفعل الاجتماعي" بوصفهِ "تصورًا وتمثلا" أي ظاهرة ينبغي تحليلها وتفسيرها وتأويلها، أمّا الصحفي فيوجدُ أحيانا في قلبِ الفعل والحدث الذي يُترجَم إلى: الإخبار أو التبليغ. هكذا يتمايزانِ في مقاربةِ الواقع الاجتماعي وفي النتائج أيضًا: العلوم الاجتماعية تنتجُ معرفة تراكمية، بينما تتوقف نتائج الصحافة على التأثير، وهذا بحد ذاتهِ ملمحٌ جوهري ينبغي التفكير فيه وفي مسألة العلوم الاجتماعية خاصة في السياق العربي؛ أي عن مدى تأثيرها في المجتمع.
إنّ هذا التمايز أساس لفهمِ جذور التنازع بين الصحافة والعلوم الاجتماعية، بيدَ أنّ ما هو ثابت بين الحقلين هو الاشتراك في استثمار أدوات البحث الاجتماعي، أي من حيث الاستعمال والاستثمار، وهو ما يعني على مستوى التوصيف أنهما يشتركان في "الفعل" لا في "الصفة"؛ وهكذا نجد الإنتاجات والمحتويات الصحفية تستثمر الأدوات الاجتماعية في معالجة العديدِ من الظواهر مثل استعمال المقابلات والملاحظة والسرد الاجتماعي والأنثربولوجي في القصة الصحفية الإنسانية وتحليل الوثائق ... وغيرها من الأدوات التي تسعف الصحافي في أداء عملهِ بعمق وبتأثير.
لا تُغيّب مسألةُ استعمال الأدوات الاجتماعية سواء في الصحافة أو العلوم الاجتماعية ما يصطلح عليه بـ"سلطة المنهج"؛ فالضرورة الإبستمولوجية والمنهجية تقتضي منَ الباحث التقيد بالأدوات المستعملة في البحث، وهو ما يضعه في امتحانٍ صعب حدَّ التناقض أمامَ الظواهر الاجتماعية التي قد تنفلتُ من "سلطة المنهج"، إلاّ أنّ الأداة في الاستعمال الصحفي تخضعُ لمحددات مرنة - نسبيًا - ومن جهة أخرى تخضع لإطار وتحديد مسبق (الخط التحريري، الضغوط السياسية والإكراهات الاقتصادية، الإكراه الزمني) فالشرطُ هنا معياري وليسَ قيمي، إذ يظل الأول مقرونًا ورهينًا بالصحافة، بينما الثاني هو مُحدد ملازم لماهية العلوم الاجتماعية.
يتطابق البحث بين الصحفي والباحث في العلوم الاجتماعية من جهة فهم الواقع ومحاولة تفسيره، هذا هو جوهر عمل الباحث الذي يتقصد "الفعل الاجتماعي" بوصفه "تصورًا وتمثلا" أي ظاهرة ينبغي تحليلها وتفسيرها وتأويلها، أمّا الصحفي فيوجدُ أحيانا في قلبِ الفعل والحدث الذي يُترجَم إلى: الإخبار أو التبليغ. هكذا يتمايزان في مقاربة الواقع الاجتماعي وفي النتائج أيضًا.
خاتمة:
إنّ عملية "الاقتباس" بين الصحافة والعلوم الاجتماعية ليست فعلاً ميكانيكيا للنقل بين الحقول، بل هي إعادة بناء وتأويل مستمر للمعرفة، حيث تتجاوز الحدود التقليدية بين العلوم؛ فالصحافة في سعيها إلى فهم الواقع وتفسيره تستفيد من أدوات البحث الاجتماعي، ولكنها تتعامل معها ضمن سياقات مرنة وقيمية تختلف عن تلك التي تهيمن على الممارسات العلمية الأكاديمية.
وبينما تسعى العلوم الاجتماعية إلى بناء معرفة تراكمية معمقة، تهدف الصحافة إلى التأثير الفوري وإيصال المعلومة للجمهور، مما يعكس التفاوت في النتائج بين الحقلين، إلا أنّ هذا التفاوت لا يمنع من التفاعل البيني المثمر. وبناءً عليه، يمكننا القول إنّ "الاقتباس" بين الحقلين يعكس حقيقة حيوية هي أن المعرفة تتطور وتتوسع عبر التفاعل المتبادل بين الحقول، وهو ما يسهم في إغناء كل منهما بشكل مستمر، ويعكس ضرورة التفكير النقدي في استثمار الأدوات المعرفية المشتركة وفي العلاقة بين الحقلين أيضا.
المراجع:
- يتناول الفيلسوف الألماني إدموند هوسرل (Edmound Husserl)، في كتابه: أزمة العلوم الأوروبية والفينومينولوجيا الترنسدنتالية. الأزمة التي يمر بها الفكر الأوروبي المعاصر، من خلال تحليله لتراجع دور العلوم الطبيعية في فهم المعنى الحقيقي للوجود الإنساني، حيث عبر عن قلقه من أن العلوم الحديثة قد تبتعد عن أسئلة المعنى والحقيقة الوجودية، متأثرة بالمادية والتقليدية.
- Bastin, Gilles. “Le journalisme et les sciences sociales. Trouble ou problème?” Sur le journalisme 5, no. 2 (2016).
- Bastin, “Le journalisme et les sciences sociales,” 48.
- Bastin, “Le journalisme et les sciences sociales,” 53.
- Morin, Edgar. Introduction à la pensée complexe. Paris: Points Essais, 2014.
- روبرت بارك، من أشد المدافعين عن الإطار المؤسساتي للصحافة الاجتماعية، فالصحافة وفقا لمنظوره، تساعد في تحقيق التوازن بين الأفراد والمؤسسات، طبق نظرية النسقية في الصحافة، ويرى أن الإعلام جزء من النظام الاجتماعي الأكبر، ويعمل كوسيط يربط بين مختلف مكونات المجتمع. وقد بدأ حياته المهنية كصحفي ثم مدرسا للفلسفة وعلم الاجتماع، في جامعة هارفارد، لمزيد من التفاصيل حول نظريته، العودة إلى كتاب الصحفي والسوسيولوجي، الذي نشر بالفرنسية في عام 2008، وقدم له إيدوي بلينيل: https://www.sa-autrement.com/livre/9782020970976-le-journaliste-et-le-sociologue-robert-e-park/
- Weaver, David H., and Maxwell E. McCombs. “Journalism and Social Science: A New Relationship?” The Public Opinion Quarterly 44, no. 4 (1980): 485.


















![Palestinian journalists attempt to connect to the internet using their phones in Rafah on the southern Gaza Strip. [Said Khatib/AFP]](/sites/default/files/ajr/2025/34962UB-highres-1705225575%20Large.jpeg)