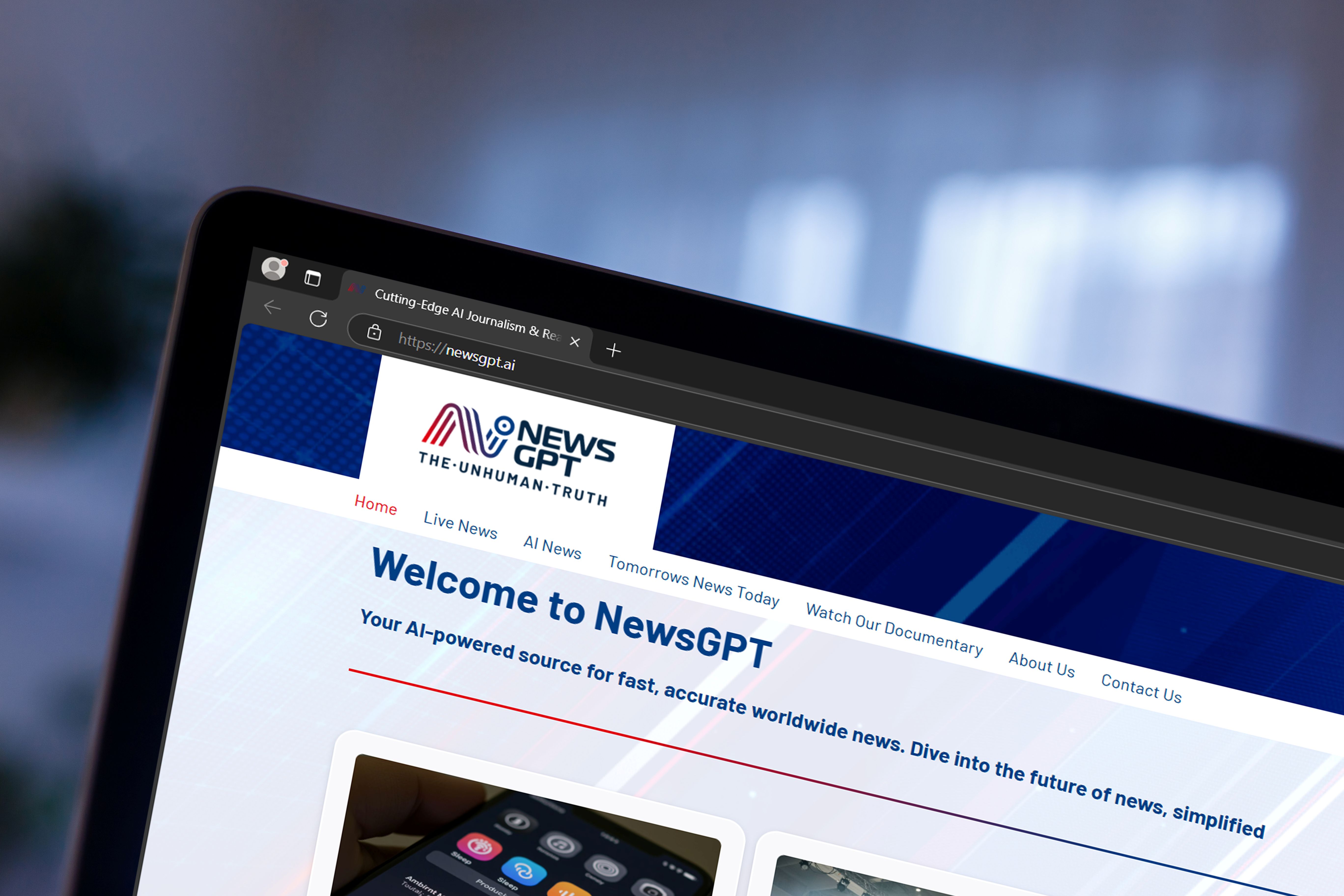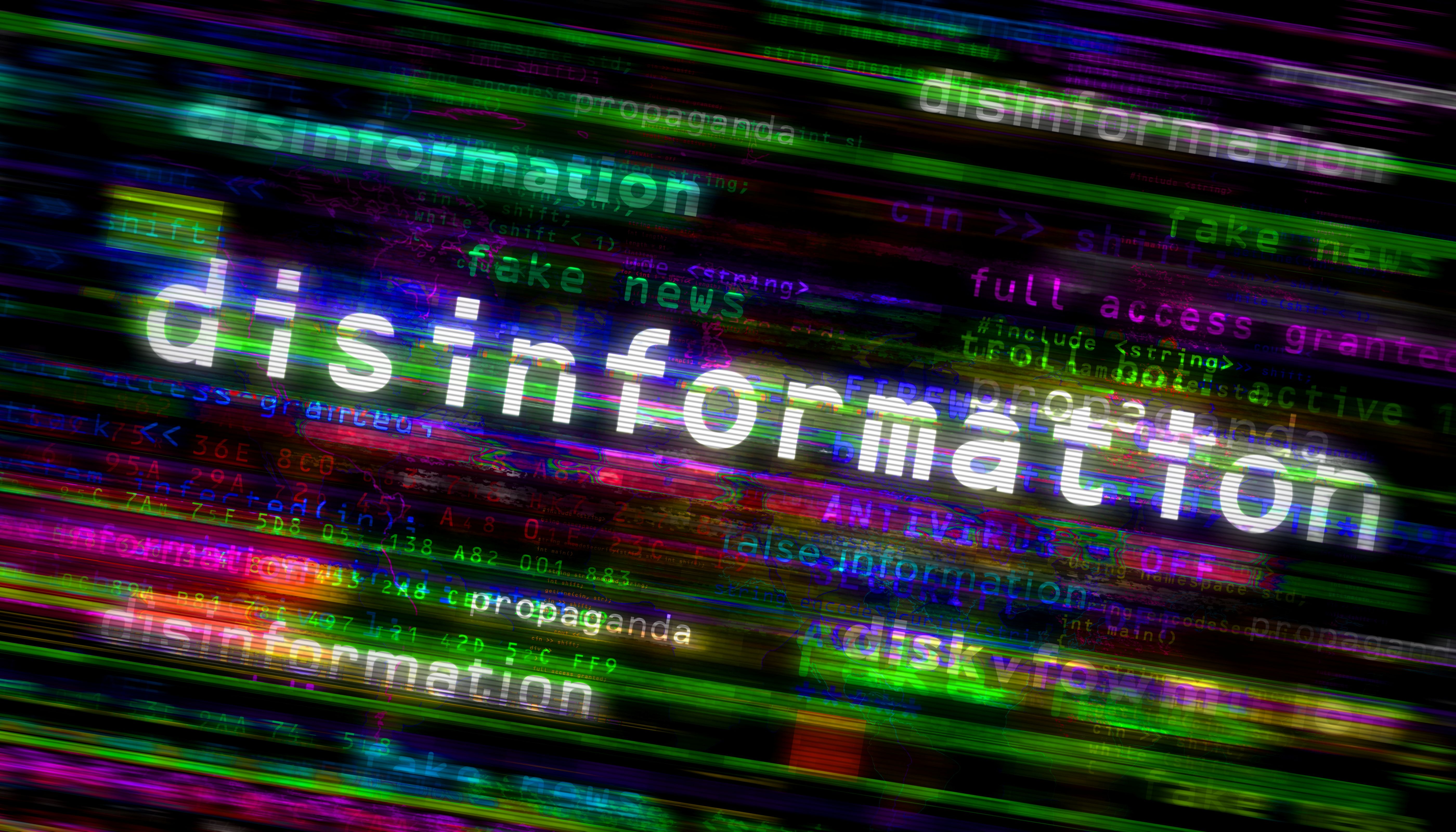كان يوما ربيعيا أواخر أبريل/نيسان 2011، حين هبطت بنا الطائرة في مطار بنينا العسكري قرب مدينة بنغازي شرق ليبيا، هذا البلد العربي الذي قرر شعبُه خوض مغامرة خطرة عنوانها "الشعب مقابل الدكتاتور". لم تكن تجربتي الأولى في تغطية الحروب والمعارك، لكنها كانت تجربة مختلفة بكل تفاصيلها منذ بداية إرهاصاتها.. بدأ ذلك عندما استقبلني ذلك الثائر المسلح عند باب الطائرة، وبعد نظرة سريعة بين جواز سفري ووجهي، استلَّ من جيبه ختما خشبيا صنع على عجل ومَهَر به الجواز، لتظهر دمغة حبرية كبيرة كتب في وسطها عبارة "أهلا بكم في ليبيا الجديدة". وسيبقى ذلك الختم ينغص علي كل تحركاتي، إذ كان بمثابة تهمة تثير الشكوك أينما ذهبت سواء في ليبيا أو خارجها.
في الطريق من مطار بنينا إلى فندق تبيستي في بنغازي، كان كل شيء يشي بأن ثورة عارمة وغاضبة خرجت من قمقمها دفعة واحدة ودون مقدمات. الشعارات على الجدران، الشباب المسلحون بالكلاشنيكوف، تعابير الوجوه الفائضة بالتحدي والتمرد، كل ذلك جعل فكرة متطرفة تقفز إلى واجهة ذهني، كيف سأكون حياديا هذه المرة؟ وإلى أي حدِّ بإمكاني كبح نفسي عن التواطؤ مع هؤلاء الفتية المسلحين؟ وكيف سأوفِّق بين هذا التواطؤ الداخلي كإنسانٍ، وبين فكرة الحياد على الصعيد المهني؟
أمضيت ذلك المساء وليلته في الفندق أقرأ عن السياسة والتاريخ والاقتصاد والمجتمع في ليبيا.. ليبيا التي تُمزِّق ثوبها وتحاول التغيير. لم أكن أعرف أني سأتعلم درسا قاسيا جدا في الحيادية، درسا سيبقى عالقا في تجربتي كذكرى اعتراضية ثقيلة الوزن.
كانت مدينة البريقة غرب بنغازي أشبه بعنوان للمرحلة، إذ باتت مسرحا للعمليات بين ثوار 17 فبراير وبين كتائب القذافي. فبعد الحسم الذي حقَّقه الثوار في مدينة أجدابيا، جسدت البريقة مرحلة المراوحة في المكان، فمرَّة تقع أجزاء منها بيد الثوار، ومرة تستعيدها كتائب القذافي. وكصحفيين كنا نعمل مع وسائل إعلام اعتبرتها كتائب القذافي معاديةً ورصدت جوائر مالية لمن يقطف رؤوسنا، وبات لزاما علينا الحذر أكثر. مع ذلك، لم أستطع مقاومة فكرة الذهاب إلى مقهى الشاهي في المدينة (والشاهي هو الاسم الذي يطلقه الليبيون على الشاي). كان يُدير هذا المقهى شابٌّ ليبي قليل الكلام وكثير التدقيق في وجوه الناس، يدعى فوزي.
كان فوزي شخصية مغرية بذلتُ الجهد الوفير لتسلّق أسوارها قبل أن نصبح أصدقاء، لكن بحذر ثنائي متبادل، فلم يكن الصحفي بداخلي مستعدا للوثوق بأحد، بينما كان فوزي -كأغلب مشرقيي ليبيا- يتوجس من الغرباء مثلي، فما بالك بصحفي أجنبي في تلك الأيام العصيبة؟!
كان مقهى الشاهي يلعب لعبة الحرب نفسها، تارة يحتضن الثوار وأحاديثهم عن الحرية وليبيا الجديدة، وتارة يكون بيد كتائب القذافي ونظريَّاتهم عن المؤامرة الكبرى ضدَّ العقيد والبلاد والليبيين. كان فوزي يلعب اللعبة ذاتها بين الطرفين، لعبة الحيادية الخطرة.
سألته ذات مساء:
- كيف تتعامل مع كتائب القذافي؟
بهدوء ودون تفكير قال: مثلما أتعامل مع الثوار، أو مثلما أتعامل معك أنت، لا فرق لديَّ سوى أن الكتائب تحبُّ الشاهي الأخضر باللوز، بينما يفضِّله الثوار أخضر دون لوز.
كصحفيٍّ أُعجبت كثيرا بكلام فوزي وأحسست أنه صحفي بالفطرة، باغتُّه بالسؤال:
- لماذا تمارس كل هذه الحيادية؟
- فقط كي أبقى على قيد الحياة، لدي عائلة وطفلان.
دون مقدمات، رفعت سقف المكاشفة مع فوزي وسألته:
- مع من تقف، مع الثورة والتغيير أم مع القذافي وكتائبه؟
بدا لي فوزي حينها يفكِّر بعمق قبل أن يقول: أنا متعاطف مع الثورة والثوار، لكني لست على علاقة سيئة مع الكتائب، فأنا أقدم الشاهي للجميع وغير معنيٍّ بأفكارهم السياسية وتصرفاتهم.
خضتُ نقاشا طويلا مع فوزي بشأن الحيادية، وكان بدوره يبذل جهدا كبيرا لإثبات أن الحيادية ليست مجرد صحافة والتزام ومهنية، بقدر ما هي وسيلة حماية ودرع ضد الموت بين بنادق تتصارع. ختم فوزي أطروحته بالتعبير عن اعتقاده بأن الحيادية جعلت منه شخصا مقبولا لدى الجميع، فلا هو صديق لأحد، ولا أحد يعامله كعدو، فهو فوزي صاحب مقهى الشاهي الذي يقدم الشاي للجميع.
كنت معجبا بفوزي، وزاد إعجابي به ذات مساء حين فرد ذاكرته وفرش ثقافته الواسعة عن الشاهي. راح يقص عليَّ قصة ليبيا والليبيين مع الشاي.. أخبرني كيف دخل الشاي ليبيا بين فترتي العثمانيين والاستعمار الإيطالي، وكيف كان عيبا على الليبيين شرب الشاي شأنه شأن التدخين والخمر، وكيف تقبَّل الليبيون الشاي خطوة خطوة حين سمحوا بشربه للرجال فقط بينما حرمت منه النساء، وكيف انتصر الشاي في معركته النهائية مع الليبيِّين ودخل كل بيوتهم، بل وتربع على عرش ثقافتهم وعاداتهم حتى بات جزءا من ثقافتهم اليومية وأهازيجهم الشعبية التي تتغنى بأنواعه وطرق تحضيره.
كان فوزي، مثقفا جدا في مهنته، يحفظ كل الأشعار الشعبية والرسمية التي تتغزل بالشاهي أو تلك التي تذمه. كان حياديا في كل شيء تقريبا حتى في شعره عن الشاهي.
عرف فوزي بتواطئي الداخلي مع الثورة، لكنه كان يشاهد حيادية صارمة في كل ما أنقله من أخبار وتقارير.. سألني مرة: كيف أوفق بين هذا وذاك؟ وكيف أبرر ما كان يسميه انفصاما في الشخصية المهنية ومعركة بين إنسان يستطيع وبسهولة التمييز بين الحق والباطل، وبين شيطانه الصحفي الذي يمنعه من قول ذلك علانية؟ كان يوم الأربعاء من شهر مايو/أيار، حين أعلن الثوار سيطرتهم الكاملة وللمرة الأخيرة على البريقة بعد معارك استمرت أياما. كانت سعادتي كبيرة لأني رغبت في لقاء فوزي والجلوس في مقهاه وشرب الشاهي الذي يصنعه. جلست على ذات المقعد الذي تعودت الجلوس عليه في مقهى الشاهي، قبل أن يباغتني صوت فتى صغير:
- أي نوع من الشاهي تريد؟
وبعد أن تفحص وجهي جيدا وتقاسيم الدهشة عليه، قال لي غيرَ مبالٍ:
- إن كنت تنتظر فوزي فهو لن يأتي.. لقد قتلوه. قتلته الكتائب قبل انسحابها نهائيا من هنا، قتلته على مرأى من الثوار الذين لم يفعلوا شيئا.. لقد تركوه يموت.
كانت جملته الأخيرة أشبه بمصيدة لصحفي مثلي دفعتني قبل مغادرتي ليبيا إلى سؤال قائد تلك المعركة:
- لماذا لم يتحرك الثوار حين قتلت الكتائب فوزي؟
- ولماذا نساعده أصلا؟ كنا نشك فيه دائما، ولو لم تقتله الكتائب لفعل الثوار ذلك.. فوزي كان شخصية إشكالية تبعث على الشك والريبة.. لقد كان حياديا.
كانت الطائرة تقلع بنا من مطار بنينا العسكري لنعود من حيث أتينا، وكنتُ حينها مشبعا بتساؤل لم أجد له جوابا حتى اللحظة:
لماذا قُتل فوزي إن كان حياديا؟
ولماذا بقيت أنا على قيد الحياة بوجود ألف دليل على أني أمارس الحيادية؟
ومن كان أكثر صدقا في حياديته، أنا أم فوزي؟