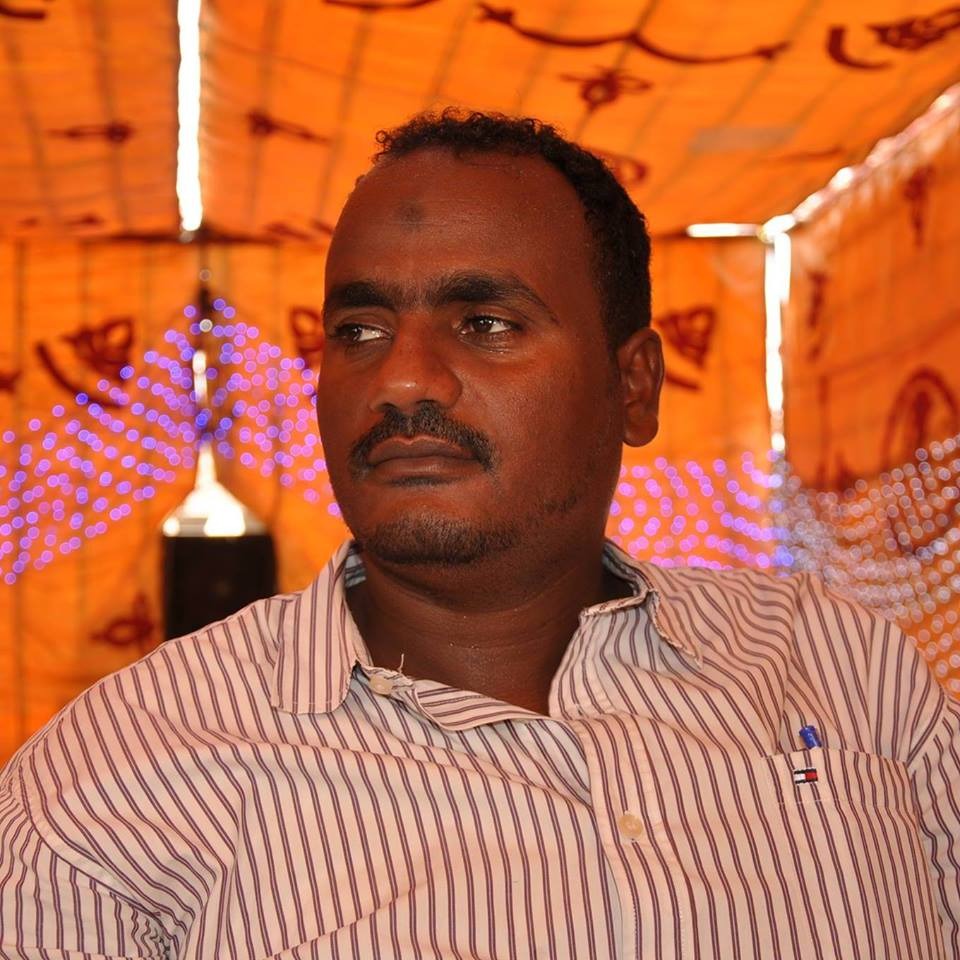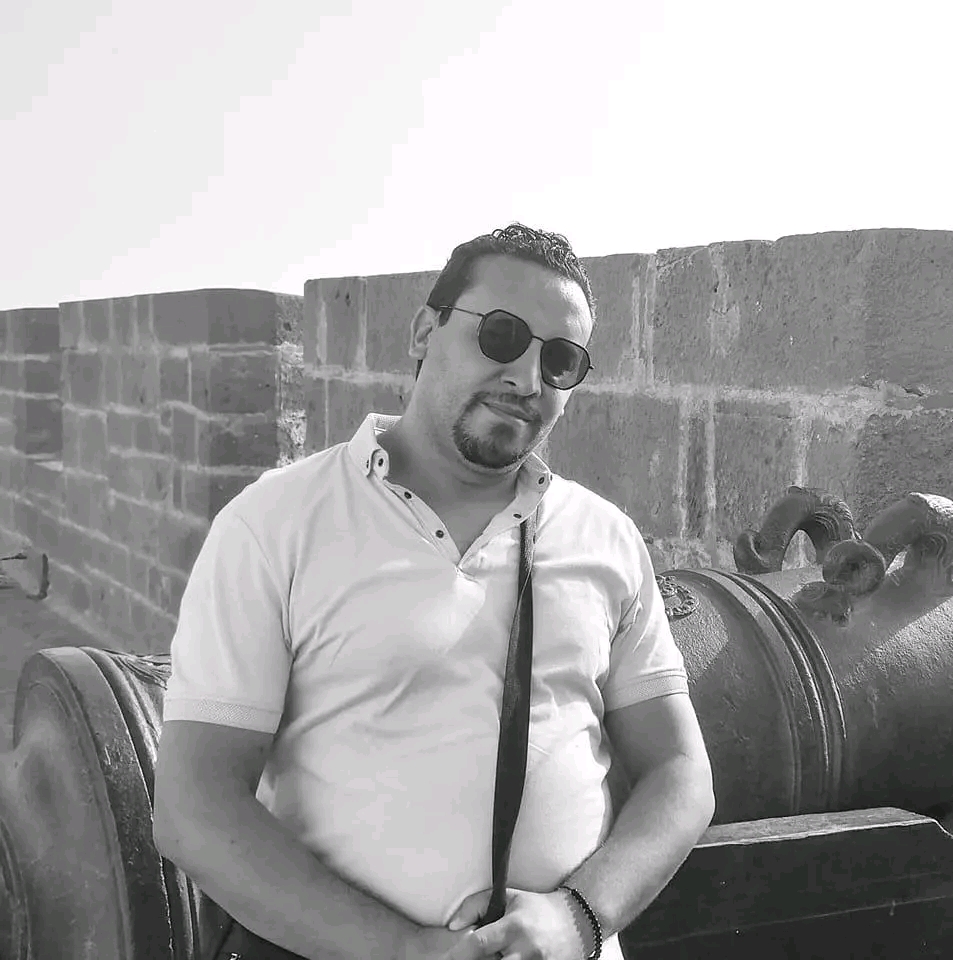خلال السنواتِ العشرِ الماضية، وجد الصحفي السوري نفسه أمام خيارينِ لا يقل أحدهما صعوبةً عن الآخر، فإما البقاء في الميدان بما يحمله من اعتقالٍ وتصفياتٍ وملاحقات أمنية وأخطار ميدانية، أو الخروج إلى المنفى حيث الغربةُ التي لا تقل قسوةً عن الرصاص.
هكذا عاش الصحفيون السوريون ضمن معادلةٍ صعبة ليدفعوا ثمناً باهظاً من حياتهم ومهنتهم وهويتهم في سبيل الاستمرار. وفي ظلِّ نظامٍ ديكتاتوري حوّل الصحافة إلى أداةِ دعاية تخدم سلطته، أصبح الصحفي المستقل عدواً مباشراً يُستهدف بالإقصاء أو النفي. ومع سقوط نظام الأسد في نهاية عام 2024 برزت أسئلةٌ جديدة وملحّة: هل انتهت مرحلةُ التضييق على الصحافة السورية فعلاً؟ هل تغيّر المشهد فعلاً أم أن المعاناة ما زالت تلاحق مهنة الحقيقة؟
المنفى فقدان للهوية
مع اندلاع الثورة السورية عام 2011، أدرك الكثير من الصحفيين السوريين أنهم يعملون في أكثر البيئاتِ عداءً للصحافة والمهنة من خلال التهديدِ المباشر والملاحقاتِ الأمنية والاعتقالات والرقابةِ المحكمة على القلمِ الحر والصورةِ كذلك، وهو ما دفع غالبيتهم إلى الهجرة خصوصاً أنّ خيار البقاء كان أقرب إلى الانتحار المهني أو الشخصي، فكانت الهجرة القسرية هي الخيار المحتوم وليس بحثا عن فرصة أفضل.
لم يكن المنفى - سواء في أوروبا أو في دولِ الجوار - حلاً فعالا للصحفي السوري؛ فالهجرة إلى أوروبا التي بدت في البداية ملاذاً يضمن حرية التعبير ويوفر حمايةً قانونية، كشفتَ سريعاً عن تحدياتٍ يومية تتعلقُ بلغةٍ جديدة، وإجراءاتٍ بيروقراطية معقدة، وصعوباتٍ في الاندماج داخلَ بيئات إعلامية مختلفة. في المقابل، وجد الصحفيون الذين لجؤوا إلى المنافي الإقليمية أنفسهم أمامَ واقع لا يقل قسوة؛ إذ واجهوا تضييقاً سياسيا وضغوطاً أمنية تحدّ من حركتهم، إضافة إلى هشاشة الوضع القانوني الذي يجعل عملهم عرضة للتقييد أو الإيقاف.
لم يكن المنفى حلاً فعالا للصحفي السوري؛ فالهجرةُ إلى أوروبا التي بدت في البداية ملاذاً يضمن حريةَ التعبير ويوفر حمايةً قانونية، كشفتَ سريعاً عن تحدياتٍ يومية تتعلقُ بلغةٍ جديدة، وإجراءاتٍ بيروقراطية معقدة، وصعوباتٍ في الاندماج داخلَ بيئات إعلامية مختلفة.
أمام هذه التبدلات، سادت معاناة مشتركة تتمثل في فقدانِ الميدان الذي شكّل هوية الصحفي الأساسية؛ فالصحفي الذي كان يعيشُ الأحداث مباشرةً في شوارع دمشق أو أزقة حلب أو مخيمات إدلب، تحوّل إلى متابع من بعيد، محروم من ملامسة تفاصيل الواقع ومن الشهود المباشرين على ما يوثق.
لقد ولّد هذا الغياب عن الميدان شعورا بالاغتراب المهني والإنساني معاً، حيث وجد الصحفي نفسه في عزلة مزدوجة: عزلة جغرافية عن بلده، وأخرى مهنية عن أدوات عمله الأساسية.
يشير مصطفى قرة علي - وهو مخرج أفلام وثائقية من مدينة بنش بمحافظة إدلب - إلى أن الانتقال من سوريا إلى تركيا أعطاه بعض الأمان، لكنه لم يكن كافيًا لإعادةِ بناءِ هويته المهنيّة بالكامل، أما في فرنسا ففقد حياتهُ الشخصية ومهنته كليًا رغم امتلاكه معداته وخبراته الطويلة في الإنتاج الصحفي والأفلام الوثائقية. وجد نفسه مضطرًا للبدء من الصفر؛ يواجه حاجز اللغة ومتطلبات شهادات فرنسية في الصحافة وإجراءات بيروقراطية معقدة.
ويعتقد مصطفى أن "أكبر التحديات تمثلت في البحث عن فرصة عمل في الصحافة بفرنسا، فمع كل هذه القيود المتعلقة باللغة والشهادات المطلوبة والبيروقراطية شعرت بالإحباط.. وفوق ذلك، لدي عائلة وأعباء يومية تتطلب متابعة التعليم والتأمين الصحي والاستقرار، وهو ما جعل الضغط النفسي والجسدي مضاعفًا".
أظهرت الثورة جيلاً جديداً من الشباب في قلب الميدان الإعلامي من دون تدريبٍ أو تأهيلٍ مهني؛ كانَ الشغف والرغبة في توثيقِ الحقيقة هما المحرّك الأساسي لهم، فتحوّلت الصحافة بالنسبة لهم من مهنةٍ لها قواعد ومظلّة حماية إلى تجربةٍ فردية محفوفةٍ بالخطر، يحددُها الاجتهاد الشخصي أكثر مما تُحددها المعايير المهنية.
في بداية المظاهرات عام 2011 ضد نظام الأسد، كان الصحفي المستقل يعتبر سوريا ساحةَ معركة بالنسبة له بكل ما تعنيهِ الكلمة من معنى: اعتقالات وتعذيب وقصفٌ عشوائي بمختلف الأسلحةِ وغيابٌ لأيِّ حمايةٍ مؤسساتيّة، وهو الأمر الذي جعل التغطيّة ونقل صوت السوريين مهمة شاقة جداً ومحفوفة بالخطر. إنّ تحليلَ التجربة يُظهر أنّ ساحات الميدان في حُكم الأسد وخلال الثورة السوريّة لم يكن مجرّد مكان للعمل، بل جغرافيا للخطرِ المستمر لتتحول إلى معركة وجوديّة؛ فنقل الحقيقة هو تحدٍّ وجودي بين حياة معرضة للخطر وهوية مهنيّة معرضة للزوال.
يقول الصحفي ميلاد شهابي في تصريح لمجلة الصحافة: "رحلتي مع العمل الصحفي لم تكن سهلة؛ إذ منذ عام 2014 اضطررت لمغادرة سوريا بعد أن اختطفني تنظيم داعش، وتعرّضتْ أسرتي لتهديدات مباشرة، فكان خيار الخروج إلى تركيا حماية لنا جميعًا، وهناك واصلت عملي الإعلامي لسنوات، غطيت خلالها قضايا السوريين في الداخل والمخيمات الحدودية، وكان أبرزها تجربتي في متابعة تداعيات الزلزال، لكنْ رغم حرصي على البقاء قريبًا من الحدود السورية لمتابعة القضايا، واجهت في تركيا صعوبات وضغوطًا قانونية انتهت بي إلى طلب اللجوء في فرنسا".
يحكي ميلاد أنه بعد عام ونصف من الإقامة بفرنسا "كنت أواصل نشاطي عبر مؤسسة إعلامية تطوعية تعنى بالشأن السوري، نتناول فيها قضايا الفساد والمعيشة، ونعمل مع شبكة من الصحفيين داخل البلاد، بالنسبة لي يظل دور الإعلاميين السوريين في الخارج مكملًا وضروريًا، فهو يتيح لنا نقل قضايا الداخل بحرية وأمان، في وقت يواجه فيه الصحفيون داخل سوريا تهديدات تمنعهم من التصريح بأسمائهم الحقيقية."
خلال سنوات الثورة السوريّة وقبل سقوط الأسد، لم يكن الصحفي السوري يواجه القمع في الميدان فحسب، بل عانى من مؤسسات كان من المفُترض أن تحميهِ وتؤطر عمله؛ فمؤسساتُ الإعلام حينها كانت بوقاً وأدوات دعائيّة يستخدمها نظام الأسد لصياغة السردِ الرسمي فقط حاجبةً الحقيقة عن الجمهور.
وبالنسبة للمؤسسات الإعلاميّة المعارضة أو المستقلّة، اضطُر الكثير منها للعمل من الخارج أو واجهت حتميّة الإغلاق النهائي، أو تعرضت لاستهدافها بالملاحقة على الأقل؛ فغياب المؤسسات الإعلاميّة القويّة والمستقلّة عرّض الممارسةَ الصحفيّة للفراغِ المهني واللوجستي سواء كان ذلك في المنفى أو الداخل، فلم تكن هناك شبكات دعم للصحفيين في سنوات الثورة الأولى، كما سُجّل غياب واضحٌ للحمايةِ القانونيّة أو الاجتماعيّةِ فتراجعت الممارسة الصحفية خاصة المرتبطة بالتوثيق.
رغم سقوط نظام الأسد الدكتاتوري الذي كان يقمع الصحافة والرأي، بقي الصحفي السوري عالقاً بين مأساةِ هشاشةِ المؤسسات وقسوةِ الميدان والمنفى؛ جيلٌ كامل دخل المهنة بالشغفِ لا بالتدريب، وحملَ الكاميرا على اعتبارها هويةً لا أداة، ومع كل شهادة أو صورة أو فيديو تظهر الحاجة إلى صحافةٍ تحمي الحقيقة والذاكرة معاً.
ظهرت الحاجة الملّحة لتغطية أحداث الثورة السورية منذ البدايات، وخصوصاً أنّ نظام الأسد استخدم السلاح في وجه صوت الشعب، وهو ما أظهر جيلاً جديداً من الشباب في قلب الميدان الإعلامي من دون تدريبٍ أو تأهيلٍ مهني؛ كان الشغف والرغبة في توثيقِ الحقيقة هما المحرّك الأساسي لهم، فتحوّلت الصحافة بالنسبة لهم من مهنةٍ لها قواعد ومظلّة حماية إلى تجربةٍ فردية محفوفةٍ بالخطر، يحددها الاجتهادُ الشخصي أكثر مما تحددها المعايير المهنية.
في مدينة معرّة النعمان جنوب إدلب، يروي الصحفي الشاب بشار قيطاز جانبًا من تجربتهِ في العملِ الإعلامي في سنوات الثورة الأولى؛ بدأَ مساره الصحفي من دونِ أي تدريبٍ أو خبرة مهنية مكتفيًا بشغف التوثيق وكاميرا حملها لتكون نافذته الوحيدة نحو العالم. هذا النقص في التأهيلِ أشعره أن المسؤوليةَ المُلقاة على عاتقهِ أكبر بكثير من إمكانياته، خصوصًا حين أدرك أن صورةً أو مقطعَ فيديو قد يصبح الدليلَ الوحيد على حقيقة إجرام الأسد.
الأخطار لم تقتصر على القصف أو المداهماتِ الأمنيّة، بل تمثلتْ في لحظاتٍ كان يقف فيها أمام خيار مصيري: أن يرفع الكاميرا مخاطراً بحياته، أو أن ينجو بصمت، وكثيرًا ما دفع ثمن هذا الخيار برؤية زملاء وأصدقاء يسقطون أمامه، فتركَ هذا في داخله ندبةً لا تُمحى، ورسّخ لديه تساؤلاتٍ عميقة حول معنى الهوية الصحفية، وهل هي مجرّدُ مهنة أم رسالة وجودية.
مع مرور الوقت، تحولت تجربته إلى ما يشبه دفاعًا عن الذاكرةِ الجمعيّة لسوريا الممزقة. بالنسبة له، لم تكن الصحافة بطاقة اعتمادٍ أو انتماءٍ إلى مؤسسة، بل كانت قدرةً على أن يكون شاهدًا صادقًا مهما كان الثمن.
رغم سقوط نظام الأسد الدكتاتوري الذي كان يقمع الصحافة والرأي، بقي الصحفي السوري عالقاً بين مأساة هشاشة المؤسسات وقسوة الميدان والمنفى؛ جيلٌ كامل دخل المهنة بالشغف لا بالتدريب، وحمل الكاميرا على اعتبارها هويةً لا أداة، ومع كل شهادة أو صورة أو فيديو تظهر الحاجة إلى صحافةٍ تحمي الحقيقة والذاكرة معاً؛ فالتحّدي يكمنُ في بناءِ بيئة مهنيّة تعيد للصحفي مكانته وللقلم قدرته على الفعل.